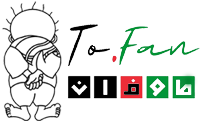كنت في المرحلة ما بعد الإعدادية، في الصف العاشر، عندما فاض الكيل وقلت لمعلم مادة الرياضيات: يعني بالله عليكَ يا أستاذ، ما فائدة نظرية فيثاغورس وحل المعادلات؟ منذ الصف الأول وإلى اليوم ولم أحتج الرجوع إلى أي من هذه المعادلات، فما هي الفكرة من مادة الرياضيات بالضبط؟!
كان أستاذ الرياضيات هذا بارعاً جداً في حل المسائل بل وكطلاب في مقتبل العمر، كنا ننظر إليه وكأنه عبقري متبحر في العلوم. وكان محبباً وقريباً من الطلبة حيث أتاح لنا ذلك أن نسأله ونعبر عن أنفسنا بحرية عنده أكثر من غيره من المعلمين…
كنت أقول، بأن التعليم هو عماد النهضة، ولكنني اليوم أقول إن “كيفية التعليم” هي عماد النهضة وليس التعليم ذاته.
إن سؤالي عن ما نتعمله في مادة الرياضيات وعلاقته بحياتنا اليومية بعد عشر سنواتٍ على مقاعد الدراسة يكشف عن إشكالية كبيرة في منظومة التعليم التي لم تبدأ بوضع الأساس ولا في أي سنة من هذه السنوات العشرة، حيث تبدأ الحصة بفتح الكتاب، ووصف الخطوات للوصول إلى الحل. كان جل هدفنا أن نصل إلى الحل من خلال فهم ما تعنيه كل إشارة رياضية، فهذه الإشارة تقسم، وهذه تضاعف، وهذه تزيد أو تعيد الرقم إلى جذره الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه. نتعلم ذلك حتى نستطيع أن نكتب الحل لنحصل على المكافأة. وكأنها أحجية قائمة بذاتها منفصلة عن سياق الواقع. وكانت أكثرنا يجيب على سؤالي الذي سألته لأستاذ الرياضيات بأن الرياضيات تندرج تحت تصنيف التمارين العقلية التي تمرن العقل على حل المسائل. كلها أجوبة افتراضية وضعناها بأنفسنا لأن أحداً لم يخبرنا عن الأسباب، لأن محيطنا الذي نعيشه كشباب على مقاعد الدراسة كان منفصلاً بطبيعة الحال عن المادة التعليمية التي كنا نتلقاها.
إن غياب الجواب على سؤال “لماذا؟” في منظومة التعليم وفي كل ما يتعمله الإنسان يجعل عقل الإنسان ممتنعاً عن رؤية التراكم البشري والتسلسل المعرفي للمادة التعليمية، مما يجعل تلقي المعلومة عبارة عن قوالب جاهزة يجب على الطالب تذكرها، الأمر الذي كنت أستغربه وأتساءل، هل التعليم هو القدرة على التذكر؟ أم أن القدرة على التذكر هي نتيجة لبناء سليم في العقل عندما تتكاثر فيه المعرفة المترابطة منطقياً. وأيضاً، إن غياب الجواب على سؤال “لماذا؟” في منظومة التعليم يساعد الإنسان على التفكير بحلول أخرى وبطرق أخرى للوصول إلى الحل. لأن “لماذا؟” تفسر الأسباب، وعندما تفسر الأسباب تبين الأهداف. فالجواب على “لماذا؟” في منظومة التعليم يخبرك بطبيعة الحال إلى أين سنذهب وإلى أين سنصل.
إذا ما بحثنا في التاريخ قليلاً، فإننا نجد أن المستعمر كان دائماً ما يهدف مسخ الهوية من خلال الأنظمة التعليمية، فيُذكر أنه في الجزائر قد أصدر الاستعمار الفرنسي مرسوماً تم من خلاله اعتبار اللغة العربية لغةً أجنبية، وفُرضت اللغة الفرنسية على الجزائريين آنذاك. وفي فلسطين تم إضعاف التعليم من خلال تجاهله في الميزانيات المالية في حيت أغدقت الحكومة البريطانية على أنظمة التعليم اليهودية، والأمثلة الإستعمارية كثيرة. وإذا ما دققنا النظر فيها فإننا نجد أنها أساليب تتناسب مع ما ترمي إليه تلك الأنظمة الإستعمارية من تشويه مباشر في الهوية. في نظري تغيب هذه الأمثلة الصدامية المباشرة في تشويه التعليم والهوية في مجتمعاتنا العربية بسبب اختلاف الغاية التي تقوم عليها الأنظمة السياسية، فهي أنظمة متحالفة تاريخياً مع الاستعمار ولكنها لا تزال تتحدث بلغتنا وتحمل هويتنا في ظاهرها، الأمر الذي يدفع هذه الأنظمة بالضرورة إلى استخدام أساليب أخرى تمهد إلى المستقبل الذي ترمي إليه هذه الأنظمة، ولذلك كانت النظم التعليمية على هذه الشاكلة، حيث أن هذه النظم تعمق أسلوب التبعية بالتركيز على حفظ الطريقة التي توصلك إلى الجواب الصحيح حتى تتم مكافأتك، دون الحاجة إلى فهم الأساس والجوهر وما ترمي إليه المعرفة. فيكبر الإنسان في هذه المجتمعات ببنية عقلية تتعاطة مع الأمور وكأنها منجات معلبة دون الاكتراث بكيفية بدايتها أو إلى ما ستؤول إليه، فتستقبل الأحداث على مستوى الكلمات والمواقف الحاضرة دون ربطها بأساساتها ودون حضور الصورة الكاملة للموقف. وبذات طريقة التعليم، يعرف الفرد تلقائياً أن عليه أن يتبع الخطوات التي توصله إلى الجواب الذي يؤدي به إلى المكافأة، فينفعل مع المواقف بالطريقة التي تحصّل له الرضى من قبل السلطات القائمة.
قد يظن أحدنا أن هذا العرض لهذا النمط في المنظومة التعليمية هو من باب التشابه، إلا أن هناك علوماً تناقش العلاقة بين السلوك وبين البنية المعرفية وطريقة تلقيها مثل علم النفس التربوي، وعلم الأعصاب المعرفي، وكذلك علم النفس المعرفي، وعلم الإجتماع التربوي الذي يوضح الأبعاد السياسية والاجتماعية لطريقة التعليم. فمثلاً هناك أبحاث في علم النفس التربوي مثل Bloom’s Taxonomy تظهر أن السؤال عن السبب يحرك مستويات التفكير العليا ويرفعها إلى التحليل والتقييم والإبداع، بينما الحفظ فقط يترك الطالب في المستوى الأدنى من “التذكر”.
وإن الأمر الذي يصعّب المسألة ويُظهرها كتحدٍّ بالغٍ أمام من يدفعون باتجاه حرية الفكر، هي أن هذه الطريقة التقليدية في التعليم والتي تعتمد على الحفظ لا تمنع من تكوين النخب المجتمعية الخاصة بهذا الأسلوب، بل يبرز في المجتمع خبراء متخصصون ويُسمع لهم، ولكنهم خبراءٌ بالكيفية، لا خبراء بالأسباب والأهداف ولا مآلات الأمور ولا أسباب بداياتها. الأمر الذي يستوجب على العاقلين تفكيك هذه الأنظمة التعليمية ومواجهة روادها من حملة شهاداتها العليا.
فهم البدايات والنهايات أساس التعلم
ليتحرر الإنسان من آلية الكيفية، والتي كان لها الكثير من التبعات الفكرية السلبية، مثل التبعية الدينية والتبعية الطائفية والإيديولوجية، فإن على الإنسان أن يفهم بدايات الأمور ونهاياتها بتسلسلها المنطقي وبأسبابها التي دفعت لها في ظروفها الخاصة، فإن في بداية كل علم ونظرية وفكرة وإديولوجيا كان هناك شرارة ودوافع تبين الأسباب التي ظهر لأجلها هذا العلم أو تلك القضية. هذه الأسباب والدوافع والظروف هي بوصلة المتعلم، حيث يتعلم العلم ليكمل الطريق التراكمية الإنسانية التي وُضع لأجلها العلم، أو يكمل هذا المسار الإنساني الذي لم يكتمل، أو أنه يبادر بوضع أسس أخرى تصل إلى ذات الهدف من طريق إبداعي مختلف. ويصعب على من لا يفهم البداية والشرارة أن يقدم ويعطي ويساهم إن كان جل علمه هو في الكيفيات والتقنيات دون رؤية البداية والشرارة التي أطلقت هذا العلم أو تلك القضية، فيصبح الأمر وكأنه ممارسة لطقوس: أفعال منفصلة عن بدايتها ولا تؤدي إلى الغاية المنشودة (سواء أكانت هذه الأفعال مجتمعية، سياسية أو دينية).
كما أن فهم البدايات جوهري من أجل فهم لب القضية، فإن فهم المآل الذي سينتهى إليه العلم يرسم الطريق ويشكل الغاية للمتعلم. إن الإنسان لا يستطيع أن ينوي نية صحيحة للقيام بعمل ما إذا لم يكن يعرف نتيجة العمل. النهايات ترسم للإنسان شكل مسؤوليته فيما يفعل. وطرح النهايات والغايات والأهداف في العلم هو أمر يحترم للإنسان خياره في تبني العلم وتطويره او رفضه وانتقاده. فإن كنا في بلد ما نعتبر السلوك الذي نمارسه يومياً يحقق الهدف الذي تعلمنا أن ننشده دائما، وهو الحفاظ على نعمة الأمن والأمان، فالسبب في قناعتنا التامة بأنه سلوك صحيح هو عدم فهم بدايات الأمور والجهل بنهاياتها ومآلاتها… فكيف يكون هذا السلوك صحيحاً وفي جوارنا حرب إبادة ضروس تبيد أهلنا الذين هم من لحمنا ودمنا؟! ولكن، إذا حضر السؤال: لماذا يراد لنا أن نطلب الأمن والأمان والخطر محدق؟ وإلى أين سيؤدي بنا هذا الأمر في نهاية المطاف؟ عندها تتحرر البنية الفكرية من الأجوبة المعلبة المغلفة، والتي أسميها بالأجوبة الطقوسية، لأنها فارغة من المحتوى العقلي الفكري الذي يبررها بشكل سليم.
القياس
فعندما أجابني الأستاذ على أهمية فيثاغورس والمعادلات الرياضية في حياتنا اليومية، كان جل ما يريد فعله هو أن يزيل الحرج عن ذاته مستخدماً سلطته كرجل كبير في الصف يثق به الطلبة، فسخّف السؤال الذي يهز شرعيته مستخدماً هيبة الرياضيات كعلم ولم يقدم إجابة شافية. وانتهى الأمربأن ضَحك الطلاب، فعلمتُ أنه لا يعرف الجواب حتى لجأ إلى هذا الأسلوب… أو أنه قد خاف أن أعرف الجواب!
كانت القراءة وما زالت، سفينة نجاةٍ تقدم الأجوبة، فرواية عالم صوفي للفيلسوف النرويجي جستاين جاردر قدمت لي الجواب بطريقة إبداعية، لأن الرواية تربط الخيال بهذا الواقع المادي بحثاً عن طريقة لقياسه، حيث خلصت بإجابة عندما قرأت هذه الرواية وأنا في سنوات الجامعة أن ما لا يقبل القياس فهو ليس بحقيقي ولا وجود له، ولذلك تجد أن المتعلمين والفيزيائيين قلما يقبلون بفكرة الجن والسحر والتلبس والروح، حيث أنه لا يوجد ما يتم به قياس هذه الأمور، بل وعلى العكس من ذلك، لم تحدث في التاريخ حالة وفاة بلا سبب (مجرد خروج الروح من الجسد)، بل كانت كل أسباب الوفاة مقترنة بسبب مادي يمكن قياسه وإدراكه. ولا يُذكر في التاريخ أن هناك حالة صمت وتسليم للسلاح نجحت في تحقيق الأمن والأمان حين كان الخطر المحدق حاضراً.
في المحصلة، إنني لا ألقي لوماً على الشعوب المخدرة، فالقادة سُموا بهذا الإسم لأنهم يمتلكون زمام الأمور، وسميت الشعوب شعوباً لتشعبها، وشتان بين من يقود إلى هدفٍ محدد، وبين من يعيش تشعباتٍ لا نهاية لها. فإنني أرى أن على نخبة النخبة الذين يرون مكامن الخلل بدقة، أن يحرروا النخبة التي تتصدر المشهد، وبذلك تبدأ عملية إفراز القادة التي يمكن لها أن تؤثر على الشعوب والجماهير تباعاً.
آدم السرطاوي – كندا