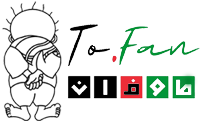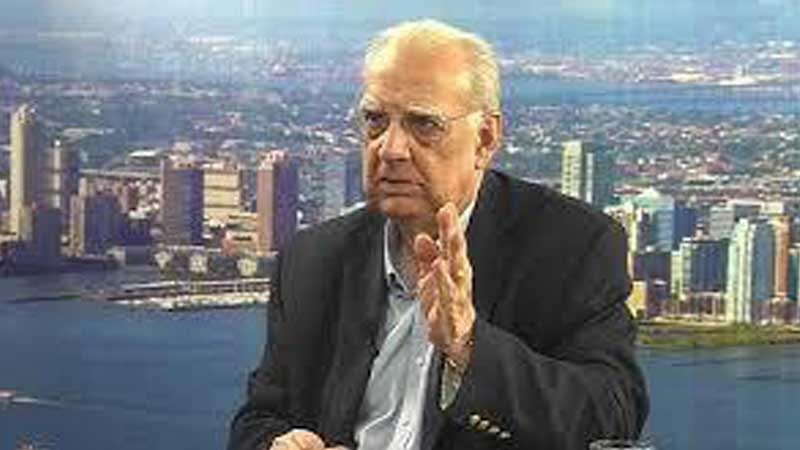ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤتمر الرابع والثلاثون
7 – 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
بيروت – لبنان
التقرير السّياسي: غزّة وفلسطين والعالم
إعداد د. زياد حافظ (لبنان)
الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- باحث اقتصادي، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
التقرير السّياسي: غزّة وفلسطين والعالم
د. زياد حافظ (لبنان)
الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
مقدمة
نادرا يحتوي التقرير السياسي عبارات أدبية تعبوية لأن الطابع العلمي والموضوعي هو الذي يسود. لكن في هذا التقرير نعتبر أن إدخال مصطلح “ملحمة” و”أسطورة” لما يحدث في غزّة هو الحدّ الادنى من الموضوعية في مقاربة الاحداث. فغزة الملحمة والاسطورة أصبحت عاملا أساسيا وحاسما في موازين القوّة التي تحكم الصراع مع الكيان الصهيوني الموقّت. ونؤكّد أن الكيان الصهيوني موقت ليس من باب التمنّيات بل نتيجة لقراءة موضوعية لموازين القوّة ولمسار الامور التي تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الجغرافيا والتاريخ في مقاربة الموازين.
ما حدث خلال السنتين الماضيتين وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا من مواجهة ليس فقط مع الكيان الموقت بل مع الولايات المتحدة ودول الغرب وللأسف مع الصمت العربي غيّر بشكل جذري المعادلات العسكرية والسياسية والثقافية والقيمية ليس فقط في المشرق العربي، بل في الاقليم وفي العالم أجمع. قضية فلسطين عبر ملحمة واسطورة غزّة تجاوزت البعد الفلسطيني والقومي العربي كما تجاوزت البعد الديني إن كان في الاسلام أو في المسيحية أو حتى في اليهودية، بل أصبحت قضية عالمية تطرح بشكل مباشر مفهوم القيم الانسانية التي تقفز فوق اعتبارات الحسابات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية. فمفهوم الانسانية على المحكّ فيما يشهده العالم من إبادة جماعية وتجويع غير انساني ما جعل الشعوب في مختلف دول العالم تتظاهر ضد الوحشية غير المسوقة والمدوّنة بالصورة لمشاهد كنا نقرأها في الكتب فأصبحنا نشاهدها على الهواء حيّة.
التغيير الحاصل في موازين القوّة إقليميا ودوليا وإلى حد ما عربيا يعكس القراءة التي قدّمها المؤتمر في السنوات الاخيرة. فهذا التقرير هو امتداد للتقارير السابقة ويعزّز الخلاصات فيما يتعلّق بمسار القوى المتصارعة على الصعيد العالمي والاقليمي والعربي. فالجبهة المناهضة للهيمنة الغربية بشكل عام والاميركية بشكل خاص في حال صعود وبوتيرة أكبر وأوسع مما كانت عليه في السنوات الماضية. بالمقابل فإن الجبهة الغربية والاميركية في حال تراجع قد يكون عاموديا وينذر بانهيارات داخلية بسبب خيارات وسياسات داخلية وخارجية. ولقد فصّلت التقارير السابقة تلك الخيارات والسياسات ونوعية القيادات الغربية التي أدّت إلى الطريق المسدود.
أما التقرير الحالي فسيعرض اولا بشكل سريع التطوّرات على الصعيد الدولي وثانيا، المستجدّات الكتلة الاوراسية ودول الجنوب الاجمالي، وثالثا في المواجهة مع الكيان الصهيوني في غزة ولبنان واليمن. وفي الجزء الاخير سيعرض بشكل سريع التحوّلات في الموقف العربي العام ويطرح اسئلة جوهرية في المقاربة الاستشرافية حول النظام العربي القائم.
الجزء الاول: المشهد الدولي: الولايات المتحدة واوروبا
أولا- المشهد في الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تشهد تحوّلات كبيرة في البنية السياسية والاقتصادية كما تشهد تحوّلات سياسية ومجتمعية ناتجة عن تراكم سابق فجرّها “طوفان الاقصى”. فعلى الصعيد السياسي التغيير في البنية السياسية ما زال مستمرّا داخل الحزبين الحاكمين، أي الحزب الديمقراطي والجمهوري. وهذا التغيير يعود إلى انتفاضة القواعد التقليدية للحزبين على سياسات نخبها الحاكمة. والانتفاضة الشعبية تقودها شريحة واسعة من الاميركيين دون سن الاربعين، بمعنى أن هناك حراك جيلي قد بدأ وما زال قائما ولم ينته. وخلاصة الحراك هو توافق القاعدتين الديمقراطية والجمهورية الشابة على رفض تورّط الولايات المتحدة في حروب جديدة وضرورة انهاء الحروب القائمة خاصة في شرق اوروبا وغرب آسيا.
أ- المستجدات في المشهد الداخلي الاميركي
شرارة التغيير، التي كانت عناصره تراكمات ناتجة عن خيارات وسياسات شُرحت في التقارير السابقة، أطلقها فوز دونالد ترمب بولاية ثانية بعد اقصاءه عن تلك الولاية في 2020. واعتبر ترمب أن إعادة دور اميركا للصدارة تكمن في استعادة السلطة التنفيذية التي تناثرت عبر العقود السابقة داخل مراكز متعدّدة شكّلت ما يُسمّى بالدولة العميقة. وعنوان معركته الداخلية هو “تجفيف المستنقع” أي تحييد الدولة العميقة. وهذه العملية هدفها إعادة حصر السلطة التنفيذية بيد الرئاسة بعد أن تناثرت عبر العقود التسعة الماضية في مراكز قوّة ونفؤذ شكّلت الدولة العميقة التي كان عمودها الفقري المجمّع العسكري وامتداداته الامنية والاستخباراتية وفي قطاعات الجامعات ومراكز الابحاث والاعلام. كما أنه لا يعتبر أن مهمة الولايات المتحدة هي أن تكون شرطي العالم أو بناء الدول أو التتدخل في شؤون الدول. ما يهمّه هو عقد صفقات اقتصادية وتجارية تكون الولايات المتحدة الرابح الاكبر وإن اضطرّ إلى فرض الضغوط على الجميع سواء كانوا “حلفاء” أو “خصوم” أو على الحياد.
استطاع في التسعة الاشهر الاولى من ولايته الثانية تنفيذ عددا من وعوده الانتخابية عبر سلسلة من المذكّرات التنفيذية تجاوزت رأي الكونغرس الاميركي. وأبرز تلك الاجراءات هو صدّ الهجرات الوافدة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة التي كانت تشكّل احتياطا بشريا ليد عاملة رخيصة في العديد من القطاعات التي تتطلّب يد عاملة مستعدّة للاعمال الشاقة في الزراعة والبناء وخدمات التنظيف التي لا يريد المواطنون القيام بها. وتشير الاحصاءات أن الهجرة انخفضت حيث 1،4 مليون شخص غادروا الولايات المتحدة تلقائيا أو قسرا. هذه الاجراءات حاولت الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي التصدّي لها عبراعلانها ملاذات آمنة للمهاجرين ما جعل الصدام مع الدولة الاتحادية قائما خاصة في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن. لذلك ارسل الرئيس الاميركي الحرس الوطني ليقضى على ذلك النوع من العصيان ووعد بإرسال القوّات المسلّحة لدعم الحرس الوطني و”تنظيف المدن”. وما مازلت الحالة متأزمة عند اعداد هذا التقرير بين الدولة الاتحادية والولايات المعنية.
قضية المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة ليست قضية عابرة لأنها تصبّ في صميم التركيبة السكّانية للولايات المتحدة. فكافة الاحصاءات تشير أن العنصر الابيض سيصبح أقلّية في منتصف القرن الحالي وهذا ما يشكّل غضب الكتلة البيضاء التي هي العامود الفقري للحركة الشعبوية المحافظة. والرئيس الاميركي حريص على تحقيق وعده بمكافحة الهجرة الوافدة التي لا تقتصر على العنصر الاميركي اللاتيني بل تستهدف أيضا الهجرة الاسيوية وخاصة الاتية من الهند. فتراجع قيمة الهند الاستراتيجية عند ادارة ترمب أدّت إلى فرض التعريفات الجمركية كما أدّت إلى فرض رسوم قد تصل إلى مئة الف دولار لرخص العمل للهنود. ومن دلائل الانكفاء نحو الداخل هو استدعاء اكثر من 800 قائد عسكري من رتبة عقيد وما فوق وابلاغهم أن مهمتهم هي الحرب في الداخل ضد الاحتلال القائم (يقصد المهاجرين). هذا التوجه يخالف القانون المعمول به منذ 1878 الذي يحظر استعمال القوّات المسلّحة في القضايا الداخلية. عند اعداد هذا التقرير لم يصدر تعليق او ردّة فعل من قبل القيادات العسكرية وإن كانت هناك بعض معالم تمرّد. اضافة إلى ذلك فوثيقة الامن الاستراتيجي التي صدرت في مطلع شهر ايلول تفيد أن اولوية الولايات المتحدة هي الدفاع عن الحدود وتحصين الداخل ما يعني الانكفاء عن التموضع الخارجي. السؤال المطروح هل ينجح ترمب في تنفيذ تلك السياسية؟ من المبكر الاجابة إلاّ أن المعطيات تفيد أن حجم الانقسام الداخلي كبير والاحتقان اكبر والرئيس ترمب لا يخفي رغبته في اقصاء خصومه حتى اذا لزم الامر الصدام في الشارع وملاحقة قيادات الحزب الديمقراطي. عناصر حرب آهلية في الولايات المتحدة متوفرة والمسار الذي تتخذه الادارة قد يؤدّي ألى الانفجار الداخلي.
من جهة اخرى قامت الادارة بردّ الجميل للادارة السابقة التي لم توفّر وسيلة لملاحقة ترمب عبر تسييس القضاء . لذلك اقدم ترمب على اقصاء عدد من القضاة الذين تصدّوا لاجراءاته سواء في حق المهاجرين أو في التسريح التعسّفي داخل جسم الاداري للدولة الاتحادية. وعند اعداد هذا التقرير ما زال الصراع قائما.
حقق الرئيس بعض النجاحات في إعادة تركيب بعض الاجهزة الاستخباراتية والامنية سواء في مكتب البحوث الاتحادي (اف بي أي) أو الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو أس أي دي/USAID) التي الغاها بالكامل والحقها بوزارة الخارجية بعد أن كانت مستقلّة وصاحبة موازنة لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة. كما الغى الوقفية لدعم الديمقراطية (ناشونال ادنومانت فور ديمقراسى/ National Endowment for Democracy). والمؤسستان كانتا مصدر التمويل الاساسي للجمعيات غير الحكومية في معظم الدول التي تريد الولايات المتحدة تغيير نظامها أو سلوك نخبها الحاكمة. فهي من ساهمت في تمويل الحركات الاحتجاجية في روسيا وجورجيا واوكرانيا ولبنان وطبعا في معظم الدول التي شملها “الربيع العربي”. كما اقدم الرئيس الاميركي على تخفيض عدد العاملين في مجلس الامن القومي الذي بلغ عدد العاملين فيه أكثر من 400 بينما كان عدد العاملين عند التأسيس بحدود الاربعين فقط). وكذلك الامر يجري في البنتاغون حيث يتم تخفيض عدد الجنرالات العاملين. بالمناسبة، إن عدد الجنرالات بثلاث واربع نجوم لم يتجاوز السبعة خلال الحرب العالمية الثانية بينما الان يفوق العدد الثمانين! وهذا الاجراء له اهميته لان عددا من مكوّنات الدولة العميقة تعتمد على ذلك المخزون من الجنرالات لتمرير الصفقات التسليحية مع شركات التصنيع وتزويد مراكز الابحاث بالمعلومات كي تبني التوجّهات السياسية داخليا وخارجيا. فسياسة البوّابات الدائرة هي أحدى ميزات عمل الدولة العميقة التي توثّق العلاقة بين الدولة الاتحادية ومراكز القوّة والمال في الفضائ السياسي والاقتصادي والعسكري والامني الاميركي.
كل هذه الاجراءات تلاقي معارضة شديدة ليس من قبل الحزب الديمقراطي فحسب بل من مكوّنات الدولة العميقة داخل الجسم الاداري للدولة الاتحادية. ما زال من المبكر اصدار احكام حول المنتصر أو المنهزم في هذه المعركة لانها طويلة ومعقّدة وتطال مصالح عديدة غير مستعدّة بالافراط بامتيازاتها. لذلك من الصعب اصدار الحكم التقييمي على ولاية ترمب في التسعة الاشهر الاولى لأن المشهد في حالة انسياب كبير. فيوم تميل الكفّة للرئيس الاميركي ويوم تربح الدولة العميقة جولات ليست ببسيطة وخاصة في السياسة الخارجية.
على صعيد آخر فإن ما يتميّز به المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة هو حضور فلسطين وغزّة في متن الخطاب السجالي السياسي. فالتحوّلات في الراي العام الاميركي سواء في داخل القوى السياسية المتحكّمة في الولايات المتحدة أو في الشارع الاميركي تشير بوضوح أن الدعم للكيان يخضع في الحد الادنى لمراجعة وفي الحد الاقصى في جدوى العلاقة معه واولوية الكيان في السياسة الخارجية الاميركية. فكافة استطلاعات الراي العام تشير إلى تراجع التأييد التقليدي للكيان إلى أقل من خمسين بالمائة بينما كان يتمتع بالتأييد بالسبعينات بالمائة من المستطلعين. والنسبة الأكبر هي عند الشباب أي دون سن الثلاثين من كافة المكوّنات للمجتمع الاميركي بما فيه الجالية اليهودية. فشباب تلك الجالية كانوا من قيادات التحرّك الجامعي الداعم لغزّة وكانوا على تناقض واضح مع ابائهم.
وهنا لا بد من التوقّف عند ظاهرة ترشيح زهران ممداني لمنصب عمدة مدينة نيويورك وفوزه على ابن المؤسسة الحاكمة من الحزب الديمقراطي ومن سلالة عائلية عريقة في الحزب الديمقراطي الحاكم السابق اندرو كوومو. فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية على منافسه كوومو الذي انفق أكثر من 20 مليون دولار من دعم اللوبي الصهيوني له دلالات عدّة. الدلالة الاولى يؤكّد الانشطار داخل الحزب الديمقراطي بين الجيل الشاب وجيل الكهول والشيوخ. فالشباب يرفضون جملة وتفصيلا السردية المنتشرة لدى نخب الحزب الديقمراطي فيما يتعلّق بضرورة الدعم الاعمى والمطلق للكيان الصهيوني المؤّقت. اما الدلالة الثانية فهي أن المرشح من اصول مسلمة آسيوية يجاهر بدعمه لفلسطين كما يجاهر بافكاره الاشتراكية في عاصمة اللوبي الصهيوني، وفي معقل الرأس المالية المتمثّلة بوال ستريت، وفي أكبر تجمّع سكاني للجالية اليهودية الاميريكة في الولايات المتحدة. الدلالة الرابعة هي في التداعيات المختلفة على صعيد تركيبة الحزب الديمقراطي التي بدأ العديد من المرشحّين لمناصب في الكونغرس الاميركي والمجالس المحلّية في مختلف الولايات جدوى تبنّي التماهي مع الكيان الصهيوني المؤقّت.
هذه الظاهرة انتقلت إلى داخل الحزب الجمهوري وخاصة داخل القاعدة الشعبية لترمب أي تيّار “ماغا” (لنجعل أميركا عظيمة مرّة اخرى/MAGA). فقيادات “ماغا” داخل الكونغرس الاميركي في مجلس النوّاب مع مارجوري تايلور غرين وفي مجلس الشيوخ مع توم ماتيس. وعند اعداد هذا التقرير وصل عدد اعضاء الكونغرس المندّدين بجرائم الكيان المؤقت إلى أكثر من عشرة. والتنديد موجود أيضا خارج الكونغرس عند الشخصيات المؤثّرة في تيّار “ماغا” كتاكر كارلسون، وكانديس اوينز، وستيف بانون، وجو روغان، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، تنتقد بشدّة سياسات ترمب الداعمة للابادة الجماعية في غزة. وحتى داخل الكتلة الانجيلية بدأت تظهر مظاهر التصدّع حيث الكنيسة المنهجية الموحّدة (United Methodist Church) اعلنت عن تفكيك استثماراتها في شركات تعمل في الكيان وأو تدعم الكيان. وهذه الظاهرة جديرة بالمتابعة حيث تكّرس مدى تراجع نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذي أصبح محصورا في الاعلام الشركاتي وداخل الكونغرس علما ان مظاهر التراجع حتى في تلك المؤسستين بدأ يظهر للعلن. ما زال اللوبي قويا ونافذا لكنه أصبح يواجه معارضة شرسة ومتزايدة في قطاعات كان يحسبها محسومة لصالحه. فغزّة قلبت المفاهيم وبالتالي موازين القوّة في الرأي العام الداخلي الاميركي كما في معظم الدول في العالم التي كانت حتى تاريخ قريب من المؤيّدة للكيان الصهيوني. وإضافة لكل ذلك ما زالت التحرّكات الاحتجاجية داخل الجامعات وخارجها مستمرّة رغم القمع التي تفرضه الادارة وإدارات الجامعات على الجسم الطلاّبي والتعليمي. فهذه ثورة وثورة مضادة مشتعلة لم تحسم حتى الساعة ما يدلّ على قوّة الاحتجاج القائمة أمام إمكانيات ادارات الجامعات وإدارة الدولة الاتحادية.
لا بد ايضا الاشارة إلى النقاش الحاد الذي يحصل داخل التيّار المحافظ الاميركي حيث الجيل الجديد ينتقد بشدّة الانصياع إلى اجندة اللوبي الصهيوني. هذا ما حصل في الندوة الاخيرة لمؤتم السنوي اللمحافظين في الولايات المتحدة (National Conservative Annual Conference) بين كورت ميلز رئيس تحرير موقع “اميركان كونسرفاتيف” وماكس ابرامز استاذ العلاقات الدولية في جامعة نورث ايسترن. الاخير انتقد أنصار “اميركا اولا” ودعوتهم لمراجعة العلاقة العدائية مع الجمهورية الاسلامية في إيران والعلاقة مع الكيان. بالمقابل اكّد ميلز ضرورة مراجعة التحالفات التي تضرّ المصالح الاميركية في المنطقة كالعلاقة مع الكيان. طبعا، لم يُحسم الجدل إلاّ أن مجرّد وجوده هو تحوّل حيث كان من المحرّمات التفكير بمراجعة العلاقة مع الكيان. وهناك دعوات من قبل المجموعة المحافظة ككانديس اوين تدعو إلى تصنيف منظمة “أيباك” كمنظمة أجنبية لا يحقّ لها التدخّل في الشأن السياسي الداخلي الاميركي. هذه من بعض ارهاصات التغيير في المزاج الاميركي التي تؤكّده العديد من الاستطلاعات (بيو، وغالوب) عن التغيير في الراي العام الاميركي تجاه الكيان المؤقّت وفلسطين.
في هذا السياق لا بد من الاشارة إلى حادثة اغتيال المؤثّر المحافظ شارلي كيرك الذي هو من اعمدة حركة “ماغا”. كيرك شاب (31 سنة) معروف بمواقفه المحافظة والمتشدّدة مسيحيا. ويقود حملة ضد ثقافة ليبرالية تحقّر الدين. وكان أيضا من الانصار المتشدّدين للكيان المؤقت. لكن في الاونة الاخيرة تغيّر موقفه من الكيان بسبب الابادة الجماعية في غزة والتي تتنافى مع القيم المسيحية. رفض تمويلا صهيونيا وقام بمواجهة كبار المموّلين الصهاينة في الولايات المتحدة. ملابسات الاغتيال ما زالت غامضة ولكن هناك تشكيك كبير في الرواية التي يروّجها مكتب الابحاث الاتحادي (أف بي أي) فيما يتعلّق بهوية القاتل المزعوم وطريقة الاغتيال. المؤثّرة الكبيرة في حركة “ماغا” كانديس اوين شكّكت بشكل علني والذين يتابعونها بالملايين في الولايات المتحدة. وهي أيضا من منتقدي سياسة ترمب تجاه الحروب الدائرة في شرق اوروبا وغرب آسيا. ويأتي اغتيال شارلي كيرك في ظروف احتقان كبير بين انصار الرئيس الاميركي والفئات المناهضة له. فالرئيس الاميركي يعتبر الحركة اليسارية المناهضة للفاشية (انتيفا) حركة ارهابية ويريد ملاحقة قيادات الحزب الديمقراطي. كما يقود حملة واسعة لتقويض حرّية التعبير بحجة أن مناهضيه يروّجون للكراهية. فهو يتبّع نفس اسلوب ادارة بايدن وبالتالي الاحتقان الشعبي أصبح واقعا من الصعب التعامل معه . هذه الحادثة لاغتيال كيرك وحملة ترمب لتقويض حرّية التعبير تظهر مدى تأثير طوفان الاقصى في اللاوعي الاميركي.
ب- المستجدات في المشهد الاقتصادي
التطوّر البارز في المشهد الاقتصادي الاميركي هو محاولة الرئيس الاميركي إعادة توطين القاعدة الانتاجية الصناعية داخل الولايات المتحدة. وهذه المحاولة تشكّل تحوّلا استراتيجيا مناقضا لخيارات وسياسات اعتمتدتها ادارات سابقة ومتتالية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة عندما اعتبرت النخب الحاكمة الاميركية أنه لم يعد من الضروري التمسّك بتلك القاعدةالانتاجية، بل يمكن توطينها في الدول النامية الواقعة تحت السيطرية والنقوذ والهيمنة الاميركية. فهذه الدول تحظى بيد عاملة رخيصة واحكام ضابطة رخوة فيما يتعلّق بالبيئة ونقابات يمكن تطويعها بسهولة. استراتيجية ترمب تعتبر أن فقدان تلك القاعدة الانتاجية التي كانت اساس عظمة الولايات المتحدة هو سبب التراجع المفصلي في الدور الاقتصادي الاميركي في العالم. وهو إلى حدّ كبير محق لأن السيطرة على شرايين المال في العالم لا تكفي لتحصين الهيمنة الاميركية امام صعود اقتصادات منافسة للولايات المتحدة.
بناء على ذلك التقييم للمشهد الاقتصادي وضرورة حماية الصناعات في الداخل الاميركي وتحفيز الشركات الصناعية للعودة إلى الولايات المتحدة أقدم الرئيس الاميركي على فرض سياسة حماية جمركية عشوائية وغير مدروسة أعطت الانطباع ان الولايات المتحدة دولة بلطجية لا تكترث لحقوق الدول. فكانت حرب التعريفات الجمركية مع الدول الصديقة كدول الاتحاد الاوروبي والدوال المنافسة أو المخاصمة كدول مجموعة البريكس. ما زالت الحرب قائمة لكن ارتداداتها على صعيد الاقتصاد الاميركي باتت واضحة حيث ارتفاع الاسعار للسلع المستوردة سواء كانت للاستهلاك أو للتصنيع الداخلي أدّت إلى تراجع القوّة الشرائية لدى المواطن الاميركي. والجدير بالذكر أن سياسة فرض التعريفات الجمركية على دول العالم لا تحظى بموافقة المحاكم الاتحادية حيث محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويورك نقضت قرار الادارة الاميركية بفرض التعريفات على قاعدة انها مخالفة للقانون. المعركة مستمرة وليس بالمستطاع جزم مسار الامور في هذا الملف. لكن من الواضح أن الارتدادات الجيوسية لتلك القرارات سلبية بالنسبة للولايات المتحدة وخاصة داخل مجموعة البريكس حيث توثّقت العلاقات بين الصين والهند وروسيا والجمهورية الاسلامية في إيران لمواجهة تلك القرارات.
الجديد في سياسة ترمب هو اقدام الدولة الاتحادية شراء حصص وازنة في عدد من الشركات الكبرى. ففي شهر آب من هذا العام اشترت الدولة ما يوازي عشرة بالمائة من رأس مال شركة “انتيل” (Intel) التي تصنّع الرقائق التي تشكّل ركيزة صناعة الحاسوب. ويبدو ان الرئيس الاميركي يريد تكوين صندوق سيادي يضم محفظة من الشركات الكبرى. ومن ضمن الشركات المرشّحة للدخول في تلك المحفظة شركات تصنيع الرقائق التي ما زالت تقوم بالتصنيع في الصين، وشركة “ابل” (Apple) والشركة الاميركية لصناعة الصلب (US Steel). هذا يعني أن الدولة الاتحادية سيكون لها كلمة في إدارة الشركات خاصة فيما يتعلّق بالامن القومي الاميركي والقدرات التنافسية. هذا الامر، اذا اكتمل يشكّل تحوّلا كبيرا في الفلسفة الاقتصادية الاميركية التي كانت دائما تنظّر لإبعاد الدولة عن النشاطات الاقتصادية. وهذا امر جدير بالمتابعة علما أن التجربة ما زالت في بدايتها.
على صعيد آخر يخوض الرئيس الاميركي معركة طاحنة مع مصرف الاحتياط الاتحادي، أي المصرف المركزي. هذا المصرف لا تملكه الدولة بل مجموعة من المصارف الكبيرة الخاصة ويحظى المصرف باستقلالية شبه مطلقة. الرئيس يعيّن فقط رئيس مجلس ادارة المصرف ولكن لا يستطيع أن يفرض سياسته على المصرف. الصراع القائم هو حول ترويض المصرف وجعله خاضعا للسلطة التنفيذية وهو جزء من الصراع مع مكوّنات الدولة العميقة حيث المجمّع المالي وعلى رأسه مصرف الاحتياط الاتحادي يلعب دورا كبيرا في توجيه الخيارات والسياسات الداخلية والخارجية. والصراع القائم يكمن في محاولة أقصاء رئيس مجلس الادارة وعدد من اعضاء المجلس. في حال نجح الرئيس الاميركي فقد يكون احدث انقلابا استراتيجيا في البنية الاقتصادية والمالية. السؤال هل ستسمح مكوّنات الدولة العميقة بذلك؟ لا احد يستطيع ان يجيب على ذلك ما دامت المعركة قائمة. لكن تداعيات الصراع ستكون كبيرة على طبيعة النظام الاقتصادي والمالي بغض النظر عمّن سيربح المعركة ولكن ذلك حديث آخر خارج تقدير الموقف في هذه الورقة.
لكن العامل الاهم والاخطر الذي يهدّد استقرار الولايات المتحدة بشكل مباشر وسريع ويلقي ظلاله على الخيارات السياسية الخارجية الاميركي هو حجم الدين العام الذي تجاوز 37 تريليون دولار والحبل على الجرار. لم يكن تفاقم الدين العام هاجسا كبيرا لدى النخب الحاكمة في الولايات المتحدة حتى فترة قصيرة حتى بدأ سوق السندات المالية يترنح امام الاستحقاقات وامام تراجع مكانة الدولار في العالم. والدولار كان الركيزة الاساسية التي “تغطّي” الدين العام كأصول يمكن الاعتماد عليها. لكن تراجع مكانة الدولار في العالم يفرض على الادارة الاميركية خيارات صعبة منها تخفيض قيمة الدولار تجاه العملات الاخرى. لكن الاساس في المشكلة هو عدم امكانية تسويق سندات الخزينة للمشترين الكبار كالصين ودول الجزيرة العربية الذين بدأوا تخفيف انكشافهم نحو الدولار. وما ساهم في عدم انهيار سوق السندات هو ارتفاع سوق الاسهم الذي تسيطر عليه اربع أو خمس شركات مالية كبلاك روك، وستيت ستريت، وفانغارد، وفيدليتي، وهتاوي بركشاير. المحفظة المالية لهذه الشركات تتجاوز نصف قيمة البورصة في نيويورك وهي تملك معظم الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. وتحكّم هذه الشركات بالبورصة ساهم في عدم انهيار سوق السندات. لكن استمرار هذا الواقع غير ممكن وبالتالي هناك ضرورة ماسة للحصول على اصول مالية تغطي الدين العام. لذلك نرى الاهتمام المجدّد للسيطرة على ابار النفط في العالم وخاصة في فنزويلا التي تملك أكبر احتياط نفطي في العالم ، وعلى نفط شرق الاوسط. السيطرة على نفط شرق الاوسط يصطدم بالجمهورية الاسلامية في إيران لذلك تمّ استهداف الجمهورية من قبل الكيان المؤقت في حزيران/يونيو 2025، وقد يتكرّر العدوان في وقت قريب بغية قلب النظام والاستيلاء على النفط الايراني. الدول العربية النفطية لن تشكّل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة ومن هنا نفهم التركيز على ضرورة الاطاحة بالنظام في إيران. كذلك الامر بالنسبة لفنزويلا حيث تمّ التصعيد الكلامي ضد حكومة مادورو بحجة أن فنزويلا أصبحت دولة تنتج وتروّج المخدّرات. لكن ليس من المؤكد أن استراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على نفط فنزويلا وايران قد تنجح وبالتالي لا يمكن استبعاد انهيار سوق السندات في الولايات المتحدة ودخولها في أعمق ازمة اقتصادية وسياسية واجتماعية قد تطيح بالتماسك الداخلي.
ت-المستجدات في المشهد الخارجي
سنقارب في هذا التقرير خمسة ملفات تتعلّق بالسياسة الخارجية الاميركية في ولاية ترمب الثانية. ونعي أن دولة كبيرة كالولايات المتحدة لها اهتمامات دولية كثيرة بسبب مكانتها وسياساتها تجاه هذه الدول. لكن استنسبنا هذه الملفات الخمسة لما لها من تداعيات مباشرة على موازين القوّة في العالم وعلى مسار الصراع العربي المقاومة مع الكيان الصهيوني. للأسف، يبدو أن النظام العربي الرسمي لم يعد يعتبر نفسه معنيا بذلك الصراع وهذا ما سنقاربه في الجزء الخاص بالمشهد العربي. لذلك، نعتقد أن الصراع القائم حول فلسطين هو بين مقاومة عربية شعبية ومعها دولة عربية منخرطة في المواجهة العسكرية أي اليمن، وعلى الصعيد الدبلوماسي الجزائر، في مواجهة احتلال الكيان الصهيوني المؤقّت لفلسطين. السمة الرئيسية للسياسة الخارجية الاميركية هي الارباك والعجز على تنفيذ الاهداف خاصة أنه هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والقدرات على التنفيذ. ما زالت الادارة الاميركية تعتمد على قوّة اندفاع سابقة دون أي أضافة أو تجديد لامكانياتها.
1-الملف الاوكراني والعلاقة مع روسيا
بالنسبة للإدارة الاميركية الجديدة القديمة وللنخب السياسية المتحكّمة بالقرار السياسي الخارجي الاميركي فإن الحرب في اوكرانيا هي اولوية ملحّة وإن كان ذلك الالحاح مبنيا على تناقضات جوهرية. فالنخب الحاكمة التي كانت تنفّذ إرادة الدولة العميقة سواء لأسباب عقائدية كالكره الاعمى لروسيا لأسباب عنصرية لا تعتبر العرق السلافي من العرق الابيض أو يتنمي إلى ثقافة غربية، أو لتحقيق مصالح اقتصادية كالحصول على امتيازات استغلال مناجم الاتربة الارضية النادرة، أو بسبب الفساد المستشري في البنية السياسية الاميركية حيث معظم المساعدات التي ارسلت إلى اوكرانيا عادت بشكل أو بآخر إلى أصحاب النفوذ في الولايات المتحدة. فهناك قوى استفادت من تقديم المساعدات لاوكرانيا وتنظّر لاستمرار المواجهة مع روسيا ليس فقط لاستنزاف روسيا بل للحصول على المزيد من الاموال المرسلة لاوكرانيا. هنا لا يمكن تجاهل عنصر الفساد في مراكز القوّة في الولايات المتحدة وفي اوكرانيا لاستفادة من حرب قُتل فيها حوالي مليونين اوكراني لا لسبب غير ذلك الفساد.
القمة التي حصلت في شهر آب بين الرئيسين الروسي والاميركي في الاسكا لم تسفر عن نتائج ملموسة حول إنهاء الحرب بل فقط عن ابتعاد ادارة ترمب عن الادارة المباشرة للصراع في اوكرانيا وتركها للاوروبيين. وعلى ما يبدو هنالك قناعة متزايدة داخل الادارة أن الحرب ستأخذ مجراها لتحقيق النصر المبين الروسي وأن لا جدوى في صرف المال والعتاد لاستمرار الحرب. وإذا اراد الاوروبيون الاستمرار فيها فهذا شأنهم والولايات المتحدة جاهزة لبيعهم الاسلحة التي لا تملكها الان والتي لن تستطيع تسليمها قبل بضعة سنوات!
لكن الرئيس الاميركي يواجه معارضة شديدة داخل إدارته وداخل الدولة العميقة في مشروعه ل “تطبيع” العلاقات مع روسيا. فبينما يرى إمكانية عقد صفقات تجارية وغير تجارية مع روسيا فإن المعارضين لذلك يرون أن روسيا تشكّل تهديدا مباشرا للهيمنة الاميركية لما تملكه من ترسانة نووية. وترى المعارضة الاميركية أن روسيا والصين ومعهما مجموعة البريكس تشكل تهديدا وجوديا لتلك الهيمنة فلا بد من الاستمرار في المواجهة المباشرة دون أي تطبيع يذكر مع روسيا.
من جهة اخرى فإن اللوبي النفطي والغازي يدعم الرئيس الاميركي في مشروعه التطبيعي مع روسيا آملا بالعودة إلى شرق روسيا للاسثتمار في جزر صخالين حيث اضطرت شركة اكسون التخلّي عن استثماراتها بسبب العقوبات على روسيا. وتقدّر الخسارة التي تكبدتّها الشركة بأكثر من 4 مليار دولار لذلك نراها حريصة على العودة إلى روسيا. هذا دليل آخر أن الداخل الاميركي ليس منسجما حول موقف واحد من روسيا والتجاذبات الداخلية تربك الادارة وتمنعها من وضع تصوّر متماسك. فالمواقف الصادرة هي ردود فعل على فعل يحصل خارج ارادتها. إضافة إلى ذلك فإن فريق مجلس الامن القومي والخارجية الاميركية ما زال تحت فبضة المحافظين الجدد الذين لا يريدون أي تقارب مع روسيا أو إيران أو الصين أو اي بلد يشكّل مصدر تنافس جدّي للولايات المتحدة. الاستراتيجية التي يروّجون لها هي المواجهة دون أي سقف. لكن في آخر المطاف، فإن إدارة ترمب خرجت فعليا من المستنقع الاوكراني ورمت الكرة بكاملها في احضان الاتحاد الاوروبي. والدليل على ذلك حوار الطرشان بين الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي حول العقوبات على روسيا حيث حدّد الرئيس الاميركي شروط العقوبات الاضافية على روسيا بأن تقطع الدول الاوروبية كل استيرادها وعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا وخاصة فيما يتعلّق بالنفط والغاز الذي ما زالت تستورده من روسيا عبر دول اخرى. وبما أن هذا الامر شبه مستحيل فإن العقوبات الاميركية المطلوبة اوروبيا لن تحصل في المدى المنظور.
2-الملف الايراني
من الواضح أن هدف الادارة الاميركية تحت إدارة ترمب تريد تغيير النظام القائم في الجمهورية الاسلامية في إيران والعودة إلى عصر الشاه عبرتنصيب ابن الشاه المخلوع كحد أقصى أو المجيء بفريق أكثر اعتدالا وراغبا في التفاهم مع الولايات المتحدة كحد ادنى. والحجة المتبعة هي الملف النووي الذي لا يشكّل موضوعيا أي تهديد للولايات المتحدة. فهناك تقارير في البنتاغون وحتى قي الدوائر العسكرية في الكيان الصهيوني الموقت تشير أنه بإمكان التعايش مع إيران نووية. المشكلة إذا هي في وجود النظام الذي يجب تغييرة إما تحت ضربات الداخل أو عبر ضربات من الخارج.
ليس في الافق ما يبشّر بإمكانية الوصول إلى تفاهم بين الادارة الاميركية والجمهورية الاسلامية في إيران. فالاحقاد الاميركية بسبب احتلال السفارة الاميركية في الايام الاولى للثورة الاسلامية ما زالت راسخة في الوعي الاميركي كما أن النزعات المعادية للاسلام تتضافر مع رفض وجود أي معارضة للسياسات الاميركية في الإقليم. وموقف الجمهورية الاسلامية الداعم للمقاومة في لبنان وفلسطين وفي العراق واليمن يعزّز العداء الاميركي لإيران.
العدوان الاميركي في شهر حزيران/يونيو 2025 على ايران استهدافا للبنية التحتية للبرنامج النووي في إيران لم يسفر عن نتائج تذكر رغم ادعاءات الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء الصهيوني ب “محو” البرنامج النووي نتيجة للضربات. فإذا كان ذلك صحيحا لماذا تصرّ الولايات المتحدة على تفيكك البنية التحية والتراجع عن التخصيب؟ من جهة اخرى، ظهرت تقارير من المؤسسة الاستخباراتية الاميركية للدقاع (DIA) أن نتائج العدوان الاميركي على المفاعلات النووية الايرانية لم تكن كما تمّ الادعاء ما أثار غضب الرئيس وإقالة المسؤول الكبير في المؤسسة الاستخباراتية وعدد من معاونية للتناقض مع السردية للرئيس الاميركي. هنا نشهد أن الادارة الاميركي لا تملك استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ في الملف الايراني ما يؤكّد حالة الارباك. الرغبات والتنمنيات الاميركية لا تشّكل استراتيجية حيث هناك رؤية واضحة لوضع الاليات والتنفيذ.
3-الملف الصيني
السمة الرئيسية لسياسة الادارة الاميركية تجاه الصين هي العداء العالي النبرة في الاعلام ومحاولات الوصول إلى تفاهم مع الصين فيما يتعلّق بالتعريفات الجمركية. فالمصالح المشتركة والتشبيك بين الشركات الاميركية والصينية تجعل أي محاول لفك الارتباط مكلفة للغاية، على الاقل بالنسبة للفريق الاميركي. فمنذ الثمانينات من القرن الماضي حتى وصول الرئيس الديمقرطي باراك اوباما كانت العلاقات بين الطرفين مزدهرة حيث وجد الطرفان مصحلة مشتركة في العولمة وتشبيك المصالح. لكن التقدّم الصيني أقلق النخب الحاكمة في الولايات المتحدة فأقدمت إدارة اوباما على تغيير استراتيجيتها الكونية ألا وهي الالتفات إلى شرق أسيا (pivoting to East Asia). وفي ولاية ترمب الاولى وفيما بعد في ولاية بايدن تراجعت العلاقات حتى وصلت الى النفور والعدائية الصريحة من قبل الفريق الاميركي الذي اعتبر أن النظام القائم في الصين نظام تسلّطي يجب تغيير سلوكه في الحد الادنى أو تغييره بشكل كامل كما كان يسعى جورج سوروس.
اما في ولاية ترمب الثانية فالامور اخذت منحى أكثر تعقيدا بعد أن فرض تعريفات جمركية على الصين. نتيجة هذه السياسة متعدّدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي. التخبّط في الملفّ الثاني لا يختلف عن التخبّط في العديد من الملفّات. فعلى الصعيد الاقتصادي كانت تداعيات التعريفات الجمركية خسارة الاسواق الصينية بالنسبة للسلع الاميركية. وعلى صعيد الاستيراد الصيني فقد استبدلت الصين البرازيل كمصدر للقهوة. والانتاج البرازيلي تحوّل إلى الصين بأكمله. بالمقابل استدارت الصين نحو البرازيل كمصدر أساسي لاستيراد فول الصويا التي كانت تستورده من الولايات المتحدة وبذلك بسبب التعريفات الجمركية المفروضة على الصين. وعلى صعيد الطاقة فقد توقّف تصدير غاز البروبان من الصين الى الولايات المتحدة. لسنا هنا في إطار سرد كامل التداعيات لسياسات ترمب تجاه الصين لكن لا بد من الاشارة إلى شركات التصنيع العسكري الاميركية منكشفة في سلاسل التوريد تجاه الصين ومن الصعب تغييرها قبل فترة طويلة من الزمن. وعلى صعيد آخر، فقطاع التكنولوجيا المتطوّرة يحتاج إلى معادن الاتربة النادرة التي معظم احتياطها موجود في الصين. فكيف تسطيع الولايات المتحدة أن تحافظ على مكانتها في التكنولوجيا إذا ما حرمت الصين الولايات المتحدة من تلك المعادن وخاصة تلك التي تتعلّق بالذكاء الاصطناعي. في خلاصة الامر يمكن القول أن الصين ما زالت حاجة اميركية بينما الولايات المتحدة لم تعد حاجة صينية.
على صعيد آخر الصعوبات التي اوجدتها ادارة ترمب تجاه الاجانب وخاصة تجاه الطلاب بما فيهم الطلاب الصينيين فإن الشركات الاميركية الكبرى والجامعات الكبيرة ضغطت على الرئيس الاميركي لحلحلة الموضوع والسماح لحوالي 600 الف طالب صيني التوجّه للولايات المتحدة. فالقطاعات الاقتصادية الاميركي بحاجة إلى التدفّق البشري الماهر الصيني. والطلاب الصينيون يدفعون كافة نقاتهم التعليمية ما يشكّل مصدر واردات للجامعات. هذه بعد النماذج عن التناقضات في سياسات ترمب تجاه الصين. وما زاد الطين بلّة الاستعراض العسكري الضخم الذي تبع قمة منظمة شنغهاي وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير الصين من الاحتلال اليباني في الحرب العالمية الثانية. المعلومات تفيد أن الرئيس الاميركي ومعه العديد من النافذين في الادارة فوجئوا بما قدمته الصين.
عند اعداد هذا التقرير لم تتضح معالم الخطوات المقبلة للرئيس الاميركي تجاه الصين. فليس بإمكان الادارة الاميركية التفكير بأي مواجهة عسكرية مع الصين في قضية تايوان وخاصة بعد الاخفاقات البحرية في البحر الاحمر، كما لايستطيع التراجع عن الوعود التي قطعها على قاعدته الانتخابية باسترداد الوظائف التي “سرقتها” الصين. وهناك مؤشرات تشير إلى أن ترمب لا يرغب في المواجهة المباشرة مع الصين بل يفضّل الوصول إلى تفاهمات تجارية. من هنا دلالة الاتفاق على “تأجير” شركة تيك توك لشركة اوراكل الاميركية واللقاء الاخير بين الرئيس الاميركي والصيني في آخر شهر اوكتوبر 2025 وما نتج عنه من تصريحات تخفّف التوتر.
4-الملف الفلسطيني وغزّة
عند اعداد هذا التقرير تفيد المعلومات أن إدارة ترمب في الموضوع الفلسطيني ترفض المشاريع الجزئية للهدنة. فعلى ما يبدو اعطت إدارة ترمب لحكومة الكيان المؤقت الضوء الاخضر “لإنهاء الموضوغ” في غزة قبل نهاية 2025 اذا استطاع وإلاّ فعليه أن يلتزم بمبادرة ترمب. فسنة 2026 سنة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ولا يريد الرئيس الاميركي أي شيء يعكّر مزاج الناخب الجمهوري. فسنة 2026 يجب أن تكون الولايات المتحدة خارج أي حرب ورثتها من إدارات سابقة أو شجّعتها في 2025. والموقف الاميركي يحمل أيضا تهديدا لرئيس وزراء الكيان المؤقت وفقا لما جاء على لسان الرئيس الاميركي حيث قال أن الكونغرس الاميركي لم يعد مؤيّدا مطلقا للكيان وأن نفوذ اللوبي الصهيوني فقد هيبته ونفوذه في الكونغرس. هذا الكلام الخطير قد يشكّل نقطة تحوّل في العلاقات مع الكيان إن لم يستطع الكيان “انهاء المهمة” في غزة وفقا لتصريح سابق. لكن السؤال الاساسي هو هل بمقدور الكيان المؤقت القيام بذلك؟ هذا ما سيتم مقاربته في فقرة لاحقة. لكن هناك تساؤلات في العديد من المنصّات الاميركية حول جدوى هذه الحلول وإمكانية تحقيق أهدافها خاصة بعد الاخفاق الكبير لقوّات الاحتلال بعد سنتين وحتى بعد التدخّل الواسع للولايات المتحدة في إنقاذ الكيان من المواجهة مع المقاومة في لبنان. كما أن اخفاق البحرية الاميركية في البحر الاحمر أسقط نظرية التفوّق العسكري للولايات المتحدة في السيطرة على الممرّات البحرية التي شكّلة قاعدة “اسقاط القوّة” لها في العالم (power projection).
المشاريع الاميركية المطروحة لغزّة لا تختلف عن المشاريع المطروحة لكل من لبنان وارمينيا وتعكس مقاربة العلاقات الدولية في عقل الرئيس الاميركي. فالسياسة هي الغطاء السياسي لمشاريع تطوير عقاري فقط لا غير ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول ناهيك عن مصالح الشعوب. والمشاريع المطروحة تتماهى مع بعض تطلّلعات وأطماع الكيان الصهيوني. فالادارة تسعى إلى نزع سلاح المقاومة في كل من غزّة ولبنان غير أن قدرة تنفيذ تلك المهمة باتت معدومة بعد فشل قوّات الاحتلال في تحقيق أي من الاهداف في كل من غزة ولبنان. وهذا الفقر في التفكير السياسي يعكس ضحالة النخب الاميركية الحاكمة والتي أصبحت منقطعة عن واقع الدول والشعوب في العالم. لذلك نشهد الاخفاقات تلو الاخفاقات في المقاربات السياسية للملفّات الاساسية التي تهمّ الادارات الاميركية المتتالية. فرداءة النخب الحاكمة تغذّي ثغرات الخيارات والسياسات المتبعة التي أوصلت الولايات المتحدة إلى الحالة التي تهدّد تماسكها الداخلي ومكانتها في العالم.
اما فيما يتعلٌّق بخطة ترمب حول غزّة والتي تم التباحث فيها مع عدد من الدول العربية والاسلامية ومن بعد ذلك مع الكيان الصهيوني المؤقت فإن الهدف كان احراج حركة حماس واجبارها على رفض الخطة وتحميلها بالتالي كافة مسؤولية المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني والتي ستحظى إلى “شرعية” ومباركة أميركية واضحة وإلى حد كبير من قبل الدول العربية. غير أن المرونة التي تتمتع بها الدبلوماسية المقاومة استطاعت من خلالها القبول بمبدأ اطلاق سراح الاسرى لكن بعد وقف العمليات العسكرية والتفاوض على تفاصيل التنفيذ. بمعنى آخر تم رمي الكرة في ملعب الرئيس الاميركي والكيان الصهيوني. وعلى ما يبدو، تلقّق الرئيس الاميركة الفرصة للضغط على نتنياهو لإيقاف القصف فورا ما يعزّز الشعور بان الرئيس الاميركي ليس راغبا في أي مواجهة عسكرية رغم التصريحات الاستعراضية العدوانية.
ث- القدرات والجهوزية العسكرية والاداء العسكري
الحرب في اوكرانيا وطوفان الاقصى كانت لهما ارتدادات كبيرة على القدرة العسكرية الاميركية في مواجهة خصومها على المدى المتوسّط والطويل. فالدعم الاميركي في التسليح والتذخير لكل من اوكرانيا والكيان المؤقت افرغ الترسانة الاميركية التي وصلت إلى حدّ الخطر كما يقول البنتاغون الاميركي. فلم يعد بالامكان للولايات المتحدة المزيد من تزويد حلفائها في السلاح والذخيرة. واهم من كل ذلك فقد انكشفت العورة الاميركية في انتاج الاسلحة حيث المجمّع العسكري الصناعي يعجز عن تلبية حاجات البنتاغون في المرحلة الراهنة وحتى في المستقبل القريب. وصفقات السلاح التي غُقدت مؤخرا مع دول الجزيرة العربية والتي ستُعقد مع الدول الاوروبية للاستمرار في الحرب على روسيا لن يتمّ تسليم السلاح قبل بضعة سنوات على الاقل. إلاّ أن عامل الوقت في الميدان في اوكرانيا كما في الكيان المؤقّت يجعل من هذا التأخير في تسليم الاسلحة امرا خطيرا على إمكانية الاستمرار في الحرب. والتأخير في تسليم السلاح يعود إلى بنية الشركات التصنيعية العسكرية التي أنتجت سلاحا مكلفا للغاية وبكمّيات محدودة ما يجعل قدرة الولايات المتحدة على خوض حروب طويلة أمرا شبه مستحيل. هذا ما حصل بالفعل في المواجهة مع اليمن حيث اضطرت الاساطيل من الانسحاب من ساحة المعركة لفقدانها الذخيرة التي استهلكت في قصف اليمن، دون تحقيق أي نتيجة تغيّر في قدرات اليمن. والانسحاب يعود ايضا الى اخفاق وسائل الدفاع الاميركية في مواجهة الصواريخ البالستية والمسيّرات. فعدم التوازن بين عدد الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها اليمنيون وعدد وسائل الدفاع الاميركية وعدم جدواها امام الصواريخ الدقيقة والفارقة للصوت أكدّت أن السيطرة على البحر الاحمر لم تعد ممكنة بالنسبة للبحرية الاميركية.
من جهة اخرى هناك تقارير من مراكز مقرّبة من البنتاغون تفيد أن مدى الانكشاف في صناعة الاسلحة في الولايات المتحدة لدى الصين كبيرة جدّا ما يعني أن في حال مواجهة عسكرية مع الصين لن تستطيع الولايات المتحدة انتاج ما تحتاجهة من سلاح وذخيرة بسبب سيطرة الصين على سلسلة التوريد. كما ان مركز ابحاث “هريتاج فونديشن” (Heritage Foundation) يصدر كل سنة في شهر شباط/فبراير تقريرا مفصّلا عن جهوزية القوّات المسلّح الاميركية. وجاء في التقارير الستة الاخيرة أن الجهوزية في الحد الاقصى هي “هامشية” (marginal) ما يثير التساؤل حول الانفاق الضخم في وزارة الدفاع (الحرب اليوم!) والترجمة الفعلية لمواجهة خصوم واعداء الولايات المتحدة.
في هذا السياق لا بد من الاشارة إلى تقارير عديدة من خبراء عسكريين في الولايات المتحدة وفي آسيا تفيد أن السلاح الاميركي هو سلاح القرن العشرين بينما نرى التجهيزات الروسية والصينية وحتى الايرانية هي تتناسب مع حروب القرن الحادي والعشرين. فامتلاك الصواريخ الفارقة للصوت لكل من روسيا والصين وايران وعدم وجود أي شيء يماثله في الترسانة الاميركية وخاصة في وسائل الدفاع والتصدّي كما حصل في المواجهة بين البحرية الاميركية واليمن وبين القوّات الاميركية والصهيونية في مواجهة ايران تفيد أن ربما الاساطيل البحرية الاميركية اصبحت خردة عائمة يمكن القضاء عليها في وقت قصير للغاية. التوازن العسكري التقليدي انكسر لصالح السلاح الشرقي وهذا يشكّل نقلة نوعية لم تكن بالحسبان. من جهة اخرى فإن التقدّم في السلاح الجوّي الروسي والصيني برهن عن تفوقّقه على السلاح الجوّي الاميركي في المواجهة بين باكستان والهند حيث السلاح الجوّي الصيني تفوّق بشكل كاسح على السلاح الغربي سواء كان اميركيا أو فرنسيا أو بريطانيا. هذه المعادلة العسكرية الجديدة ما زالت تتنكّر اليها النخب الحاكمة في الولايات المتحدة التي ما زالت تعتقد أن السلاح الاميركي متفوق على السلاح الشرقي. ولكن الاخطر من كل ذلك هو عدم قدرة الولايات المتحدة على خوض حروب معقّدة رغم كثافة القدرات النارية التي تمتلكها. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تربح الولايات المتحدة أي حرب خاضتها سواء في شرق آسيا (كوريا في الخمسينات) أو في جنوب شرق آسيا في الستينات والسبعينات (فيتنام) أو في وسط أو غرب آسيا في احتلال كل من العراق وافغانستان. قدرة الولايات المتحدة على التدمير موجودة لا غبار عن ذلك لكن ترجمة تلك القدرة إلى مكاسب سياسية كانت وما زالت شبه معدومة. الولايات المتحدة كالكيان الصهيوني المؤقت تجيد القتل ولكن لا تجيد القتال رغم الامكانيات الضخمة. والحروب الالكترونية التي شنتها طابعها أمني أكثر مما هو عسكري ميداني. فهناك قدرة على القتل ولكن ليس على الحسم العسكري رغم القدرات النارية الهائلة.
هذه الحقائق التي تقرّ بها النخب الحاكمة بشكل مبطّن وليس علنا تشكّل قاعدة التحوّل في الدفاع الاستراتيجي للولايات المتحدة. فالتقرير الصادر عن البنتاغون والذي حرّره الريدج كولبي يقول بصراحة أن مهمة القوّات المسلّحة الاميركية هي الدفاع عن حدود الولايات المتحدة وجعلها حصنا منيعا. هذا يعني أن أي تفكير في مواجهة عسكرية مع الصين قد فات أوانها وكذلك الامر بالنسبة للمواجهات العسكرية الكبرى مع روسيا أو الجمهورية الاسلامية في إيران. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلّى عن العنف كعمليات محدودة أو عمليات امنية لكن من الواضح ان الانكفاء هو العنوان العريض. هذا على الاقّل ما يحصل في إدراة ترمب والسؤال هل كافة مكوّنات الدولة العميقة في الولايات المتحدة ستسمح بذلك؟ هذا موضوع بحث منفصل خارج عن تقدير الموقف الحالي ولكن يعكس حالة الارباك البنيوي الذي يتحكّم بالنخب الحاكمة في الولايات المتحدة.
في خلاصة الامر وتأكيدا لما جاء في التقارير السابقة المقدّمة للمؤتمر القومي العربي وامانته العام في السنّوات الماضية فإن المستجدّات في الولايات المتحدة تؤكّد مسار التراجع بل ربما الافول. فالقدرات العسكرية استنفذت لتحقيق اهداف الهيمنة والتراجع الاقتصادي ينذر بنهاية دورها في العالم كدولة تستطيع فرض ارادتها على العالم. وهذا يتجلّى بنتائج مؤتمرات البريكس ومنظمة شنغهاي حيث نظام سياسي واقتصادي جديد أصبح قائما رغم محاولات الولايات المتحدة والغرب الاجمالي.
الاستمرار في القرارات التي تؤدّي إلى عزلة الولايات المتحدة دوليا ستؤدّي إلى الانعزالية الداخلية التي لا تستطيع أن تعيش خارج الاطار التفاعل العالمي. مسارات التفكّك والانهيار الداخلي ما زالت قائمة حتى مع محاولات ترمب لتصحيح بعض الثغرات في البنية السياسية والاقتصادية. لكن فقدان الرؤية المتكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا سيحد من قدرات محاولات التغيير.
ثانيا- المستجدّات في المشهد الاوروبي
لاحظنا في المشهد الاوروبي تاكيدا للتصدّعات الحادة بين دول الاتحاد وداخل دول الاتحاد والتي كانت التقارير السياسية السابقة للمؤتمر القومي العربي تشير إليها. والتصدّعات تعود إلى عدم وجود اجماع حول الحرب في اوكرانيا على روسيا. فاللجنة العليا للاتحاد الاوروبي برئاسة اورسولا فون ديرلايدن تسعى إلى استمرار الحرب على روسيا في اوكرانيا رغم الخسائر الفادحة لدى الجيش الاوكراني والشلل شبه التام في المشهد الاقتصادي الاوكراني والاستنذاف المالي الكبير في دول الاتحاد من جرّاء تمويل الحرب. وهناك دول تعترض على استمرار الحرب كالمجر وصربيا وسلوفاكيا بينما دول كالمملكة المتحدة والمانيا وفرنسا ودول البالطيك ما زالت تسعى إلى استمرار الحرب.
من جهة أخرى نشهد تصدّعات بين الدول الاوروبية حيث العلاقات الثنائية تأثرت بسبب المواقف من الحرب في اوكرانيا. فالعلاقات تتدهور بين بولندا والمجر، وبين ايطاليا وفرنسا، وبين ايطاليا والمانيا، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. كما أن استمرار الحرب جعل قيادات الدولة المعنية باستمرارها اتخاذ قرارات في تخفيض التقديمات الاجتماعية لزيادة الانفاق العسكري جعل شعوب هذه الدول كفرنسا والمملكة المتحدة والمانيا تعترض على تلك الاجراءات. هذا الامر يساهم في صعود التيّارات اليمينية المتطرّفة في معظم الدول الاوروبية التي بنت صعودها على خطاب عنصري تجاه المهاجرين المسلمين وتجاه المهاجرين الاوكرانيين حيث أكثر من نصف سكّان اوكرانيا هاجر إلى الدول الاوروبية المجاورة. كما ان الاعتراض على الحرب في اوكرانيا ساهم في تعزيز مواقف ذلك اليمين المتطرّف والقومي الاتجاه حيث لا يجد أي مصلحة قومية في التورّط في تلك الحرب التي هي من صنع النخب الليبرالية والنيوليبرالية المتحكّمة بالقرار السياسي والاقتصادي في اوروبا.
العنصر الجديد الذي لاحظناه هو حضور فلسطين في صلب الخطاب السياسي. فرغم محاولات قمع التظاهرات وكل من يؤيّد فلسطين وينتقد الكيان الصهيوني المؤقّت بحجة معادة السامية فإن الجماهير الاوروبية خرجت بكثافة وعلى مدى السنتين الماضيتين في احتجاجات عارمة عمّت العواصم والمدن الكبيرة في اوروبا. وهناك عدد من الدول الاوروبية فرضت عقوبات وقاطعت الكيان كايرلندا واسبانيا ومؤخّرا هولند حيث استقال وزير الخارجية مع عدد من زملائه من الوزارة احتجاجا على سياسة الدولة التي ما زالت تدعم الكيان.
وهناك ظاهرة جديدة في الموقف الاوروبي تجاه فلسطين حيث اعلنت عدة دول اوروبية عن عزمها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم محاولات اميركية وصهيونية لمنع ذلك. المهم في هذا الموضوع هو أن اعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ياتي ك “معاقبة” لسلوك الكيان في غزة وليس لأن الحق الفلسطيني هو الاساس. وعلى ما يبدو فإن هذا الموقف جاء ليمتصّ الغضب الشعبي على حكومات الدول التي ما زالت تتعامل مع الكيان المؤقّت كأن لم يحصل شيء. ونلاحظ أيضا بداية تحرّك النقابات العمّالية في مقاطعة الكيان كاعلان عمّال المرافئ الايطالية رفضهم تحميل أو تفريغ السفن التابعة للكيان أو المتجهّة إلى الكيان.
تداعيات التصدّعات تنذر بتفكّك المجتمعات الاوروبية وسقوط حكوماتها وصعود اليمين المتطرّف. فكرة الاتحاد الاوروبي أصبحت على المحك والصورة التي اعطتها القيادات الاوروبية في المكتب البيضاوي للرئيس الاميركي بعد قمة بوتين وترمب في الاسكا تؤكّد على تراجع دور وهامشية اوروبا في الشان العالمي. وما يزيد الطين بلّة هو حضور دولة سلاوفاكيات قمّة منظّمة شنغهاي كالدولة الاوروبية الوحيدة في تلك القمة والتي تعبّر عن الدور المتنامي والحاسم للكتلة الاوراسية ومنظمة شنغهاي ومجموعة البريكس.
في خلاصة الامر، إن الاتحاد الاوروبي بسبب تبعيته للولايات المتحدة وانخراطه كلّيا بالحرب الاوكرانية على روسيا دخل مرحلة ما بعد التصنيع بعد أن وافق على نسف انبوب الغاز الروسي نورث ستريم. انقطاع تدفّق الغاز الرخيص وإحلال مكانه الغاز الاميركي المستورد بكلفة اربعة اضعاف عما كانت تدفعه الدول الاوروبية وخاصة المانيا يعني نهاية القدرات التنافسية التصنيعية الاوروبية. فالاتحاد الاوروبي الذي كان يشكّل ثاني اقتصاد في العالم مرشّح ليصبح كتلة اقتصادية هامشية لا تأثير له في موازين القوّة في العالم. والكراهية الالمانية المتصاعدة ضد روسيا تعني أن ذاكرة الحرب العالمية الثانية وخاصة هزيمة المانيا النازية على يد الاتحاد السوفيتي ما زالت راسخة في الوعي الالماني. لذلك نرى غياب حتى الحد الادنى من العقلانية في التعاطي مع روسيا حيث وصف المستشار الالماني الرئيس الروسي بأسواء مجرم حرب في التاريخ متجاهلا عمدا دور رئيس الوزراء الكيان المؤقّت في الابادة الجماعية التي تحصل امام أعين الجميع.
ثالثا- المواجهة في اوكرانيا
التطوّرات الميدانية في اوكرانيا تفيد أن الكفّة العسكرية أصبحت مائلة بشكل كامل لصالح العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا. الانهيارات المتتالية للخطوط الدفاعية الاوكرانية تنذر بأن مصير الحرب أصبح قاب قوسين أو ادني لصالح روسيا وأن الحلّ هو الحل الذي ستفرضه روسيا. هذا ما كان متوقّعا في التقارير السابقة واليوم أصبحت مسالة التوقيت. هناك رهان في بعض المنصّات الموالية للسياسة الروسية أن الحسم قد يكون قبل نهاية عام 2025 وفي الحد الاقصى في ربيع 2026. الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي كانا يراهنان على التدخّل الاميركي في المواجهة العسكرية غير أن ترمب كان حازما أن الولايات المتحدة لن ترسل جنودا ولن تقاتل في اوكرانيا. لكن هي على استعداد بيع الاسلحة (التي لا تملكها الان!) للاطلسي وللاتحاد الاوروبي ولكن الولايات المتحدة لن ترسل بشكل مباشر معدّات عسكرية لاوكرانيا ولا مساعدات مالية. هناك معارضة داخل ادارة ترمب حول هذا الموقف إلاّ أن موازين القوّة داخل الادارة الاميركية هي لصالح عدم الانخراط عسكريا في اوكرانيا. ومن يقود هذا الموقف إلى جانب الرئيس الاميركي نائبه جي دي فانس الذي اصبح الوريث غير المسمّي لقيادة الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
اما الكلام عن تكوين جيش اوروبي أو ارسال وحدات من الجيوش الاوروبية لاوكرانيا فالقدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية لدول الاوروبية في الاقدام على تلك الخطوة شبه معدومة. هناك تعويض عن العجز المادي في رفع النبرة الاعلامية العدائية تجاه روسيا لكن مفاعيل ذلك الموقف ما زالت محدودة للغاية إن لم تكن معدومة. وهذه الدول التي ما زالت ملتزمة باستمرار الحرب تواجه ضغطا شعبيا متصاعدا لأن تلك المواجهة ستؤدّي حتما إلى تقليص التقديمات الاجتماعية إضافة إلى المزيد من التضييق على حرّية التعبير وانتقاد سياسات الحكومات. ومن جهة اخرى نشهد أن رئيسة لجنة الاتحاد اورسولا فان دير ليدن تواجه انتقادات عنيفة سواء في اداءها السياسي أو في ارتكابها فضائح مالية ناهيك عن جذور عائلتها المرتبطة بالنازية الالمانية.
الخلاصة للمستجدات في كل من الولايات المتحدة واوروبا هي تراجع فعّالية الغرب الاجمالي الذي يواجه الاخفاقات تلو الاخفاقات على كافة الاصعدة. فالغرب الاجمالي أصبح خارج التاريخ وقد يكون خارج الجغرافيا إن لم يحصل أي تغيير جذري في البنى السياسية والاقتصادية والعسكرية، واهم من كل ذلك في الذهنية الثقافية والقيمية والاخلاقية.
الجزء الثاني: المشهد في الكتلة الاوراسية والجنوب الاجمالي
المستجدات على الصعيد الدولي في دول الكتلة الاوراسية ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي ومجمل دول الجنوب الاجمالي تؤكّد ما جاء في التقارير السابقة حول صعود تلك المجموعة التي تطرح ضرورة مراجعة اسمس العلاقات الدولية على قاعدة الالتزام بميثاق الامم المتحدة، واحترام سيادة الدول والتعامل بينها على قاعدة الندّية، وأن العلاقات السياسية والاقتصادية لا يجب أن تخضع إلى قاعدة اللعبة الصفرية التي فرضها الغرب وخاصة الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة، بل على قاعدة الربح المشترك. في هذا الجزء من التقرير سنستعرض بشكل سريع بعد العلامات الفارقة التي تشكّل منعطفات كبيرة في مسار المشروع المناهض للهيمنة الغربية وخاصة الاميركية.
1-الصين
التقارير السابقة أشارت إلى صعود الصين والانجازات التي حققّتها. فاليوم اصبحت الصين دولة تقود العالم في الاقتصاد وتعتمد على تلك القوّة الاقتصادية لتثبيت حضورها السياسي. ومن مستلزمات تثبين الحضور السياسي هو ابراز قدرات عسكرية في الكم والنوع لم تكن في الحسبان وخاصة في دول اجمالي الغرب. والاستعراض العسكري الذي اقامته الحكومة الصينية بحضور الرئيس الروسي وكوريا الشمالية بمناسبة احتفالات نهاية الحرب العالمية الثانية وتحرير الصين من العدوان الامبريالي الياباني كان بمثابة الصاعقة التي وقعت على رأس الرؤوساء الغربيين. ومن يقارن الاستعراض العسكري الذي اجري في مطلع الصيف في العاصمة الاميركية في ذكرى ميلاد القوّات المسلّحة منذ 250، مع الاستعراض العسكري الذي اجري في العاصمة الصينية يرى مدى الفرق في الانضباط والدقة في التنفيذ. في مطلق الاحوال القدرات العسكرية الصينية باتت واضحة بعد تجارب قدرات السلاح الصيني والسلاح الغربي في المواجهة بين باكستان المسلّحة صينيا والهند المسلّح بطريقة هجينة بسلاح غربي وبعض شرقي. أسرار الطائرة جي 20 الصينية الفارقة للصوت والتي لا تستطيع الردارات الغربية رصدها قد تشير إلى احتمال جدّي في كسر التفوّق الجوّي الاميركي السابق والتي دائما كانت تعرضه هوليوود كحقيقة لا يمكن مناقشتها.
مصادر القوّة الصينية هي في الاقتصاد ومصادر قوّة الاقتصاد هي في الاستثمار المكثّف في التربية والعلوم. ونعرض هنا بعض الارقام المذهلة التي تُفسّر قدرات الصين في التكنولوجيا والصناعة. أشارت التقارير المتعدّدة حول الصين والتي ذكرتها صحيفة “الايكونومست” البريطانية المحافظة والمعادية بشكل صريح لكل من الصين وروسيا أن عدد المنتسبين لدراسة الهندسة لسنة 2025 تجاوز 4،8 مليون طالب. وهذا الاقبال يدلّ على نجاح الحكومة الصينية في توجيه الطلبة حيث حوالي 36 بالمائة من المجموع المذكور توجّهوا نحو التكنولوجيات المتقدمة بينما النسبة في سنة 2024 كانت 32 بالمائة فقط. بالمقابل، فإن نسبة توجّه الطلاب البريطانيين والاميركيين للعلوم الهندسية لا تتجاوز 5 بالمائة. فكثرة المهندسين الصينيين أدّت إلى ارتفاع المهارة وبالتالي الانتاجية وبالتالي انخفاض كلفة الانتاج. والتقارير تشير أن ليس انخفاض كلفة اليد العاملة سبب القدرة التنافسية في إلانتاج، بل هي نتيجة الاستثمار في اليد العاملة وتنميتها. لسنا هنا في استعراض مكامن القوّة والتفوّق الصيني في الصناعة والتكنولوجيا بل الاشارة إلى أن السياسات المتبعة والتي ترتكز إلى تخطيط مركزي افرزت مشاريع الحزام الواحد الطريق الواحد، النسخة لقرن الحادي والعشرين لطريق الحرير القديمة. ومشروع مبادرة الحزام الواحد يتركز على ترويج التشبيك الفارط في التواصل والمواصلات ما يفسّر التركيز على الاستثمارات في البنى التحتية التي تتجاوز حدود الصين وتمتد غربا عبر القارى الاسيوية وصولا إلى شواطئ البحر المتوسّط. كما ان تلك الطريق تتكامل مع مشاريع الممرات شمال وجنوب التي تربط شمال روسيا بالمياه الدافئة في المحيط الهندي والتي تعبر دول آسيا الوسطى. المشاريع الصينية لها أبعاد جيو استراتجية واضحة تساهم في تعزيز جاذبية النموذج الصيني للتنمية والنمو. لذلك نشهد الاقبال المتزايد من دول جنوب شرق آسيا وصولا إلى الدول الافريقية للتعامل والتشبيك مع الاقتصاد الصيني.
وتأكيدا لما سبق، نعرض خريطة للعالم تشير إلى المساحة الجغرافية الاقتصادية التي تتعاطى مع الصين في سنة 2020 مقارنة مع سنة 2000. وتشير هذه الخريطة أن عدد الدول التي كانت تتجار مع الصين سنة 2000 كان محدودا ومحصورا في شرق ووسط آسيا بينما أكثرية الدول في العالم كانت تتاجر مع الولايات المتحدة. اما في عام 2020 فالاكثرية الساحقة للدول في العالم تتاجر مع الصين بينما عدد الدول التي تتاجر مع الولايات المتحدة أصبح محدودا جدّا ويقتصر على كندا والمكسيك واميركا الوسطى وبعض دول اوروبا الغربية. (مصدر الخريطة تقرير من موقع بلومبرغ).
الغرب وخاصة الولايات المتحدة تتحفّظ على الصعود الصيني اقتصاديا وبالتالي سياسيا. والصعود العسكري الذي شهدناه في الاستعراض الاخير هو لحماية المشاريع الاقتصادية. ما يلفت النظر هو ان المشاريع الاقتصادية عبر آسيا وإفريقيا ودول الجنوب الاجمالي هي ليست للتوسع وللهيمنة على طراز الغرب بل لتحصين الوضع الداخلي في الصين. لقد استوعبت القيادات الصينية أن النموذج التنموي الذي اتبعته خلال العقود الخمسة الماضية ارتكز على التصدير بشكل عام وعلى التصدير إلى الولايات المتحدة بشكل خاص. هذا النموذج لم يعد قابلا للاستمرار لسببين: اولا السوق الداخلي الصيني أصبح يوازي إن لم يتفوّق على السوق الأميركي وبالتالي لا داعي لبذل الجهود لغزو السوق الاميركي، وثانيا، لان ردّة الفعل الاميركي من جرّاء تراجع الصناعات الاميركية وخسارة السوق الاميركي للصادرات الاسيوية بشكل عام والصينية بشكل خاص خلق مناخا ومزاجا سياسيا معاديا للصين هي بغنى عنه. لذلك نرى القادة الصينيين يبذلون الجهود لطمأنة نظرائهم الاميركيين إلاّ أن الاخرين ما زالوا في حالة الهلع والبارونيا من العملاق الصيني. لكن هناك بوادر واضحة ان إدارة ترمب رغم الكلام العالي النبرة تسعى إلى التفاهم مع الصين وليس المواجهة وإن كانت المواجهة مطلبا لمراكز قوة ونفوذ في الدولة العميقة ولنزوات المحافظين الجدد والمتدخلّين الليبراليين الذين يعتمدون قاعدة اللعبة الصفرية مع العالم وخاصة مع الصين. لذلك هناك اسباب وجيهة تشير إلى عدم التصادم العسكري الذي لا تريده الصين والتي لا تستطيع تحمّله الولايات المتحدة، على الاقل في المدى المنظور.
من ضمن المبادرات الاقتصادية السياسية التي تقوم بها الصين مع روسيا هي ترسيخ كتلة جغرافية اقتصادية وعسكرية تضم كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية. ومؤخّرا تعمل الصين وروسيا على ادخال مونغوليا في ذلك التكتل ما يسمح لاستثمارات ضخمة في الطاقة في فضاء سيبيريا. من جهة اخرى، تعمل الصين مع روسيا على الاستثمار في الممر القطب الشمالي الذي يربط آسيا باوروبا وحتى الولايات المتحدة ما يقلّل من قيمة الممرات البحرية اليت كانت تسيطر عليها الامبراطوريات السابقة وحاليا الولايات المتحدة. في هذا السياق، المتضرّر الكبير من الممر في القطب الشمالي هو قناة السويس الذي سيفقد او تتراجع مكانته الاستراتيجية التي تحلّى بها على مدى قرنين من الزمن.
ومن ضمن توجّهات الدولة الصينية التكامل مع روسيا وكوريا الشمالية سياسيا واقتصاديا وعسكريا إضافة إلى تعزير المشروع الاوراسي عبر اطلاق مبادرات عدة كمنظومة شنغهاي للامن المشترك وفيما بعد منظومة البريكس. هذه المبادرات كانت ارضية لدبلوماسية فعّالة جعلت من الصين مرجعا سياسيا للعديد من الدول. فمبادرات التقارب بين دول متحاربة كالتقارب بين الجمهورية الاسلامية في إيران وبلاد الحرمين، ومحاولات توحيد الصفوف بين الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ومؤخّرا تخفيف التوتر مع منافسها اللدود أي الهند، فهذه المبادرات تدلّ على أن الصين تكتسب الاصدقاء عبر مقاربة الهواجس وتؤسس مع روسيا قواعد العلاقات بين الدول والتي تختلف كلّيا عن سلوك دول الغرب الاجمالي الذي يعتمد قاعدة اللعبة الصفرية وعدم احترام سيادة وهواجس الدول.
على صعيد آخر، فإن انكشاف الولايات المتحدة تجاه الصين وخاصة في الصناعات العسكرية يشكّل ورقة ضاغطة لصالح الصين ويربك احتمالات الممكنة للولايات المتحدة لتغيير مسار الصين. ومشاريع المواجهة الاميركية مع الصين تصطدم بهذا الواقع الذي لا يسمح بمواجهة عسكرية وسلسلة التوريد الصناعية للشركات التصنيع العسكري الاميركي تتحكّم بها الصين في المدى المنظور. لذلك نشهد محاولات تخفيف التوتر بين الصين والولايات المتحدة في القضايا التجارية كما حصل مؤخرا في ملف منصّة “تيكتوك” التي كان ترمب يريد تقويضها أو السيطرة عليها. ويمكن في هذا السياق ادراج الحرب التكنولوجية القائمة بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلّق بالرقائق (chips) وشبه المواصلات (semiconductors) نتج عن ذلك الاكتفاء الذاتي الصيني وقطع التبعية للولايات المتحدة في ذلك القطاع. آخر المعلومات تفيد أن شركة نيفيديا (Nvidia) التي كانت تورّد الرقائق المتدنية المستوى الى الصين للحفاظ على السوق الصين لمصلحة الولايات المتحدة أصبحت تواجه صناعة صينية في الرقائق من المستوى العالي ما يجعل الخروج الاميركي من السوق الصينية أمرا مفروغا منه.
الانجازات الاقتصادية الضخمة في الصين ومشاريعها الطموحة في آسيا وسائر مناطق العالم تتطلّب حماية عسكرية. فالصعود العسكري الذي كشفه العرض العسكري والمواجهة بين باكستان والهند دليل على أن الصين انتقلت من قوّة اقتصادية عالمية عظمى إلى قوّة سياسية تدعمها القدرات العسكرية المتطوّرة. هذا يعني أن أي تفكير في الغرب في امكانية اخضاع الصين أصبحت أضغاث احلام ناتجة عن الحقبة الاستعمارية في القرنين الماضيين. والاستثمار العسكري انعكس في نشأة وتطوّر مؤسسات إقليمية ودولية تقارب الاقتصاد كما تقارب الملفّات الامنية. فالصين ومعها روسيا تعتبر أن الامن لا يتجزّاء وان جميع الدول يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار هواجسها الامنية. فلا إمكانية لترتيب أمني على حساب أمن الاخرين. وهذه هي قاعدة العلاقات الدولية المرتقبة بدلا عن املاءات الدول الغربية التي تعتبر امنها فوق أي اعتبار وإن كان على حساب الدول الاخرى.
2-روسيا
روسيا متعافية سياسيا واقتصاديا. فمنتديات سان بترسبورغ وفلاديفوستوك الاقتصادية تدلّ على مشاركة كثيفة من دول الجنوب الاجمالي وخاصة من إفريقيا ما يشير أن محاولات عزل روسيا من قبل دول الغرب الاجمالي فشلت فشلا ذريعا. ومن سخريات الدهر ان الدول الاوروبية التي قطعت علاقاتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلّق بالطافة (غاز ونفط) ما زالت تشتري النفط الروسي عبر الهند ورغم التهديدات بالعقوبات الاميركية. اما على صعيد النمو الاقتصادي فروسيا سجّلت نسبة نمو مرتفعة بأكثر من 3 بالمائة لسنة 2024-2025 بينما الدول الاوروبية الغربية المقاطعة سجّلت معدّلات منخفضة جدا (حوالي نصف بالمائة) إن لم تكن سلبية كما هو الحال في المانيا. في هذا السياق تفيد المؤشرات الاقتصادية أن حجم الاقتصاد الروسي اصبح رابع اقتصاد في العالم من حيث الناتج الداخلي بالقوّة الشرائية وبقيمة 6،45 تريليون دولار. في المرتبة الاولى هناك الصين بناتج داخلي بقيمة 34،4 تريليون دولار تليها الولايات المتحدة بقيمة 27،3 تريليون دولار ومن بعدها الهند بناتج قومي بقيمة 14،5 تريليون دولار. نلاحظ هنا وجود ثلاث دول من منظومة البريكس في طليعة الناتج القومي المقاس بالقوّة الشرائية.
المانيا تشكّل مع المملكة المتحدة رأس الحربة في العداء لروسيا وتدعو إلى تشكيل قوّة عسكرية لمواجهة روسيا عسكريا في 2030. روسيا لا تكترث كثيرا لتلك التصريحات التي تتناقض مع الامكانيات العسكرية الحالية والمحتملة للدول الاوروبية في وضع اقتصادي واجتماعي مضطرب. والتحريض الاوروبي على روسيا عبر اوكرانيا جعل القيادة الروسية تهدّد مباشرة كل من المانيا والمملكة المتحدة وفرنسا بإنها لن تكون بمنأى عن أي ضربة روسية. ومن الواضح ان الدول الاوروبية في نفس الوضع كالكيان الصهيوني أن مواجهة عسكرية كبرى مع روسيا أو أيران لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة الولايات المتحدة.
القمة التي جمعت كل من الرئيس الاميركي والروسي في الاسكا اقنعت القيادة الروسية أن حرّية المناورة للرئيس الاميركي محدودة ومكبّلة باعتبارات داخلية وإن كانت رغبته الحقيقية التفاهم مع روسيا. وبالتالي ليس هناك من اي تصوّر أنه بالامكان الوصول إلى أي تفاهم حتى في القضايا المشتركة كمحادثات الحدّ من السلاح الاستراتيجي أو التعاون الاقتصادي. والتقلّبات في التصريحات اليومية للرئيس الاميركي تجاه روسيا تعكس ذلك التقييم الروسي حيث وصلت القناعة انه لا داعي للرهان على تغيير ملموس في القضايا الاساسية التي تهم روسيا كهندسة الامن في اوروبا التي تشكّل حجر الزاوية للتحرّك العسكري الروسي في اوكرانيا. رغم كل ذلك نرى استمرار المحاولات لكسب الولايات المتحدة على قاعدة المشتركات بين روسيا والولايات المتحدة التي تختلف في جوهرها مع تركيبة البنية الاوروبية. نشير هنا إلى مقالات وتصريحات ديميتري كيريلف المسؤول عن محفظة الاستثمارات الروسية وصناديقها السياسية لاقناع أن نقاط التشابه بين روسيا والولايات المتحدة أكثر مما هي مع اوروبا. فالاقتصادان اقتصادان قاريان، يمتلكان موارد كثيرة، وصناعات متشابهة مع يجعل إمكانيات التفاهم اكبر من مع اوروبا. من جهة اخرى أرسلت القيادة الروسية رسالات حول استعدادها لتمديد اتفاقيات ضبط التسليح النووي التي تنتهي في 2026 كبادرة حسن نية. السؤال هل تلتقتها القيادة الاميركية وخاصة ذلك الجناح في إدارة ترمب الذي يريد الخروج من المستنقع الاوكراني والاوروبي كنائب الرئيس جي دي فانس ومن يمثله في القاعدة الشعبية “ماغا”؟ هذا ما يجب متابعته في الفترة المقبلة.
أما على الصعيد العسكري فتتقدّم القوّات الروسية على قدم وساق في اوكرانيا والدفاعات الاوكرانية تنهار الواحدة تلو الاخرى ما يعني أن الحلّ العسكري هو الوحيد وأن الاستسلام الكامل الاوكراني هو المخرج لوقف العمليات العسكرية في اوكرانيا. التوقّعات تشير إلى أن النهاية قد تكون في آخر الخريف 2025 وفي أسواء الاحوال في ربيع 2026 دون ان تسطيع دول حلف الناتو ان تغيّر أي شيء. لكن بالمقابل، فإن نهاية العمليات العسكرية في اوكرانيا وإن كانت لصالح روسيا بشكل مطلق فإن استمرار المواجهة مع الحلف الاطلسي واقع مؤكّد رغم عدم وجود قدرات عسكرية للحلف للقيام بأي مشروع عسكري في مواجهة روسيا. هذا يعني أن اي معركة عسكرية مع روسيا بالسلاح التقليدي ستنتهي بهزيمة مبينة للحلف الاطلسي وأن امكانية التعديل تكمن فقط في اللجوء إلى السلاح غير التقليدي. الحماقة التي تتسم بها قيادات الغرب وخاصة في منظومة الناتو تجعل من ذلك الاحتمال ممكنا وروسيا تتعامل مع هذه الوقائع وتأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات. لذلك عزّزت روسيا علاقاتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع كل من الصين وكوريا الشمالية والجمهورية الاسلامية في إيران ما يجعل أي اعتداء على روسيا من أي طرف غربي امرا له عواقب وخيمة على المعتدي. في هذا السياق يجب ايضا اعتبار روسيا البيضاء (بلاروسيا) جزء لا يتجزّاء من القدرات العسكرية الروسية حاليا ومستقبليا كما جاء على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رهانات الدول الغربية على معارضة روسية داخلية للرئيس الروسي تبخّرت مع سلسلة العقوبات التي فرضتها على روسيا منذ 2022. لم تأخذ تلك الدول في الحسبان الشعور الوطني المتجذّر في روسيا ودور الكنيسة الارثودوكسية التي تمّ استهادفها في اوكرانيا. الوضع الداخلي في روسيا مستقر خاصة بعد فشل العقوبات وتمكّن الحكومة الروسية من تأمين معدّلات نمو واستقرار نسبي للقوّة الشرائية. سوء التقدير المستمرّ الغربي للقدرات الروسية ادّى إلى فشل كافة المحاولات لتقويض روسيا ناهيك عن نوعية قيادية روسية مميّزة في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري ورداءة القيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية في دول الغرب. فهذه عناصر مكوّنة لموازين القوّة تمّ شرحها في تقرير سابق للمؤتمر القومي العربي.
ومن تداعيات المواجهة في اوكرانيا اختبار السلاح الروسي الجديد والكاسر للتوازنات كما أن الخبرة المكتسبة على كافة المستويات تقابلها عدم كفاءة في صفوف الحلف الاطلسي ناهيك أن التسليح وقدرة انتاج السلاح محدودة للغاية. ففي المعادلة العسكرية الاستراتيجية تتفوّق روسيا على الولايات المتحدة وسائر مكوّنات الحلف الاطلسي في الطاقة الانتاجية في نوعية السلاح الجديد المتمتّع بالتكنولوجيات الحديثة وبكلفة محدودة نسبيا غير موجودة في البنية الانتاجية الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية.
فعلى سبيل المثال، شركة بورش الالمانية المعروفة بإنتاج السيارات الفخمة وجدت نفسها مضطرة إلى بناء الدبابات إلاّ أن تلك العملية تستوجب وجود صناعة للصلب في المانية. غير أن هذه الصناعة توقّفت بسبب انقطاع الطاقة الغازية الاتية من روسيا. الدولة الوحيدة في دول حلف الناتو التي تنتج الصلب هي السويد ما يعني أن الدول الاوروبية التي تريد بناء مصانع للانتاج العسكري ستتنافس على الكمّيات المحدودة التي تنتجها السويد ما سيؤدّي إلى ارتفاع سعر الصلب وبالتالي كلفة الانتاج العسكري. هذا يعني ان قدرة الاطلسي على المواجهة العسكرية مع روسيا أقرب لأن تكون أضغاث احلام وليس من الواقع الممكن خاصة في الظروف القائمة في الدول الغربية فيما يتعلّق بالبنى السياسية والاقتصادية.
رغم كل ذلك تمضي روسيا في مشاريعها التي تحصّن بنيتها الاقتصادية واستقلالها في مشاريع استراتيجية كطريق القطب الشمالي الذي سيختصر نقل البضائع من شرق آسيا لاوروبا لبضعة ايام فقط بدلا من المرور بقناة السويس الذي يأخذ 15 يوم. فكلفة النقل تنخفض بشكل ملموس كما أن الانكشاف نحو الممرّات البحرية يتراجع. فالتركيز على النقل البرّي وعبر القطب الشمالي يعزّز مكانة المكانة الجغرافية السياسية للكتلة الاوراسية التي تحاول الغربية محاصرتها بشكل مستمر عبر السيطرة على الممرّات البحرية. اما المشروع الاخر فهو خط الانبوب الثاني للغاز عبر سيبيرا ما يعزّز التكامل الاقتصادي مع الصين. ولا بد من الاشارة إلى استضافة الفعّاليات الاقتصادية الدولية لخاصة لدول الجنوب الاجمالي لتكريس الدور الاقتصادي والسياسي لروسيا على الصعيد العالمي. فالمنتديان الاقتصاديان الدوليان في سان بترسبرغ وفلاديفوستوك في شرق روسيا منصتان لذلك التشبيك الاقتصادي والسياسي. كل هذه التحوّلات يمكن الاطلاع على حيثياتها في منشورات منتدى فالدي الذي ينافس منتدى دافوس الاقتصادي ولكن من منظور مصلحة الشعوب وليس من منظور الشركات العالمية والدول الغربية التي تروّج للمشاريع النيوليبرالية التي وصلت إلى طريق مسدود في الغرب ومن يتبع ذلك النهج الاقتصادي.
3-الهند
الهند شبه قارة أكثر مما هي دولة وطنية متماسكة داخليا. فالتعداد السكّاني فيها مليار وخمس مائة الف تجاوز التعداد السكّاني الصيني فأصبحت أكبر دولة سكّانيا في العالم. إلا أن التجانس بين السكّان امر غير متوفر لتعدّد اللغات والثقافات. فهناك ثقافات متعدّدة متنافسة كالثقافة الهندوسية في الشمال والثقافة البنغالية في الشرق والثقافة التاميلية الدراودية في الجنوب والتقافة الاسلامية في الغرب. أما عدد اللغات الرسمية في الهند فهو 22 إلأ أنه ليس هناك من لغة وطنية واحدة للهند. والتعدّد الثقافي واللغوي يؤسّس لصراعات “قومية” ودينية خاصة بين الاكثرية الهندوسية والاقلّية المسلمة التي تشكّل ثالث أكبر تكتّل بشري مسلم في العالم بعد اندونيسيا (249 مليون) وباكستان (247 مليون) حيث بلغ عددها حوالي 214 مليون أي ما يوازي 14 بالمائة من اجمالي سكّان الهند. بالمناسبة، فإن عدد المسلمين في العالم في ايلول/سبتمبر 2025 بلغ 2،16 مليار!
تاريخيا، كانت الهند من اعمدة مجموعة دول عدم الانحياز في حقبة الحرب الباردة. وكانت الهند متعاطفة مع القضية الفلسطينية ولم تقم أي علاقة مع الكيان المؤقّت حتى قامت اتفاقية اوسلو. فاقنعت عند ذلك الحين السلطة الفلسطينية القيادة الهندية بالاعتراف باتفاقية اوسلو وبالتالي بالكيان. مع صعود الحركة القومية الهندوسية التي لم تخف عداءها للعرب والمسلمين تطوّرت العلاقات مع الكيان المؤقت حيث اصبح حزب جناتا من أهم واقرب الحلفاء لبنيامين نتنياهو. ليس هدف التقرير مقاربة العلاقات الهندية العربية أو الهندية الفلسطينية بل تحديد موقع الهند من التحوّلات الجيوسياسية القائمة في العالم وخاصة في حقبة التراجع الاميركي على كافة الاصعدة. فالهند على مفترق طرق فيما يتعلّق بالخيارات الاستراتيجية للتحالفات التي يمكن أو يجب أن تعتمدها. فحتى فترة قريبة حاولت الهند الحفاظ على توازن في العلاقات بين روسيا التي تربطها علاقات تاريخية منذ حصول الهند على استقلالها في اواخر الاربعينات من القرن الماضي وخلال حقبة حكم حزب المؤتمر، ومع الولايات المتحدة التي تربطها علاقات منذ وصول حزب جاناتا للحكم في العقد الثاني من الالفية الثالثة.
المتغيّر الاساسي والذي سيؤثّر في مقاربة الحكومة الهندية للخيارات في التحالفات السياسية الخارجية هو موقف ادارة ترمب من الهند. فالادارة الاميركية تتعامل مع الدول كتابعين لها وليس كدول لها سيادتها وكرامتها. الهند دولة عظمى صاعدة بحجمها الجغرافي والسكّاني والاقتصادي رغم التصدّعات الداخلية التي تهدّد التماسك الوطني. والهند رائدة في القطاع التكنولوجي وخاصة في المعلوماتية. ليست صدفة ان يكون رؤوساء الشركات التكنولوجية العملاقة في الولايات المتحدة منحدرين من اصول هندية. والهجرة الماهرة الهندية إلى الولايات المتحدة اصبحت “مشكلة” لدى إدارة ترمب التي تعتبر الهند “تسرق” الوظائف العالية. إضافة لكل ذلك فالهند لا تتماهى مع كافة الخيارات الاميركية فيما يتعلّق بالمواجهة مع روسيا. العلاقة الحميمة بين الهند وروسيا شكّلت نقطة احتكاك مع الادارة الاميركية التي كانت تراهن على انخراط الهند في المجموعة الرباعية لمحاصرة الصين وإذ تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات على البضائع الهندية وتهدّد بفرض تعريفات إضافية بمستوى 50 بالمائة أذا ما استمرّت في شراء النفط الروسي وبيعه فيما بعد للدول الاوروبية. فهذه منافسة للشركات الاميركية كما هي خروقات للحصار على روسيا.
نتيجة للضغوط الاميركية وخاصة فيما يتعلق بفرض تعريفات بمستوى 50 بالمائة على البضائع الصينية فإن الصين وجدت من مصلحتها التقارب مع الصين وتشديد وثاق العلاقات مع مجموعة البريكس. فالتقارب بين الهند والصين الذي حصل على هامش اجتماعات منظومة شنغهاي قلبت المعادلات الاميركية حول إمكانية محاصرة الصين ضمن المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، الهند، اليبان، واستراليا). لكن هذا التحوّل يواجه معارضة داخلية لا تريد الابتعاد عن الولايات المتحدة إلاّ أن سلوك الادارة الاميركية لا يعطيها المجال. فقرار الادارة برفع الاعفاء عن التعامل مع الجمهورية الاسلامية في إيران يضرب بشكل مباشر المصالح المالية والاقتصادية والسياسية للهند التي منحتها الجمهورية الاسلامية في أيران في استثمار مرفأ شابهار على بعد 150 كيلومتر من مرفأ غوادار الباكستاني التي تديره الصين. القرار الاميركي يقوّض قدرات الصين في التأثير على النفوذ الصيني في وسط أسيا وخاصة في افغانستان ويهدف إلى منع صعود الهند إلى مستوى دولة عظمى في الاقليم. الولايات المتحدة لا تريد أي منافس لها في العالم وبالتالي لا تعطي أي اهمية لتطلّعات الدول التي تحاول جذبها إلى جانبها. المهم هنا هو أن الهند على مفترق طرق في الخيارات الاستراتيجية وخاصة في الانخراط إلى جانب الكتلة الاوراسية ومجموعة البريكس التي هي من مؤسسيها في 2013.
ملف آخر يساهم في توتير العلاقات مع الولايات المتحدة هو ضغط القاعدة الشعبية الجمهورية الاميركية (ماغا) على الحدّ من الهجرة الهندية إلى الولايات المتحدة التي تنافس الاميركيين في الوظائف وخاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة. وأخيرا، لا يمكن تقليل تداعيات المواجهة العسكرية مع باكستان التي كشفت عورات السلاح الغربي وخاصة طائرات “رفال” الفرنسية في مواجهة الطائرات الباكستانية الصينية الصنع. هناك تفكير في مراجعة مصادر التسليح الهندي في الابتعاد عن المصادر الغربية بما فيها الاميركية.
4-باكستان
استطاعت باكستان في الاونة الاخيرة ان تصبح لاعبا اساسيا في المعادلة الاقليمية. وهذا الدور بدأ عندما رفضت باكستان الانخراط في العدوان على اليمن في منتصف العقد الماضي بل شرّعت قانونا يمنع التدخل الخارجي الذي قد يمسّ بالامن القومي الباكستاني. حتى بعد الانقلاب الداخلي على رئيس وزراء الباكستان عمران خان كانت السياسة الباكستانية حريصة على التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين. إلاّ أن التقارب الاخير والمعلن مع الجمهورية الاسلامية في إيران وطموح البكاستان في الالتحاق بمنظومة البريكس بعد دخولها منظمة شنغهاي يرسم التوجّهات الاستراتيجية لباكستان. فباكستان تستفيد من مبادرة الحزام الواحد كما أنها جزء من الممرّ الشمالي الجنوبي الذي يربط روسيا وافغانستان بالمحيط الهندي.
المواجهة الاخيرة التي حصلت مع الهند اظهرت أهمية وتفوّق السلاح الصيني بحوزة باكستان على السلاح الغربي بحوزة الهند. كما أن الدور الذي لعبته الباكستان في تزويد السلاح الصيني المرسل إلى الجمهورية الاسلامية في إيران والتصريح بأن أي اعتداء على أيران ستقف الباكستان إلى جانب الجموهرية الاسلامية من دلالات تؤكّد أن رغم العلاقات المميّزة مع الولايات المتحدة فإن الباكستان تمارس استقلالية تخدم مصالحها الاستراتيجية في الاقليم. وفي هذا السياق يأتي الاعلان عن اتفاق الدفاع المشترك بين الباكستان وبلاد الحرمين على اعقاب القمة العربية الاسلامية التي عُقدت في الدوحة ليؤكّد أن ذلك الاتفاق تمّت المفاوضات عليه قبل انعقاد القمة ما يعني أنه أتى في سياق مراجعة جذرية لامن الاقليم الذي كان بيد الولايات المتحدة. فأمن الاقليم أصبح بيد الدول الوازنة كباكستان والجمهورية الاسلامية في إيران وبلاد الحرمين. هذا يعني أن المراهنة والاستثمار في الفتنة السنّية الشيعية التي افتعلتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكيان الصهيوني المؤقت أصبحت مراهنة غير ذي جدوى.
6-الجمهورية الاسلامية في ايران
اصبحت الجمهورية الاسلامية في إيران لاعبا أساسيا في المعادلات الاقليمية والدولية. فرغم الحصار المفروض عليها منذ نجاح الثورة الاسلامية في 1979 ورغم العقوبات التي يفرضها الغرب وخاصة الولايات المتحدة حتى الساعة فإن الجمهورية الاسلامية لم تصمد فحسب بل حصّنت وضعها الداخلي والاقليمي والدولي بسبب حماقات السياسة الغربية وخاصة الاميركية. فبعد ان استطاع الغرب أن يقنع النظام العربي الرسمي أن العدو الاساسي له هو الجمهورية الاسلامية وليس الكيان الصهيوني المؤقّت مع تعزيز الفتنة السنية الشيعية التي بدأت مع احتلال الولايات المتحدة للعراق في 2003 فإن التحوّلات في الاقليم ساهمت في قلب السردية وقلب المفاهيم. وأهم هذه التحوّلات هي طوفان الاقصى الذي كشف زيف الادعاءات الصهيونية والغربية والاميركية حول الكيان ومنظومة القيم التي حاولوا فرضها على المنطقة عبر الاتفاقات الابراهيمية وموجة التطبيع مع الكيان كحلّ لكافة القضايا في الإقليم.
منذ عملية “طوفان الاقصى” تعرّضت الجمهورية الاسلامية في إيران إلى هجوم مزدوج صهيوني وأميركي بحجة الملف النووي. ليس هذا التقرير في صدد شرح ملابسات الملف النووي من المنظور الغربي والصهيوني بل التأكيد أنه حجة واهية تخفي الهدف الاساسي للهجوم والحصار والعقوبات ألا وهو أجراء تغيير في النظام وربما العودة إلى حكم الشاه بعد تنصيب ابن الشاه المخلوع او المجيء بنظام اكثر اعتدالا وتقاربا مع الولايات المتحدة. الهدف من قلب النظام هو كسر العمود الفقري (او رأس الافعى كما تزعم القيادة الصهيونية والاميركية) الذي يدعم المقاومة للاحتلال الصهيوني لفلسطين وللهيمنة الاميركية على غرب آسيا. كما أن استهداف النظام القائم في إيران هو خطوة ضرورية للاسيتلاء على الثروات النفطية والغازية التي تتمتع بها وتفتيت الجغرافيا الايرانية إلى كيانات يحكمها كونسورسيوم أميركي صهيوني وذلك تمهيدا لمحاصرة كل من روسيا والصين وأحباط مشروع الحزام الواحد وكسر منظمة شنغهاي ومنظومة البريكس.
فبعد اغيتال الرئيس الايراني رئيسي عند عودته من زيارة لازربادجيان ومن بعد ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد لإيران الدكتور مسعود بزشكيان عاد الكيان الصهيوني لاستهداف كافة قادة الجمهورية الاسلامية في إيران من عسكريين وسياسيين وعلماء وخاصة قائد الثورة الامام خامنئاي. وكان الهدف من الهجوم ان تعمّ الفوضى وتهبّ المعارضة الداخلية للنظام القائم في إيران لقلب النظام. إلا أن فشل الهجوم أدّى إلى نتيجة عكسية عبر رفض المعارضة الوطنية تلبية رغبات الحلف الصهيواميركي، بل حتى التفّت حول النظام في مواجهة العدوان على الجمهورية الاسلامية. وطنية المعارضة لم تكن في حسبان الحلف الصهيواميركي لتغيير النظام في إيران. اما الرد الايراني على العدوان الصهيوني فكان دقيقا وكثيفا وقاسيا للغاية ما اجبر حكومة العدو الاستنجاد بالولايات المتحدة لوقف اطلاق النار. كما أن الرد الايراني على الغارة الاميركية التي استهدفت المفاعلات النووية في قصف القيادة المركزية الوسطي للولايات المتحدة في قاعدة الحديد في قطر والاصابة المباشرة والدقيقة لها دليل على القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية في ايران.
الملف النووي الايراني هو الحجة الاميركية والغربية وبطبيعة الحال الحجة الصهيونية لاستهداف الجمهورية الاسلامية في أيران. ومن جراء العدوان الصهوني على الجمهورية واستهداف العلماء النوويين بات واضحا أن الدور الاستخباراتي التي لعبته رئاسة الوكالة الدولية للطاقة النووية في تزويد الكيان بالمعلومات عن العلماء كشف عمق المؤامرة على الجمهورية الاسلامية. كان الرد الايراني تعليق التعاون مع الوكالة وإذ جاءت الوساطة المصرية لإجراء مفاوضات بين ايران والوكالة والوصول إلى شبه اتفاق لتشكّل انجازا دبلوماسيا كبيرا لإيران ساهم في تعرية الموقف الغربي وخاصة الاوروبي تجاه ايران. فدعوة فرنسا والمملكة المتحدة والمانية لتفعيل العقوبات على ايران بحجة عدم التعاون مع الوكالة الدولية سقطت دبلوماسيا مع الاتفاق الذي حصل في مصر. لكن اصرار الدول الاوروبية على تفعيل العقوبات واصدار القرار في مجلس الامن باكثرية غير خاضعة لحق النقض ادّى أن كل من روسيا والصين رفض القرار وعدم الالتزام به بل أيضا إلى الطعن في شرعية قرار الاممي. هذا يعني أن الخطوة التي اقدمت عليها ايران للتفاهم مع الوكالة وبرعاية مصرية أدى ألى نصر دبلوماسي الغى مفاعيل العقوبات الاممية. كما ان انخراط ايران في الكتلة الاوراسية والمشاركة في مبادرة الحزام الواحد والعضوية في منظمة شنغهاي ومنظومة البريكس إضافة للتحالفات والتفاهمات الاستراتيجية مع كل من روسيا والصين ساهم قي تعزيز عدم فعّالية العقوبات الاممية ونقض محاولة عزل ايران واضعافها. الرفض المزدوج الروسي والصيني لقرار مجلس الامن يفتح المجال للتدخل العسكري الروسي وأو الصيني إلى جانب الجمهورية الاسلامية في حال تكرار عدوان جديد عليها. وهذا التدخل يشكل قاعدة لعودة روسيا ومعها الصين إلى منطقة غربي آسيا وكابوسا للولايات المتحدة والدول الغربية. فهذا يؤكّد الدور المفصلي للجمهورية الاسلامية في ايران في التحوّلات الجيوسياسية الحاصلة في القارة الاسيوية.
الاهمية الاقليمية والدولية للجمهورية الاسلامية في إيران تكمن في قدرتها على نسج علاقات استراتيجية مع كل من روسيا في مطلع 2025 ومع الصين. إضافة الى ذلك استمرار وتطوير التقارب مع بلاد الحرمين ومصر يؤكّد خروج الجمهورية الاسلامية من العزلة العربية التي طالت عقودا من الزمن وخاصة منذ نجاح الثورة الاسلامية في تغيير النظام في إيران. العلاقات الاستراتيجية التي وُقّعت مع روسيا في مطلع 2025 لا تقتصر على العلاقات الاقتصادية والتعاون التكنولوجي بل تلاها فيما بعد مساعدات عسكرية روسية بعد العدوان الصهيواميركي على ايران في حزيران/يونيو 2025. الجدير بالذكر هو أن روسيا عرضت في مفاوضتها قبل توقيع الاتفاق مشروعا لدفاع مشترك لكن ايران رفضت لان القيادة الايرانية كانت تعتقد أن هذا الاتفاق سيزيد من استفزاز دول الغرب. لكن بعد العدوان الصهيواميركي زال التحفّظ الايراني لقبول العرض الروسي. كما ان تزويد الصين بسلاح نوعي للجمهورية الاسلامية في إيران عبر الممر الباكستاني يجعل إيران جاهزة لحماية المبادرة الصينية في الحزام الواحد كما يجعلها جاهزة لمواجهة أي عدوان صهيواميركي عليها. وفي هذا السياق تشير التقارير الامنية والاستخباراتية في الغرب أن أيران استطاعت ان تستهدف البنية العسكرية والامنية والاقتصادية للكيان المؤقت في ردّها على العدوان الصهيوني عليها. كما تؤكّد تلك التقارير تدمير ثلث تل ابيي من جراّء الصواريخ الفارقة للصوق والدقيقة التي تملكها. لذلك سارع الكيان الاستنجاد بالولايات المتحدة لطلب وقف النار.
الموقع الجغرافي لإيران عنصر أساسي في المشروع الاوراسي في انشاء ممرّات برّية من شمال آسيا حتى المحيط الهندي. هذا الممر الدولى من الشمال إلى الجنوب يتكامل مع الممرّ الذي يربط شرق آسيا بالبحر المتوسط وايران في وسط تلك الممرّات. ودخول إيران في عضوية البريكس وقبل ذلك في منظمّة شنغهاي يجعلها لاعبا أساسيا في إعادة هيكلة البنية السياسية والاقتصادية في آسيا وصولا إلى شرق بحر المتوسّط. في هذا السياق لا بد من الاشارة إلى تدشين في 25 أيار/مايو 2025 خط سكّة الحديد طوله 8،400 كيلومتر الذي يربط مدينة زي يان في شمال غرب الصين مع المرفأ الجاف آبرين على بعد 25 من جنوب غرب طهران. كما سبق ذلك إعادة تنشيط سنة 2022 سكّة الحديد التي تربط كل من تركيا بباكستان وطولها 5،981 كيلومتر بعد أن توقّفت لأسباب سياسية لمدة 10 سنوات. وهذه السكّة تخفّض مدّة النقل من تركيا إلى باكستان من 35 يوم إلى 13 يوم فقط. إضافة إلى كل ذلك فإن خطّا جديدا لسكة حديد تربط إيران بباكستان وتركمنستان وكازكستان بمدينة اولياكوف في روسيا سيمكّن إيران تصدير النفط بعيدا عن الانظار والمراقبة الاميركية. سيصبح ذلك الخط عاملا سنة 2026.
7-تركيا وازربادجيان
ليث:
وهذه السكّة تخفّض مدّة النقل من تركيا إلى باكستان من 35 يوم إلى 13 يوم فقط. إضافة إلى كل ذلك فإن خطّا جديدا لسكة حديد تربط إيران بباكستان وتركمنستان وكازكستان بمدينة اولياكوف في روسيا سيمكّن إيران تصدير النفط بعيدا عن الانظار والمراقبة الاميركية. سيصبح ذلك الخط عاملا سنة 2026.
7-تركيا وازربادجيان
لعبت الدولتان ادوارا كبيرة في التحوّلات الجيوسيية في كل من شرق اوروبا وغرب آسيا. فكلاهما زوّدا اوكرانيا بعتاد وكلاهما ساهما في تمكين الكيان الصهيوني في استمراره في الابادة في غزّة عبر تغذية الكيان المؤقّت بالنفط من ازربادجيان مرورا بتركيا. كما أن ازربدجيان كانت مسرحا لاغتيال الرئيس الايراني رئيس بسبب تواجد قواعد استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني المؤقت. لكن مساهمة ازربادجيان في الحرب الاوكرانية كانت لها كلفة خاصة بالرئيس الازري علاييف الذي يملك وعائلته مرافق اقتصادية في اوكرانيا. وهذه المرافق لم تستهدفها روسيا في المراحل السابقة في عمليتها العسكرية الخاصة إلاّ أن في الاونة الاخيرة استهدفتها ودمرّتها. اليوم ازربدجيان على مفترق طرق. فإما ان تنخرط كليّا في الكتلة الاوراسية وتبتعد عن الولايات المتحدة وإما استقرارها الداخلي مهدّد بفعل الدور الروسي والايراني. فلا روسيا ولا ايران تتحمّلان الخطر الاتي من اذربادجيان.
اما تركيا، فإضافة الى دورها التدميري في سورية حاولت أن تتوازن بين مقتضيات مصالحها الاقتصادية مع روسيا والجمهورية الاسلامية في أيران ورغبات رئيسها في كسب ود إدارة ترمب. تركيا أيضا على مفترق طرق فيما يتعلّق بخياراتها السياسية. فإما تكون صادقة وملتزمة بعلاقاتها مع كل من روسيا وايران وأما أن تنخرط كلّيا مع الولايات المتحدة والغرب والكيان المؤقت. وهناك سجال حقيقي وعميق في المشهد السياسي التركي حيث أطلق في شهر ايلول/سبتمبر 2025 زعيم الحزب القومي التركي دفلت بهجلي فكرة الخروج من التحالف مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والالتحاق بمجموعة البريكس كحلّ وحيد لاستقرار ونمو تركيا. الملفت للنظر أن الرئيس التركي لم يعارض تلك الفكرة ما يعني أن تركيا قد تكون على ابواب دخول مرحلة جديدة في علاقاتها الخارجية وانعكساتها على التوازنات الاقليمية قد تكون في غاية الاهمية.
فالوضع الداخلي في تركيا يغلي حيث الشعب التركي غير راض عن مواقف حكومته فيما يتعلق بالابادة في غزة أضافة الى القضايا الاقتصادية المزمنة. فالكلام اللفظي الذي يطلقه اردوغان والمسؤولون تنديدا بالكيان لا يقترن بافعال يعكس الازدواجية والنفاق القائم. أما في سورية، فقامت تركيا بمغامرة غير محسوبة النتائج في أيصال جماعات الغلو والتوحّش والتعصّب إلى السلطة وتغيير النظام القائم آملة بان تسيطر على سورية. غير أن هذه المقامرة اصطدمت بالواقع الصهيوني والاميركي الذي لن يسمح لتركيا التحكّم بسورية. واستهداف مرفق الدولة بما فيها وزارة الدفاع ومقرّ الرئاسة في سورية من قبل قوّات العدو الصهيوني رسالة واضحة أن دور تركيا في مستقبل سورية محدود إن لم يكن هامشيا ومقتصرا على المناطق الحدودية في شمال سورية. والسؤال هو كيف ستتعامل تركيا مع هذا الواقع؟ فإذا رضخت للمشيئة الصهيونية والاميركية فدور تركيا الاقليمي واحلام اردوغان في إعادة المجد للعثمانية يتبخّر وسيواجه مسائلة داخلية حول الخيارات العبثية التي اتخذها منها عدم مواجهة الكيان في فلسطين وسورية. كما أن قدرته على المناورة مع كل من روسيا وايران ستتعثّر. فالرضوخ للموقف الصهيوني قد ينهي حقبة حكم حزب العدالة والتنمية الذي يشكو منذ الان تراجعا كبيرا وأن زعامة اردوغان مهدّدة وطموحاته في تزعّم العالم الاسلامي ستتبخّر. والسؤال الثاني هل يستطيع ارودغان ان يكون صادقا في محاولات التفاهم مع الدول العربية بدءا بمصر وببلاد الحرمين؟ هذا ما يجت متابعته في المرحلة القادمة إن لم يحدث تحوّلا كبيرا وصادما في المشهد الداخلي التركي.
8-فنزويلا والبرازيل
أ-فنزويلا
تكتسب كل من فنزويلا والبرازيل مكانة خاصة في القارة الاميركية الجنوبية لما اطلقتا من مواقف تؤكّد سيادتها على قراراتها وثرواتها والتصدّي لمحاولات الهيمنة وتغيير النهج الوطني التي اتخذت منذ أكثر من عقد. في المرحلة الحالية قد تشهد الساحة الفنزويلة تحرّكات عسكرية وسياسية للولايات المتحدة ضمن استراتيجيتها العسكرية الجديدة التي تقضي بالانكفاء عن التورّط في حروب في العالم والتركيز على حماية حدودها من جهة ومصالحها في النصف الغربي للمعمورة وخاصة القارة الاميركية الجنوبية. ومدى اهتمام ادارة ترمب بالسيطرة على فنزويلا يعود إلى امتلاك فنزويلا أكبر احتياط نفطي في العالم وإن كان النفط الفنزويلي من النوع الثقيل الذي يستدعي عمليات تكرير معقّدة ما يجعل النفط في المشرق العربي وغرب آسيا اكثر جاذبية للعالم.
لكن السيطرة على النفط الفنزويلي يأتي في سياق نظرية الهيمنة (dominance) النفطية الاميركية التي تريد فرضها على العالم وخاصة على منافسيها كالصين.
محاولات الادارة الاميركية لتركيع القيادة الفنزويلية بل للاطاحة بها تُعتبر من المعارك الخلفية المتبقية للولايات المتحدة للحفاظ على معالم امبراطورية باتت في مهب الريح. إلاّ أن القيادة الفنزويلية نسجت علاقات استراتجية سياسية وعسكرية واقتصادية مع الدول الاساسية التى تتصدّي للهيمنة الاميركية كروسيا والصين والجمهورية الاسلامية في إيران، ولمحاولات الادارة الاميركية في القيام بأي عمل عسكري ضدها. وهذه المحاور تذكّرنا بمشروع احتلال بناما في اواخر الثمانينات من القرن الماضي في نهاية ولاية بوش الاب. والسؤال هو هل يتحمّل الرئيس الاميركي في سنة مفصلية في الانتخابات النصفية القادمة تحمّل تداعيات الخسائر البشرية في فنزويلا من مدنيين وعسكريين اميركيية من جراء أي عدوان؟ ونفس المنطق الذي يتحكّم بعدم الانخراط في حروب في غرب آسيا أو شرق اوروبا ينطبق على فنزويلا خاصة أن المناخ السياسي في القارة الاميركية الجنوبية لا يدعم ذلك التدخّل العسكري.
الاسباب الاخرى التي تدفع الادارات الاميركية المتتالية منذ وصول هوغو شافيز ومن بعده نيقولا مادورو إلى سدّة الرئاسة هو ما يمثّلان من نهج تحرّري اقتصادي واجتماعي ينقض النهج الذي تريد فرضه الولايات المتحدة. فوصول شخص منحدر من اصول السكّان الاصليين إلى الحكم بشخص شافيز شكّل تحوّلا جذريا في المشهد السياسي الفنزويلي انتقل أيضا إلى العديد من الدول في القارة الجنوبية. والمحاولات الانقلابية التي اعدتها الولايات المتحدة فشلت ودفعت القيادة البوليفارية الفنزويلة لنسج تحالفا مع روسيا والصين وايران. وتُقدّر حجم التدفقات المالية الصينية خلال العقد الماضي إلى أكثر من 62 مليار دولار معظمها كانت في قطاعات الطاقة. وحجم التجارة الخارجية الفنزويلية ازذاد مع الصين بنسبة 25 بالمائة خلال السنة الماضية معظمها من تصدير النفط بمستوى 880 الف برميل يوميا. والصين تملك حوالي 25 بالمائة من الدين الخارجي الفنزويلي ما يجعل مصلحتها المباشرة للحفاظ على الاستقرار في فنزويلا مصلحة استراتيجية.
هذه التدفّقات المالية تكسر الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا وبالتالي تزيد من غضب الاميركي ضد كل من فنزويلا والصين. كما أن الشركات الاميركية النفطية التي كانت تعمل في فنزويلا اضطرت للمغادرة بسبب العقوبات ما اتاح الفرصة للشركات النفطية الصينية الخاصة الاحلال مكانها. وأخر المعلومات تفيد أن في 2025 استثمرت الشركات النفطية الصينية في فنزويلا أكثر من مليار دولار رغم الحصار والعقوبات. لكن لا بد من الاشارة أن الاقتصاد الفنزويلي يعاني حاليا من ازمة حادة قد تهدّد الاستثمارات الصينية والروسية خاصة إذا ما نجحت المعارضة الفنزويلية في الوصول إلى الحكم بمساعدة الولايات المتحدة. فقد اعلنت المعارضة منذ الان أنها لن تسدّد القروض الروسية والصينية ما يعني أن كل من روسيا والصين ستخسر تلك الاستثمارات. وهناك ايضا تقارير استخباراتية عير مؤكّدة تفيد أن الولايات المتحدة والصين قد تصلان إلى تفاهام استراتيجي حيث تبدأ الولايات المتحدة الانسحاب التدريجي من أسيا وخاصة من شرق آسيا على أن تتخلّى الصين عن أميركا الجنوبية. وفي نفس السياق كان التفاهم الاميركي الصيني على ملف تيك توك حيث قبلت الصين “تأجير” منصّتها في الولايات الاميركية لشركة اوراكل التي يترأسها رالف اليسون احد كبار المموّلين الصهاينة في الولايات المتحدة. فهل هذا الاتفاق الذي يعني “خسارة” الصين للسوق الاميركي في وسائل التواصل الاجتماعي أن ميزان القوّة هو لصالح الولايات المتحدة؟ الخط البيان للامور يدل على عكس ذلك لذلك تصبح مصداقية التقارير عن صفقة صينية اميركية تنسحب أميركا من آسيا مقابل انسحاب الصين من أميركا اللاتينية أمرا غير دقيق. ليس هناك من أسباب موجبة لتحقيق هذه الصفقة ضمن موازين القوّة الحالية. فلا الولايات المتحدة تملك قدرات تستطيع إجبار الصين على الخروج من اميركا اللاتينية ولا الصين مضطرة للمقايضة بين آسيا واميركا اللاتينية. فقدرة الولايات المتحدة الحفاظ على ما تُسمّيه حديقتها الخلفية وإحياء نظرية مونرو التي اوجدت في القرن التاسع عشر ممكنة ضمن الموازين الحالية. فدول اميركا الجنوبية لم تعد طيّعة للقرار الاميركي ولا القدرات الاميركية تستطيع تقويض النزعات الاستقلالية في اميركا الجنوبية. فهل تلجأ الولايات المتحدة إلى قلب المعادلات في القارة الاميركية الجنوبية بالقوّة؟ هذا قد يكون فحوى الاستراتيجية العسكرية التي كشفها البنتاغون في مطلع شهر ايلول/سبتمبر 2025 في الانكفاء نحو الداخل الاميركي وحماية الحدود والحفاظ على الهيمنة في النصف الغربي للمعمورة.
هذا ما يجب متابعته في المرحلة القادمة إلاّ أن كافة المعطيات تشير إلى محدودية القدرات الاميركية التي يمكن أن تحشدها لتحقيق تلك الاهداف.
ب-البرازيل
أهمية البرازيل تكمن في حجمها الجغرافي ووزنها الاقتصادي ليس فقط في القارة الاميركية الجنوبية بل في العالم حيث تحتل المرتبة السابعة في الناتج الداخلي ب 4،45 تريليون دولار على قاعدة القوّة الشرائية. كما أن البرازيل عضو مؤسس لمجموعة البريكس حيث حرف الباء في مصطلح “بريكس” يعود إلى البرازيل. لكن هناك تساؤلات حول جدّية البرازيل بالالتحاق بقرارات البريكس لأن القيادة الحالية برئاسة سيلفا دا لولا تحاول التوازن في العلاقة بين الولايات المتحدة والمحور الروسي الصيني. وفي القمة الاخيرة لمؤتمر البريكس التي انعقدت في مدينة قازان في روسيا كانت هناك تساؤلات حول افشال مسيرة المجموعة عند ترؤس البرازيل للمجموعة في 2025. غير أن قرارات الادارة الاميركية في التدخّل المباشر في الشؤون الداخلية البرازيلية أضافة إلى سياسة التعريفات الجمركية دفعت الرئيس البرازيلي إلى المزيد من الالتحاق بمكوّنات البريكس كما دعا للتصدّى الجاد للقرارات الاميركية. لكن القلق ما زال قائما طالما كان حجم الانكشاف البرازيلي اقتصادي تجاه الخارج يشكّل مصدر ضعف. فالاستثمارات الخارجية المباشرة في البرازيل وصلت إلى 45 بالمائة من الناتج الداخلي البرازيلي. ومعظم الاستثمارات غربية وأميركية ما يعني أن إمكانية الضغط على البرازيل كبيرة. وهناك معارضة داخلية وازنة في البرازيل تقيّد قدرة حكومة لولا في المضي بعيدا في مواجهة الولايات المتحدة علما أنها غير راغبة في ذلك. أضافة إلى كل ذلك فهناك محاولات حثيثة لتقسيم البرازيل على اسس عرقية للسكّان الاصليين الذين ينتمون إلى قبائل وذلك لتسهّل استغلال ثروات البرازيل من قبل الاستعمار القديم. لذلك يمكن الاعتبار أن البرازيل قد تكون الخصرة الضعيفة في منظومة البريكس إضافة إلى الهند. فلعبة التوازنات مع الولايات المتحدة ما زالت متحكّمة في القرار السياسي وإن بدى واضحا مدى تراجع الولايات الولايات المتحدة في النفوذ. لكن قدرة الاذى المتوفرة لدى الولايات المتحدة ما زالت قوية ما يجعل التردّد في الخيارات الاستراتيجية لدول كالبرازيل والهند قائما.
9 -إفريقيا ودول الساحل الافريقي
ستكون القارة الإفريقية قارة تجاذبات بين المحور الصاعد التي تشكّله مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي وأجمالي دول الجنوب والمحور الغربي المتراجع المتمثل بالولايات المتحدة والدول التي كانت تستعمر القارة أي فرنسا والمملكة المتحدة. غير ان التحوّلات خلال السنتين الماضيتين في القارة اظهرت نزعة استقلالية لم تكن موجودة بعد نهاية الحرب الباردة وخاصة بعد الهيمنة الاميركية التي تلتها. استطاعت قيادات شابة من المؤسسة العسكرية في عدد من دول الساحل الإفريقي التحرّك لإنهاء النفوذ الفرنسي العسكري اولا تلاه النفوذ الاقتصادي والسياسي في سابقة ملحوظة لم تكن في الحسبان. فهذه الدول كانت تٌعتبر الحديقة الخلفية لفرنسا ونفوذها كان كبيرا على القرار السياسي والاقتصادي حيث استفادت فرنسا من بداية الستينات من القرن الماضي من ثروات هذه الدول. كما انها فرضت عليها منظومة نقدية جعلت فرنسا تيسطر على المقدرات النقدية والمالية لهذه الدول كما كانت تسيطر على التجارة الخارجية فيها. وهذه الدول المنتفضة ضد الاستعمار الفرنسي هي النيجر والمالي وبوركينا فاسو بشكل اساسي والتي تكتّلت في ما يُسمّى بتحالف الساحل، وتتبعها بوتيرة استقلالية اقل كل من السنغال وشاطئ العاج. المناخ الذي أوجده ذلك التحالف يعيد إلى الذاكرة مناخات بداية الستينات (موديبو كيتا في المالي واحمد سكو توري في غينيا وباتريس لموموبا في الكونغو) عندما حصلت هذه الدول على استقلالها (النظري) من المستعمر الفرنسي. المرحلة الحالية قد تكون بداية الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي لهذه الدول على الاقل هذا ما جاء على لسان النقيب ابراهيم تراوري
وقد قامت روسيا بدعوة زعماء الإفريقية إلى منتدى سان بترسبورغ الاقتصادي في 2024 حيث تمّت معاملتهم بالندية والاحترام. بالمقابل استدعى الرئيس الاميركي عددا من رؤوساء الدول الإفريقية إلى البيت الابيض وتمّ التعامل معهم بقلة احترام. هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تستطيع ملء الفراغ بعد الخروج الفرنسي من غرب إفريقيا وأن روسيا والصين ستملئان الفراع وستساعدان الدول الافريقية على استكمال سيادتها ومشاريعها التنموية والانمائية. ويجب ملاحظة حجم الاستثمارات الصينية التي تجاوزت 225 مليار دولار حتى 2023 في القارة الافريقية وفي العديد من القطاعات والاعمار والمناجم والطاقة يضاف إليها التنسيق والمساعدات العسكرية.
فمنحى التزام الولايات المتحدة بالمنظمة اصبح قاب قوسين أوادنى خاصة أنها تخترق التعهدات في اعطاء التأشيرات لممثلي الدول التي تختلف مع الولايات المتحدة لحضور جلسات الامم المتحدة. وبالتالي تتصاعد الدعوات في العالم لنقل مقر الامم المتحدة الى خارج الولايات المتحدة لانها لم تعد تتصرّف كدولة مضيفة.
وما حصل مؤخرا في مجلس الامن لاعادة تفعيل العقوبات على الجمهورية الاسلامية في إيران أدّى إلى رفض القرار من قبل الصين وروسيا واعتباره غير قانوني ولن يلزمهما. هذا يعني ان إعادة النظر في هيكلية وعمل المنظمة اصبح ضرورة وخاصة فيما يتعلّق بدور مجلس الامن. فهناك اعضاء دائمون حيث وجودهم كان مبررا في حقبة سابقة ولم يعد الان كفرنسا والمملكة المتحدة. وهناك دول وازنة ما زالت غائبة عن القرار الدولي كالبرازيل والهند وجنوب افريقيا ومجمع الدول العربية ومجمع الدول الافريقية. وهذه اصلاحات ستفرضها موازين القوّة الجديدة بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.
الجزء الثالث : المواجهة مع الكيان الصهيوني المؤقت ومحور المقاومة
حرب الابادة التي يشنّها الكيان المؤقت على الفلسطينيين في غزة بموافقة ومساعدة الولايات المتحدة أصبحت تجسّد الصراع القائم بين محور التسلّط والغطرسة الذي يمثّله الكيان والغرب عموما وفي طليعته الولايات المتحدة ومحور يرفض الخضوع لذلك التسلّط وفي طليعته جبهة المقاومة في المشرق العربي. وإذا كان “طوفان الاقصى” جرف مفاهيما عدّة في السابع من اوكتوبر فإن المواجهة مع الكيان أطلقت موجّة تحرّر في العالم من السطوة الاميركية الصهيونية. فالمظاهرات الاحتجاجية في الغرب ضد الابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المؤقت بمباركة اميركية والحكومات الغربية تحوّلت إلى مظاهرات للتحرّر من السطوة الصهيونية على الحكومات الغربية. وهذه الموجة الاحتجاجية أطلقتها حملة “اسطول الصمود” ومن شارك فيها والقرصنة الصهيونية التي اعترضتها. كما أن اعتراض الاسطول ساهم في التشكيك في مصداقية “مبادرة السلام” التي أطلقها الرئيس الاميركي التي كانت ذريعة لعدد من الحكومات الاوروبية كإيطاليا لسحب دعمها للاسطول بحجة أن محاولة كسر الحصار على غزة “يهدّد” مسار مبادرة ترمب. المهم هنا هو التأكيد أن الصراع القائم في غزة لم يعد صراعا إقليميا بل أصبح يعني العالم باسره ليس كقضية انسانية فحسب بل كقضية تحرّر من الهمنة الصهيواميركية على مقدّرات الشعوب.
المواجهة القائمة هي على عدّة مستويات. المستوى الاول هو المواجهة في غزة وفلسطين المحتلّة بينما المستوى الثاني هو على الصعيد السياسي في الاقليم وفي العالم والمستوى الثالث هو على مستوى الوعي والادراك في الوطن العربي والعالم أجمع.
المواجهة في المستوى الاوّل
اولا- غزة وفلسطين المحتلّة
السؤال الذي يجب طرحه هو حول ميزان القوّة بين المقاومة والشعب الفلسطيني من جهة وبين الكيان ومن يدعمه دوليا وأقليميا. تقدير ميزان القوّة على قاعدة مؤشرات مادية يمكن احتسابها كالعديد والعتاد بين المقاومة وقوّات الاحتلال لن يعطي الصورة الكاملة بل ربما الصورة العكسية للواقع. فهناك عدم تكافؤ في ذلك الميزان لصالح الكيان. لكن ميزان القوّة يتضمن مكوّنات غير قابلة للقياس الاحصائي والتي تفوق اهميته عن الاعتبارات المادية الكمية. والمقصود هنا الاندفاع الايماني والعقلي والابداعي لدى المقاومة الذي يتجاوز السلبيات الناتجة عن الاعتبارات المادية وخاصة عن الطبيعة الجغرافية لساحة القتال التي قد تشكل مقتلا في مواجهة تقليدية. فمحاصرة القطاع والطبيعة المسطّحة للقطاع وصغر مساحة المواجهة ليس لصالح المقاومة نظريا. والعنصر الاخر هو نوعية القيادات في الكيان والمقاومة. لكن اهم عنصر هو مدى تلاحم الشعب مع القيادة. ففي الكيان هناك انقسام عامودى وافقي بين مكوّنات الكيان مع الحكومة. وبالمقابل، هناك التصاق الشعب بالمقاومة بل ربم تقدّم الشعب على المقاومة. والنتيجة هنا هو عدم امكانية الفصل بين المقاومة والشعب في غزة وفلسطين المحتلة وفي الشتات. لذلك استطاعت المقاومة ان تحوّل هذه السلبية في عدم التاكفؤ في العديد والعتاد إلى مصدر قوّة لديها ومصدر ضعف للعدو حيث القتال من مسافة صفر عدّل التفوّق النظري لدى الكيان. كما أن اسلوب المواجهة افرغ ترسانة الكيان من كافة الخيارات العسكرية للقضاء على المقاومة حيث لم يعد يستطيع دفع فاتورة الدم حيث وصلت التقديرات لخسارة العدو إلى أكثر من 10 الاف بين قتيل وجريح ناهيك عن العطب والامراض النفسية التي أصابته. فالكيان فشل في القتال لكنه ما زال ينجح في القتل بسبب العتاد وبسبب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي اوجده التعاون بين الشركات الاميركية الكبرى والشركات التكنولوجية في الكيان المؤقّت.
روسيا لها حضور عسكري غير رسمي عبر مجموعة فاغنر قد يتحوّل فيما بعد إلى خدمات استشارية لتنمية القوّات المسلّحة الافريقية في مواجهة جماعات التعصّب والغلو والتوحّش وأي محاولة استعمارية جديدة للعودة إلى القارة. وهناك رأي منتشر في مراكز الابحاث الاميركية أن أفريقيا قد تكون خرجت من المحيط الغربي وانضمت إلى مجموعة دول الجنوب الاجمالي. وهذا الانضمام لا ينفي الانضمام إلى مجموعة البريكس لاستكمال التحوّل السياسي والاقتصادي والعسكري في إفريقيا.
10- منظومة البريكس ومنظمة شنغهاي.
التقارير السابقة أشارت بشكل مفصّل إلى اهمية منظومة البريكس وما تحمله من دلالات في تغيير موازين القوّة في العالم. والتحوّلات المنظومة خلال السنوات الماضية تستحق بحثا منفصلا إلاّ أن هذا التقرير سيشير بشكل سريع إلى أهم الانجازات التي حققتها. فاليوم اصبحت المنظومة تضم 10 دول وتشكّل أكثر 45 بالمائة من السكّان في العالم. كما ان حجمها الاقتصادي مع الدول الشريكة أصبح يمثل أكثر من 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي في القوّة الشرائية والنسبة في تزايد مستمر على حساب حجم اقتصاد الدول الغربية. والطلب للانضمام الى المنظومة كأعضاء يتجاوز 40 دولة يضاف إليها عدد كبير من الدول التي تريد “الشراكة” معها. ومن الواضح أن المنظومة تكتسب مصداقية كبرى لانها خارجة عن الهيمنة والسيطرة الغربية وخاصة الانجلوساكسونية والولايات المتحدة. ولا يمكن استبعاد الاحتمال أن تصبح المنظومة نواة مؤسسة عالمية موازية إن لم تكن بديلة عن منظمة الامم المتحدة بسبب العجز والشلل الذي اصاب المنظمة الذي يعود إلى تدخّلات الولايات المتحدة لتعطيل المنظمة والانسحاب من العديد من المؤسسات المتفرّعة عنها.
قمة دول البريكس التي عقدت في مدينة قازان الروسية في تشرين الاول 2024 خرجت بقرارات استراتيجية اهمها التركيز على عملة رقمية بديلة عن الدولار في التعامل التجاري بين الدول. القرار الاستراتيجي هو الخروج من الدولار كخطوة مركزية للخروج من الهيمنة الاميركية او تقليل نفوذها في العالم . وقرار الخروج من منظومة الدولار كوسيلة للمدفوعات الدولية والتجارة الدولية يستحق مقاربة منفصلة لا مجال لعرضها في هذا التقرير وإن كانت التقارير السابقة تتطرّقت إلى الموضوع. وإذا كانت اولويات مجموعة البريكس في العقد الماضي التعاون الاقتصادي فحسب فإن الظروف والتحوّلات في موازين القوّة على الصعيد العالمي اوكلت لمجموعة البريكس مهاما اضافية تعود للسياسة والامن ويضاف إليها التبادل التجاري والثقافي. لذلك تصبح المنظومة متكاملة الاهداف يجعلها لاعبا اساسيا وربما الاهم في المعادلات الدولية. وما يعزّز هذا التحوّل قرارات منظمة شنغهاي للتعاون الامني في مطلع هذا الصيف والتي مهمتها الاساسية كانت الامن بين الدول المعنية فأصبحت اليوم معنية أيضا بالاقتصاد والسياسة. لذلك نشهد التلاقي بين منظومة البريكس ومنظمة شنغهاي كلبنات أساسية في إعادة هيكلة العلاقات الدولية على أسس تتمسّك بميثاق الامم المتحدة ولكن خارج الهيمنة الغربية التي لم تعد مقبولة خاصة بعد تغيير موازين القوّة.
هذا ما جعل الرئيس الاميركي ترمب يعلن الحرب على المنظومة التي تنافس بشكل جدّي الهيمنة الاميركية. والرئيس ترمب يهدّد كل دولة تتعامل مع البريكس وتريد الخروج من منظومة الدولار. فسلاح العقوبات والتعريفات الجمركية حلّت مكان الدبلوماسية. غير أن ما تطرحه منظومة البريكس وخاصة الصين وروسيا هو اسس مختلفة للعلاقات الدولية المبنية على الندّية واحترام سيادة الدول واحترام القوانين والمواثيق الدولية، الامر الذي خرجت عنه دول الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. لذلك تستهوي المنظومة دول الجنوب الاجمالي بدلا من الانخراط في الفلك الغربي او الاميركي.
11- مستقبل الامم المتحدة
الشلل الذي أصاب منظومة الامم المتحدة في مجلس الامن يعود إلى استعمال حق النقض للقرارات التي تتناقض مع مصالح الدول صاحبة ذلك الحق. والتجربة تدل على أن اكثر دولة استعملت حق النقض في مجلس الامن هي الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية. فالادارات الاميركية المتتالية كانت دائما إلى جانب الكيان مهما ارتكب الكيان من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ومهما كانت خروقات الكيان لقرارات اممية ومهما تعدّدت الاعتداءات على كل من لبنان وسورية واليمن والعراق والجمهورية الاسلامية في أيران. لكن حتى مع تحوّل المؤسسة الاممية إلى اداة طيّعة للدول الغربية وللمحور الانجلوساكسوني فإن الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب تعتبر المؤسسة عبئا على الولايات المتحدة وذا جدوى محدودة بالنسبة لها. هذا وقد انسحبت الولايات المتحدة من عدّة مؤسسات اممية كالاونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاونروا ومنظمة حقوق الانسان إضافة الى الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ التابع للامم المتحدة.
وهذا التغيير في طبيعة المواجهة كانت له تداعيات سياسية واخلاقية لدى الكيان وخاصة لدى الحلفاء التقليديين للكيان كالولايات المتحدة والدول الغربية.
نوعية العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة في القطاع بعد حوالي سنتين على انطلاق “الطوفان” لفت نظر المراقبين. فبينما كان الكثيرون يعتقدون أن بعد استهداف قادة المقاومة كيحي السنوار وشقيقه محمد السنوار ومحمد الضيف وقبلهم رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، وبعد حوالي سنتين من قصف على مدار الساعة تمّ من خلاله تدمير القطاع ، فبعد كل ذلك اعتقد هؤلاء ان المقاومة تآكلت قدراتها وان انهيارها اصبح وشيكا. واذ تفاجئ المقاومة الجميع في ارتفاع عدد الملتحقين بالمقاومة وبنوعيتهم العلمية العالية وبنموذج العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة حتى في المناطق تحت الاحتلال المباشر. فحجم ونوعية العمليات أدّى إلى استنزاف كبير في القدرات البشرية والمادية لدى قوّات الاحتلال التي ما زالت عاجزة عن تحضير العديد لاستكمال خطة الاحتلال المزعومة لغزّة.
إضافة الى هذه المكوّنات لميزان القوّة والتي لا تخضع لقياس مادي هناك التحوّل الكبير الذي حصل في الرأي العام العربي والدولي تجاه القضية أولا، وتجاه صورة الكيان ثانيا، وتجاه الدول التي تساند الكيان دون قيد أو شرط ثالثا. فصمود الشعب في غزة وصمود المقاومة رغم التفاوت في الامكانات واستمرار وتيرة المقاومة رغم الكلفة البشرية الباهظة كان العامل الاستراتيجي في التحوّل في الرأي العام. واهمية الرأي العام في العالم تكمن في أن احد اعمدة قوّة الكيان، إضافة لإمكانياته المادية، هو الدعم السياسي الغربي ودعم الرأي العام الشعبي في دول الغرب عامة وفي الولايات المتحدة خاصة. فاستطاع الكيان عبر العقود الثمانية الماضية ترويج سردية الضحية بينما كان هو الجلاّد. فالتغيير في الراي العام الشعبي في العالم أضعف قدرات الحكومات الغربية على الاستمرار في دعم الكيان وخسارة ذلك الدعم ينعكس على امكانية استمرار وجود الكيان في المنطقة. فمنذ انطلاق “طوفان الاقصي” قام الشباب في الجامعات الاميركية المرموقة في الانتفاضة ضد سياسة الادارة الاميركية (بايدن آنذاك) الداعمة لمجازر الكيان. وهذه الانتفاضة الجامعية في الجامعة المرموقة لها دلالات عديدة. فالطلاب هم أولاد النخب الحاكمة وانتفاضتهم كانت تمرّدا على سياسات ابائهم. غير ان هذا الوعي لدى الطلاب لم يكن وليد الصدفة. فهو ناتج عن عمل تراكمي بدأ منذ سنوات عديدة عندما تمّ طرح حلّ الدولة الواحدة في فلسطين المحتلة لتشمل الجميع، العرب واليهود. هذا كان جوهر خطاب جمعية “بي دي أس” في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الكنائس. المهم هنا أن من تبنّى قضية الشعب الفلسطيني هم ايضا الطلاب اليهود الذين تمرّدوا ايضا على أهلهم في الدعم الاعمى للكيان وسياساته. وهذا ساهم إلى حد كبير في طرح القضية الفلسطينية وما يحصل في غزّة في متن الخطاب السياسي في الولايات المتحدة.
محصّلة هذا الحراك الطلاّبي والشعبي الذي تمّ مواجهته بالقمع المفرط خلال السنوات الاخيرة لإدارة بايدن وفيما بعد في إدراة ترمب الحالية هو تراجع نفوذ اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس الاميركي وخارجه وذلك رغم سيطرة اللوبي على الاعلام الشركاتي المهيمن الذي تبنّى وما زال السردية الصهيونية لما يحصل في غزّة. لكن العامل الفارق كان شبكة وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصّة تيك توك التي اوردت الصور بالمباشر لما يحصل في غزة. اليوم قيادات بارزة في حركة ماغا داخل الكونغرس وخارجه تنتفض ضد دعم إدارة ترمب للكيان. ومقتل المؤثرّ المحافظ شارلي كيرك الذي كان في مرحلة سابقة من أكثر المؤيّدين للكيان بسبب خلفيته الانجيلية المحافظة تحوّل إلى ناقد للمجازر وللسردية الصهيونية. وأهمية كيرك تكمن بأن عدد المتابعين له في الملايين ويشكّل أحد اعمدة القاعدة الشعبية لترمب. اغتياله اعلن بداية الهجوم المضاد على المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الاوليغارشية الصهيونية المتحكمة بالقطاع التكنولوجي. فالانباء التي تشير إلى تولّي صاحب شركة “اوراكل” (Oracle) رالف اليسون شركة تيك توك وعزمه على تغيير الخوارزميات التي تدعم القضية الفلسطينية وتنتقد سياسة الكيان. هذا يؤكّد تصريح نتنياهو في مطلع شهر تشرين الاول/اوكتوبر أنه يفتح “جبهة ثامنة” في الولايات المتحدة لنقض السردية التي تنتقد الكيان وتؤيّد القضية الفلسطينية. هذا يؤكّد أن معركة فاصلة ستكون على الصعيد الاعلام الموازي في الولايات المتحدة لترميم صورة الكيان، إن كانت قابلة للترميم بعض كل ما حصل.
إن مصير الحرب في تلك الجبهة الثامنة قد تكون مفصلية إذا فشل الكيان وأنصاره في الولايات المتحدة على تغيير الرأي العام رغم الامكانيات المادية التي يمتلكوها لان النتيجة الحتمية ستكون استمرار فقدان التعاطف الذي استفاد منه طيلة العقود الثمانية الماضية.
إذن، الهيمنة المطلقة هي عنوان المرحلة التي يبشّر بها الصهيوني والاميركي (dominance subjugation) وان على الكيانات في المنطقة ان تتكيّف مع ذلك الوضع. فكرة الهيمنة المطلقة لن تختصر على الكيان بل يتبنّاها ترمب في سياسته الداخلية والعالمية وخاصة بالنسبة لدول أميركا اللاتنيتية.
من جهة اخرى اوضح توماس باراك التفكير الصهيوني بانه لا بد من “قطع رأس الافعى” أي القضاء على الجمهورية الاسلامية في إيران لأن لولاها لما كانت مقاومات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق. المرحلة المقبلة في التفكير الصهيوني والذي يلتقي مع جهات وازنة داخل الادارة الاميركية هي المواجهة مع إيران لقلب النظام والاستيلاء على الثروات النفطية وغير النفطية ومنع التمدّد الصيني ومشروع الحزام الواحد والتواجد الروسي في غرب آسيا.
ليس من الواضح ان الحكومات العربية المستهدفة تعي تلك التحوّلات. فما زالت تعتبر أن التعايش مع الكيان ممكن إذا ما ضغطت الولايات المتحدة عليه. ومن المستغرب أنه لم يصدر أي احتجاج على تلك التوجّهات الجديدة للكيان ما يعني أن معركة ادراك الواقع قد تكون بنفس الاهمية إن لم تكن أكثر عن معركة الوعي. غير أنه يمكن اعتماد قراءة مختلفة للموقف العربي من تلك التوجّهات تُشرح في الجزء الاخير من التقرير.
لكن تلك التوجّهات المتطرّفة للكيان تصطدم بأمر الواقع حيث موازين القوّة داخل الكيان وفي المنطقة لن تسمح بتحقيق تلك الطموحات التي تتجاوز بكثير القدرات الفعلية العسكرية والاقتصادية للكيان ناهيك عما أصابه من ضربات استراتيجية في بنيته العسكرية والاقتصادية وأهم من كل ذلك في روح قوّات الاحتلال. فحكومة الكيان عاجزة عن توفير العديد حيث قوّات الاحتياط لم تعد قادرة على تلبية الحاجات العسكرية. آخر المعلومات تفيد أن رئيس الاركان لقوّات العدو لم يستطع أن يجلب أكثر من 12،000 مقاتل بينما المطلوب هو 300 الف! كما أن استدعاء قوّات الاحتياط تؤثّر بشكل مباشر على العجلة الاقتصادية في الكيان حيث التراجع في كافة القطاعات الاقتصادية أصبح واقعا لا محال له. ودعوة نتنياهو لتحويل الكيان إلى سبارطا جديدة يعكس العزلة الاقتصادية العالمية التي يواجهها. كما أن المواجهة العسكرية مع كل من غزّة ولبنان والجمهورية الاسلامية في إيران واليمن كانت لها اثمان لن تسمح للكيان بالبقاء اذا ما استمرّت فما بالك إذا عادت إلى المواجهة المباشرة مجدّدا. وبالتالي يشهد الكيان للسنة الثانية على التوالي، اي منذ بداية عملية “الطوفان” الهجرة المعاكسة التي كسرت سردية أن الكيان ملاذ آمن ليهود العالم. فهذا عامل إضافي يسرّع في ترهّل الوضع الداخلي للكيان حيث الهجرة البشرية تشمل هجرة العقول والرساميل. فمستقبل الكيان أصبح قاتما لشرائح واسعة من المجتمع الصهيوني.
أما العامود الفقري لاستمرار الكيان أي المساعدات الاميركية التي لم يكن لها حدود حتى الساعة فأصبح يخضع لمسائلة ومراجعة عند القاعدة الشعبية التقليدية الاميركية أي القاعدة الانجيلية المحافظة. وبالتالي ليس هناك من يستطيع أن يقول أن تلك المساعدات التي كانت من المسلّمات قد تستمر على ضوء تلك التحوّلات الداخلية في الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بسبب تداعيات الصور التي صدرت عن الابادة التي يرتكبها الكيان في غزّة في الوعي والضمير للشعب الاميركي وخاصة بين الشباب. في الجزء الاول من هذا التقرير تم عرض سريع للتحوّلات في الرأي العام الاميركي تجاه الكيان والتي كانت سلبية للغاية لم يكن ليتوقعها نتنياهو وقيادات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وأخيرا لا بد من التوقّف على مبادرة الرئيس الاميركي من 20 نقطة وتداعياتها على مستقبل الصراع وقبل كل شيء على الوضع الداخلي في الكيان. من الواضح ان نتنياهو لا يستطيع المجاهرة بمعارضة ترمب لان ترمب هو ما تبقّى للكيان من دعم على الصعيد العالمي وأن ذلك الدعم حيوي لا يستطيع الكيان ان يبقى لولاه. لكن هذا لن يمنع نتنياهو في استمرار الحرب على غزة وإن كانت بوتيرة أخفّ. السؤال هو كيف سيوازن بين المطلبين المتناقضين اي ايقاف القصف وتبادل الاسرى واستمرار الحرب لاقناع فريقه في الحكومة أنه لم يتغيّر شيء. مقاربة الوضع الداخلي في الكيان تؤكّد أن قدرة المناورة لدى نتنياهو أصبحت محدودة بسبب التحوّلات العالمية من جهة وتشبص حلفائه في الحكومة في المضي في الحملة التلمودية تجاه “العماليق” في غزة وفلسطين وسائر دول المنطقة التي تشكّل “اسرائيل الكبرى”. لذلك لا يجب أن يغيب عن البال أن رغم كل ما حدث من اخفاقات للكيان في ساحة غزّة فإن بيضة القبّان في الموقف الصهيوني هو الضفة الغربية. فعند اعداد هذا التقرير اقدم الكنيست الصهيوني على الموافقة على ضمّ الضفة إلى الكيان رغم معارضة الرئيس الاميركي اللفظية والتهديد بقطع العلاقات، ما يُسقط امكانية تفعيل حلّ الدولتين المرتبط بمبادرة ترمب والموافقة العربية عليها.
ولكن الامر لا يقتصر على ذلك، فإن ضمّ الضفة يعني المباشرة في تغيير البنية السكّانية أي تهجير الفلسطينيين إلى الاردن. فإذا استطاع الكيان ان يقوم بذلك، ونشكّ أنه يستطيع رغم استعمال القوّة، فتداعيات الضمّ والتهجير ستنعكس على المشهد في الاردن حيث النظام القائم قد لا يستطيع الصمود والاستمرار. فإذا سقط النظام في الاردن فالتداعيات ستكون عديدة على دول الجزيرة العربية والعراق وسورية حيث التواجد العسكري الاميركي قد يواجه فوضى أمنية عسكرية تضطرّه إلى الانسحاب من العراق وسورية. التغيير في خارطة غرب آسيا وانهاء سايكس بيكو على يد الكيان الصهيوني سيخلق سلسلة من الاهتزازات سترتد سلبا عليه والولايات المتحدة ولا يستطيع الكيان ولا الولايات المتحدة ضبطها رغم الادعاء المعاكس لذلك.
من جهة اخرى، إذا حظيت مبادرة ترمب على موافقة عربية واسلامية رغم التحفّظات على الصيغة النهائية التي لم يتمّ الاتفاق عليها فإن خروج نتنياهو عن المبادرة سيكون له تأثيرات على الدعم العربي والاسلامي الذي ما زال يتمسّك به الرئيس الاميركي. استطلاعات الرأي العام في داخل الكيان المؤقّت تشير أن نسبة 80 بالمائة تريد وقف الحرب دون أن يعني ذلك التخلّي عن الطموحات أو تغيير في النظرة تجاه الفلسطينيين. والمشكلة بالنسبة لنتياهو هو امكانية شراء الوقت لتجاوز التباين بين وقف الحرب واستئناف تحقيق الاطماع. شبح الملاحقة القانونية له ما زال قائما والهروب إلى الامام قد يكون الحلّ الوحيد المتبقّي لديه.
في الخلاصة يمكن القول أن الالة العسكرية للكيان الصهيوني أخفقت في تحقيق الاهداف المرسومة المعلنة والمضمرة، أي القضاء على المقاومة، نزع السلاح، تهجير الفلسطينيين من غزّة، وعودة الاستيطان إلى غزة. الالة العسكرية رغم ضخامتها لم تحسم المعركة لاسباب عديدة أهمها أن الحرب لا تُحسم من الجوّ بل في البر. الكيان المؤقت غير قادر على دفع فاتورة الدم وقد تبيّن ذلك في محاولته الدخول إلى لبنان بعد استهداف قيادات حزب الله ومحاولاته المتكرّرة لاحتلال والسيطرة على غزة دون تحقيق أي من الاهداف. الكيان الصهيوني برهن أنه يبرع في القتل ويفشل في القتال. الحرب من الجوّ لم تغيّر في المعادلة الميدانية، بل أدّت غلى خسارة الرأي العام العالمي الذي شكّل على مدى حياة الكيان اهم مصادر القوّة له. فغزّة هزيمة له ومبادرة الرئيس الاميركي ترمب تكّرس الهزيمة مع محاولة لحفظ ماء الوجه للكيان وحتى للولايات المتحدة الشريكة، بل المديرة للحرب التي قامت في غزّة كما جاء على لسان الرئيس الاميركي الذي اعلن في الكنيست الصهيوني شراكة الولايات المتحدة في القتل.
ثالثا- الفصائل المقاومة ووحدة جبهات القتال
استطاعت المقاومة ان تدير القتال بجدارة وبراعة وعبقرية خارجة عن المألوف حيث استطاعت الصمود لاكثر من سنتين رغم عدم التكافؤ في العديد والعتاد مع قوّات الاحتلال ورغم القصف الجوّي والبرّي المتتالي على مدى اربعة وعشرين ساعة لمدة اربع وعشرين شهر. والادارة الميدانية كرّست وحدة الميدان في غزة وفلسطين ولبنان واليمن والعراق رغم كل الادعاءات المعارضة لفكرة المقاومة وجدواها. ويمكن القول أن المقاومة هي التي تحدّد مسار الصراع وليس الكيان أو الولايات المتحدة حيث مواقفهم أصبحت في موقع ردّ الفعل على ما تقوم به المقاومة. وهذا تحوّل استراتيجي رغم مظاهر القوّة التي يريد ترويجها الكيان ومعه الولايات المتحدة. فزمام المبادرة منذ 7 اوكتوبر 2023 ما زال بيد المقاومة ولم يستطع الكيان تغيير ذلك رغم تواجده في القطاع دون أن يسيطر عليه. فيوميا يتعرّض لكمائن قاتلة لا يستطيع ايقافها ولا يستطيع تغير المعادلة العسكرية. قد برهنت المقاومة أنها تتفوّق على قوّات الاحتلال في القتال وخاصة في القتال من مسافة صفر بينما الاحتلال يجيد فقط في عملية القتل من الجوّ أو من مسافة بعيدة. والقتل ليس كالقتال الذي يصنع المعادلات. فرغم استهداف قيادات المقاومة في غزة وخارج غزة وفي لبنان لم يستطع الكيان المسّ بجسم المقاومة لا على صعيد التنظيمي ولا على صعيد القتالي ولا خاصة على روح القتال التي ازدادت وتشكّل عاملا اساسيا في ميزان القوّة.
وحدة الميدان تطرح مسألة وحدة الموقف السياسي ووحدة الموقف السياسي تطرح قضية الانقسام في الساحة الفلسطينية. وهناك رأي يجب التوقّف عنده هو أن الانقسام ليس فقط بين فصائل المقاومة والسطلة الفلسطينية ولكن في جدوى تعدّد الفصائل حيث الهدف الوحيد في المرحلة الراهنة هو التحرير من الاحتلال وليس شكل النظام السياسي أو الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. كما انه هناك ضرورة لضم تجمّعات الشتات التي ليست منخرطة في الفصائل والتي حجمها العددي لا يقلّ عن حجم المواطنين في فلسطين التاريخية. وتعدّد الفصائل يعود إلى حقبة تدخّل عدد من الانظمة العربية في الشأن الفلسطيني فتمّ انشاء فصائل تابعة لهذا النظام أو ذاك.
وبما أن الدول العربية حاليا لا تساند فكرة المقاومة وبالتالي تتماهى من خيار وسياسة السلطة الفلسطينية فجدوى استمرار فصائل منفصلة عن بعضها يصبح موضوعا يحتاج لنقاش. في مطلق الاحوال فإن الحوار الفلسطيني الفلسطيني يجب أن يتمحور حول خيار المقاومة وأشكالها وسبل دعمها وتمكينها فلسطينيا وعربيا ودوليا مع التركيز على العامل الفلسطيني. كانت هناك محاولات لتوحيد الموقف السياسي برعايات مختلفة إلاّ أن منطق الخلافات طغى على ضرورة تثبيت موقف الوحدة. والمطلوب هو أنشاء جبهة مقاومة موحّدة تدير المعركة العسكرية والامنية والسياسية في آن واحد.
إلى أن يتم ذلك فالمقاومة تتعامل اليوم مع مبادرة ترمب بحكمة وحنكة اربكت العدو كما اربكت أركان الادارة الاميركية. وتفكيك رد المقاومة أصبح درسا في الحنكة والممارسة (sophistication) تتناولها المنصّات في الغرب ومراكز الابحاث. فموقف المقاومة التي عبّرت عنه حركة حماس يحظى اليوم بتأييد الفصائل الفلسطينية وحزب الله وانصار الله والمؤتمر العربي العام بكافة مكوّناته. في آخر المطاف يمكن القول أن المقاومة لم تهزم لا في غزة ولا في لبنان وبالتالي هي منتصرة كما أن العدو لم ينتصر في غزة أو في لبنان وبالتالي هو مهزوم. هذه هي المعادلة القائمة حتى الساعة والتطوّرات الممكنة وحتى المرتقبة تنذر بأن يتحوّل انتصار المقاومة بشكله الحالي إلى انتصار مبين وهزيمة الكيان إلى هزيمة مبينة لا يستطيع اخفاءها. فموازين القوّة في الاقليم والعالم تتغيّر بوتيرة مرتفعة ليس لصالح الكيان المؤقت بل لصالح الحق الفلسطيني بسبب صمود المقاومة والشعب في غزة وفلسطين المحتلّة. والصمود هو مكوّن اساسي في موازين القوّة يصعب احتسابه وقياسه كسائر المكوّنات كالعديد والعتاد والاقتصاد والمال بينما العناصر المعنوية كالايمان بالله والقضية، ونوعية القيادات والمجاهدين، ودافع التضحية الذي كرّس المعادلة البيسطة النصر أو الشهادة، فهذه العناصر ساهمت في تغيير الرأي العام في العالم وبالتالي عدّلت بشكل جذري ميزان القوّة الذي كان لصالح الكيان فأصبح لصالح فلسطين.
المستجد هنا هو مبادرة ترمب لوقف الحرب. إن وقف النار وتبادل الاسرى والعدول عن تهجير الغزّاويين يشكّل بحد ذاته انجازا كبيرا للمقاومة وللشعب الفلسطيني. الخطورة في المبادرة هي الفقرة التي تدعو إلى انشاء مجلس وصاية دولية على غزة وتسخيف القضية الفلسطينية إلى مشروع عقاري للغرب وليس للفلسطينيين. فهذه عودة إلى عصر الانتداب الانجلوساكسوني (تكليف طوني بلير وترئيس ترمب لذلك المجلس) وتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في العودة إلى دياره والتعويض له. هذا التجاهل لحق العودة لا يستقيم مع تضحيات الشعب الفلسطيني ولا مع سياق التحوّلات في العالم. لذلك من المهم التصدّي لذلك المجلس الانتدابي الذي ينفي كل نضال الشعب الفلسطيني والشعب العربي.
هذا التصدّي يتطلّب وحدة الموقف الفلسطيني. الحديث عن الانقسام الفلسطيني طويل ولكن لا بد من بلورة صيغة تؤمّن الحدّ الادنى من الوحدة. السؤال الذي يمكن طرحه هو هل من الممكن انشاء جبهة مقاومة لتحرير فلسطين غير منظمة تحرير فلسطين؟ وهذه الجبهة عليها ان تضم جميع الفصائل الفلسطينية المقاومة بما فيها الجهات داخل حركة فتح التي ما زالت متمسّكة بخيار المقاومة رغم خيارات قيادتها. كما أن هذه الجبهة عليها ان تضم ممثلّين عن الفلسطينيين في الشتات لأن عددهم قد يوازي في الحد الادنى عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلّة. ويمكن دعوة السلطة والمؤسسات الناتجة عنها للانخراط في تلك الجبهة وإذا رفضت بغض النظر عن اسباب رفضها فيجب تجاهلها فتنزع عن نفسها شرعية التمثيل الفلسطيني. فلا داعي للمساجلة والنزاع معها لا في السياسة ولا في الشارع.
المواجهة على المستوى الاقليمي
أولا- لبنان
المقاومة الاسلامية في لبنان اختارت ان يكون لبنان جبهة مساندة منسجمة بالتالي مع عقيدتها ب “الزحف نحو القدس” وبمبدأ وحدة الساحات المقاومة للاحتلال الصهيوني في فلسطين التاريخية. ونتيجة لفعّالية الاسناد العسكري قام التحالف الاميركي الصهيوني في استهداف قيادات المقاومة عبر سلسلة عمليات أمنية وعسكرية كان واقعها الاستعراضي والاعلامي كبيرا. والهدف من الاستهداف للقيادات السياسية والعسكرية هو قطع رأس الجسم السياسي والمقاتل لتنهار المنظومة بأكملها. إلاّ ان استشهاد قيادات حزب الله لم يمنع المقاومة من التصدّي للعدو الصهيوني في معركة “اولي البأس” التي تلت استشهاد القادة، بل زادت المجاهدين عزما في استكمال المهمة كما حفّز انصار الحزب للالتفاف حوله. العدو ومعه الاميركي مارس العقلية الاستشراقية أن في الفضاء العربي والاسلامي (المتخلّف في رأيهم) فإن استهداف القادة كاف لإجهاض أي عمل منظّم.
الكفاءة العالية لدى المقاومة الاسلامية في لبنان في إدارة العمليات العسكرية داخل فلسطين المحتلة وفوق الاراض اللبنانية منعت قوّات الاحتلال من التقدّم في الجنوب اللبناني. وهذه القدرة العسكرية اوجعت قوّات العدو التي طالبت هي بوقف اطلاق النار لان حجم الخسائر في المعارك البرّية لم يستطع تحمّلها. ما يغيب عن الكثيرين من المراقبين والمحلّلين في لبنان وفي بعض دول الخليج أن العدو هو الذي طلب وقف اطلاق النار وليست المقاومة. وبالتالي تصوير المقاومة بأنها هزمت هو تزوير فاضح لوقائع الميدان. العدو، ومعه الادارة الاميركية والتابعون لهم في لبنان سارعوا في ترويج سردية هزيمة المقاومة بسبب ما اصابها من خسائر دون الالتفات إلى ما حققّته المقاومة بعد الاستهداف وحتى وقف اطلاق النار الذس استجداه العدو.
المهم هنا هو أن المقاومة وافقت على وقف اطلاق النار الذي تلاه مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان عبر انتخاب العماد جوزيف عون والمجيء بالقاضي نوّاف سلام كرئيس للحكومة. ليس هدف التقرير سرد ملابسات المجيء ثم الانقلاب على التعهدّات التي اعطيت للحزب الله ومعه لحركة امل من قبل الرئيس وخاصة من قبل رئيس الحكومة بل التأكيد أن قرار حزب الله كان مبنيا على قراءة دقيقة للمشهد الدولي والاقليمي وموازين القوّة وضرورة الاستفادة من هدنة معينة لإستكمال ترتيب اوضاعه الداخلية. والموقف السياسي للحزب هو تسليم السلطة الجديدة مسؤولية تحرير المناطق التي احتلّها الكيان المؤقت بعد وقف اطلاق النار وليس من جرّاء القتال. وبات واضحا ان استراتيجية السلطة الجديدة أنه باستطاعتها تحقيق الانسحاب القوّات المحتّلة بالطرق الدبلوماسية التي جاهرت بها لم تفلح في تحقيق أي تقدّم بل لم تمنع العدو من الخروقات الدائمة والاستهداف لمناطق عديدة في لبنان. فالجيش اللبناني لا قدرة له على المواجهة بمفرده والسلطة الجديدة لم تضع في أولوياتها التحرير بل فقط الاستجابة للإملاءات الاميركية المدعومة من بلاد الحرمين. وهذه الاملاءات تقضي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة كخطوة اساسية لبناء الدولة على حد زعم رئيس الحكومة. ومن الواضح ان حكومة الكيان اعلنت أنها لن تنسحب من لبنان بغض النظر عمّا سيحصل في الداخل اللبناني. هذا هو المأزق الذي وقعت فيه السلطة الجديدة في لبنان وما زال قائما حتى اعداد هذا التقرير.
الاملاءات الاميركية كانت مبنية وما زالت على فرضية أطلقها الموفد الاميركي توماس باراك أن على لبنان وسائر الدول في المنطقة أي ضرورة الخضوع لهيمنة الكيان المطلقة وإلا هذه الكيانات إلى زوال. هذا الوضوح بالطرح رافقه التهديد المباشر أن في حال رفضت السلطة اللبنانية التوجّهات الاميركية فإن السلطة الجديدة في سورية ستقوم باحتلال لبنان! من جهة اخرى فإذا مضت السلطة في مشروع حصر السلاح بالقوّة فإن الحرب الاهلية قد تكون النتيجة وهذا ربما ما يُرحّب به العدو. وموقف بعض الدول العربية تجاه لبنان (بلاد الحرمين، مصر) غير مفهوم على ضوء القرارات التي اتخذتها خلال السنوات الثلاث الماضية في إعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتحسين العلاقات مع الجمهورية الاسلامية في إيران وإعادة التموضع في مجموعات مناهضة للهيمنة الاميركية. على كل حال فإن حكمة قيادة حزب الله في مد اليد للجميع لبنانيا وعربيا كما جاء على لسان الامين العام الشيخ نعيم قاسم قد تكون له نتائج إيجابية على ضوء التطوّرات الاقليمية والدولية التي لم تعد لصالح الكيان وسياسات الادارة الاميركية في الإقليم وفي العالم.
من جهة اخرى فإن ميزان القوّة في الداخل اللبناني أفضى إلى أمكانية رفض نزع السلاح بسبب التهديدات التي اطلقها توماس باراك حول دور جماعات التوحّش والغلو والتعصّب ألتي تحكم سورية الجديدة. هذا ما عدّل في مواقف قيادة السلطة الجديدة وخاصة عند الرئيس عون وقيادة الجيش. أما رئيس الحكومة فيواجه معركة صعبة ضد المزاج الشعبي وحتى المزاج السنّي الذي اعتبره معاديا للحزب. فالمزاج السنّي هو مع المقاومة ويعتبر الكيان عدوا وجوديا بينما هذا لا يعني تفويض حزب الله بالهيمنة على القرار السياسي في لبنان. لكن في المحصّلة، الضغط على سلاح المقاومة هو من الخارج ولم يعد من الداخل في لبنان وهذا تطوّر لم يكن بالحسبان عند الطرف الاميركي. واستطلاعات الرأي العام في لبنان تشير إلى أن اكثرية وازنة من اللبنانيين في الطوائف الرئيسية مع بقاء السلاح في يد المقاومة في ظل التهديدات الاسرائيلية والتي يمكن أن تاتي أيضا من جماعات التعصّب والغلو والتوحّش في سورية. اما القضايا الاخرى التي ربطت حصر سلاح المقاومة بالسلطة كإعادة اعمار الجنوب والمناطق التي استهدفها الكيان المؤّقت فهي أيضا مؤجّله إلى أجل غير مسمّى على الاقل عند هذه الحكومة. ليس من الواضح على ضوء التطوّرات في المواجهة مع الكيان في غزة أن تستطيع الحكومة التي اتت في ظروف محدّدة لم تعد حيثياتها موجودة أن تستمر في سياستها الحالية.
ثانيا- اليمن
المتغيّر الاسترايجي في موازين القوّة في الإقليم كان دور اليمن الذي لم يقتصر على دور مساند للمقاومة في غزّة وفلسطين بل أيضا أصبح لاعبا استراتيجيا في المعادلة الجيوسياسية التي تتحكّم بسياسات الدول الكبرى. فالهزيمة التي ألحقها بالولايات المتحدة في ولاية بايدن وفي ولاية ترمب اسقطت اسطورة سيطرة البحرية الاميركية على الممرّات البحرية خاصة في محيط البحر الاحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. السيطرة على باب المندب يعطي فكرة عمّا يمكن ان يحصل لو يتمّ اغلاق مضيق هرمز. موقف اليمن العملياني في دعم المقاومة يترجم الدعم الشعبي الكبير الذي ظهر منذ وصول انصار الله إلى السلطة. واليمن هو الذي جعل الجمهور الصهيوني في الكيان ينزل إلى الملاجئ هربا من الصواريخ والمسيّرات. ودعم المقاومة في فلسطين أعطى الشرعية السياسية الفعلية لأنصار الله أضافة إلى شرعية الامر الواقع. واليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي نشهد فيها تلاحم القيادة مع الشعب بشكل عام وخاصة فيما يتعلّق بفلسطين.
وزن اليمن في المعادلات الاقليمية لا يقل عن وزن كل من الجمهورية الاسلامية في إيران وتركيا وبلاد الحرمين ومصر. ولم يعد من الممكن استشراف الموقف للمرحلة القادمة دون الاخذ بعين الاعتبار موقف اليمن. والامر ينجرّ أيضا على الدول الغربية والولايات المتحدة كما أيضا على الدول التي تتصدّى للهيمنة الاميركية في كل من آسيا وإفريقيا. ومن الواضح أن اليمن مقبل على أن يكون حجر الزاوية في ترتيبات امن بحر الاحمر والقرن الإفريقي ودول وادي النيل. والوضع الجديد الذي اوجده اليمن يجعل مصدر صداع للرأس الاميركي والصهيوني مضاعفا ثلاث مرّات بسبب وجود اليمن والجمهورية الاسلامية في إيران وجبهة المقاومة.
القدرات العسكرية والعلمية التي ابرزها اليمن لم تكن مفاجئة لمن كان يتابع الاوضاع العلمية. ويشهد المفتّش السابق الاميركي والضابط في المارينز الاميركي سكوت ريتر أن اليمن كان يساعد أشقاءه في العراق في التسعينات من القرن الماضي في تطوير الصواريخ. فتملّك المعرفة لإنتاج الصواريخ البالستية والفارقة للصوت إضافة لتصنيع المسيّرات التي اخرجت من الخدمة مرفأ ام الرشراش (أي ايلات) يجعل من اليمن قوّة لا يمكن تجاهلها وتكسر موازين القوّة العسكرية التي كانت لصالح الكيان المؤقت. فحتى اعداد التقرير يجبر اليمن بشكل متكرّر على مدار الاسابيع سكّان الكيان على النوم في الملاجئ. هذا تحوّل كبير ساهم في كسر نفسية سكّان الكيان ما يدفعهم إلى الهجرة.
ثالثا- الجمهورية الاسلامية في إيران
الجمهورية الاسلامية في إيران أصبحت دولة عظمى في الإقليم ولاعبا اساسيا في الصراع مع الكيان وشريكا استراتيجيا لكل من روسيا والباكستان والصين. وعضوية إيران في منظومة البريكس ومنظمة شنغهاي يعطيها بُعدا دوليا لم يكن في حسبان الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. والولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني ودول الغرب الاجمالي يعتبرون أن إيران هي أساس متاعب الكيان وحليفها الاميركي في الإقليم. لذلك نرى التركيز السياسي والاعلامي على شيطنة الجمهورية الاسلامية بغية عزلها في الإقليم لاستفرادها عسكريا بهدف قلب النظام وربما إعادة تنصيب ابن الشاه المخلوع أو المجيء بفريق من النظام الحالي يكون متماهيا مع الولايات المتحدة.
بعد ساعات من بدء العدوان الصهيوني الفاشل في شهر حزيران/يونيو 2025 على إيران مستهدفا القيادات العسكرية والسياسية وحتى القائد علي خامنئاي في رهان خاطئ ان الشعب الايراني سيهبّ ويسقط النظام قامت إيران بدكّ الكيان الصهيوني المؤقت بسلسلة من الصواريخ والمسيّرات على مدى 12 يوم دون أن تستطيع وسائل الدفاع الاميركية المنتشرة في الخليج والاردن والكيان من أيقافها. وكانت نتيجة القصف الصاروخي تدمير البنى التحتية العسكرية والامنية والاستخباراتية في الكيان وفي مختلف المدن وخاصة في تل ابيب حيث تبيّن أن ثلث المدينة قد دمّر. هذا اجبر قيادة الكيان على الاستنجاد بالاميركي لوقف النار غير أن وقف النار تُرجم في وسائل الاعلام الغربية كنقطة ضعف ودليل عن الهزيمة الايرانية. ثم تلا كل ذلك العدوان الاميركي على المفاعلات النووية الايرانية التي زعم الرئيس الاميركي انه سحقها. غير ان عددا من الضباط الاميركيين في البنتاغون نفوا ذلك الزعم ما ادّى إلى عزلهم من قبل الرئيس الاميركي. الردّ الايراني على القاعدة الاميركية الحديد في قطر اُعتبر ردّا رمزيا من قبل الادارة الاميركية لحفظ ماء وجه القيادة الايرانية ألاّ انه تجاهل أن الرد الايراني استهدف وأصاب مركز القيادة والسيطرة في القاعدة. المهم هنا هو توظيف الاعلام وترويج سردية أن الجمهورية الاسلامية في إيران تلقّت ضربات قاسمة أضعف دورها ونفوذها في المشرق العربي.
ليس هناك من استعداد لدى الكيان الصهيوني المؤقّت ولا في إدارة ترمب التسليم بأن الجهوزية والقدرات العسكرية في الجمهورية الاسلامية قادرة على صد أي عدوان بل أيضا لديها امكانيات حقيقية في إلحاق الضرر الكبير للمنشئات الاميركية والصهيونية في آن واحد. الحسابات الصهيونية والاميركية مبنية على فرضية على التفوّق الكاسح للقوّات الجوّية الاميركية والصهيونية وعلى التفوّق التكنولوجي في الرصد وتعطيل وسائل الدفاع الجوّية الايرانية. لم يتعظ الصهاينة والاميركيون من جرّاء المواجهة في حزيران وعلى ما يبدو هناك تحضيرات حثيثة لدى الاميركيين والصهاينة لتكرار العدوان.
من جهة اخرى هناك حديث متزايد في الاروقة الصهيونية والاميركية أن المواجهة القادمة والحتمية حسب زعمهم مع الجمهورية الاسلامية ستكون حاسمة لأن الفريق الصهيوني والاميركي سيستعمل كافة الوسائل بما في ذلك السلاح النووي. هذه الفرضية تسود عقل الصقور في الادارة الاميركية حيث صرّح وزير الحرب بيتر هيغسيت أن هدف الاعمال العسكرية الاميركية الانتصار وأنها ستحرّر من كافة القيود (المقصود اتفاقية جنيف على سبيل المثال) واستعمال كل ما لديها بما فيها السلاح النووي. لم يعد هناك أي رادع قانوني أو اخلاقي حيث أصبح الحديث عن استعمال السلاح النووي حديثا اعتياديا لا يجب أن يثير أي استغراب. طبعا، هذه الفرضية تخرج من التحليل الاستشرافي العقلاني ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن اللجوء الى السلاح النووي لن يكون مقتصرا على ايران بل قد يشمل العالم بأكمله. فلا الصين ولا روسيا ولا الهند ولا الباكستان ولا كوريا الشمالية تستطيع أن تقف متفرّجة لأنها ستكون مستهدفة بعد استهداف إيران. لذلك يصعب الاخذ بعين الاعتبار ذلك الاحتمال لما له من عواقب وخيمة على العالم بما فيه الولايات المتحدة التي لن تكون بمنأئ عن اي هجوم روسي أو صيني او كوري شمالي. كما هناك رهان على الحد الادنى من العقلانية في القيادة العسكرية الاميركية لتجنّب اللجوء إلى ذلك السلاح.
الجمهورية الاسلامية في إيران اصبحت عضوا اساسيا في منظومة البريكس كما أنها عضو في منظمة شنغهاي للتعاون الامني. كما أنها نسجت علاقات استراتيجية مع روسيا ومع الصين في الميدان السياسي والاقتصادي والعسكري. وفي الاقليم هناك تحالف مع باكستان وتقارب ملموس مع بلاد الحرمين ومصر. وهذا التقارب مع الدول العربية يعني أولا وأد الفتنية السنية الشيعية، ويعني أن الامن الاقليمي سيكون بيد دول الإقليم وليس بيد دول غربية كما كان الحال حتى زمن قريب. هذا متغيّر جيوسياسي كبير يعني تكريس تراجع النفوذ الاميركي والغربي في المنطقة. وبما ان المنطقة لها دور مركزي في التوازنات الدولية فإن فقدان السيطرة عليها يعني تعثّر أي مشروع للسيطرة على آسيا وإفريقيا. المهم هنا أن ميزان القوّة الاستراتيجي انكسر لصالح المحور المناهض للهيمنة الاميركية عالميا وللمشروع الصهيوني في الإقليم تمهيدا لزواله المرتقب قريبا.
المواجهة على المستوى الدولي
“طوفان الاقصى” والحرب التي تلاها كان لهما تداعيات مفصلية في العالم أهمها سقوط مصداقية الحكومات الغربية وتنامي الشعور الشعبي فيها ضد سياسات حكوماتها التي دعمت بشكل اعمى اعمال الاجرام للكيان الصهيوني المؤقت. التغيير في الراي العام العالمي بما فيه العالم الغربي وخاصة الاميركي شكّل نقلة نوعية في ميزان القوّة لصالح القضية الفلسطينية. الكيان الصهيوني استفاد لمدة ثمانية عقود من سردية كاذبة تمّ كشفها في حرب الابادة ضد أهلنا في غزة. والصور التي خرجت إلى الرأي العام العالمي غير قابلة للمحو والتغيير في رؤية العالم للكيان. تحاول حكومات الغرب امتصاص غضب شعوبها عبر اطلاق مبادرات كالاعتراف بحلّ الدولتين دون تحديد آليات تحقيق ذلك ودون تحديد جغرافية الدولة وأهم من كل ذلك تكريس حق العودة والتعويض على التهجير القسري. والانكى من ذلك ذهبت بعض الحكومات اعتبار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ك “عقاب” للكيان الصهيوني إن لم يوقف الابادة دون التطرّق إلى حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بها وبوجوده!
كما أن طرح حل الدولتين يأخذ زخما اعلاميا في الغرب دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحقائق التي فرضها الكيان المؤقت على الارض في الضفة الغربية ما يجعل اقامة دولة فلسطينية على قاعدة حدود 1967 أمرا مستحيلا خاصة مع تواجد ما يقارب مليون مستوطن في الضفة. وحل الدولتين الذي يُروّج له لا يأخذا أيضا بعين الاعتبار التحوّلات في المجتمع الصهيوني حيث طبيعة الكيان في 2025 تختلف بشكل جذري عن شكل ومضمون الكيان عند تأسيسه سنة 1948. هذا التحوّل يبدو أن الشباب في الغرب بدأ يستدركه فيرفع الشعار “فلسطين حرّة من البحر إلى النهر”. وحتى في بيئة الانجيليين المحافظين في الولايات المتحدة الذين كانوا من أشدّ الانتصار لليكان الصهيوني على أساس أن إقامة دولة الكيان هو تمهيد لعودة سيّدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
فهؤلاء بدأوا يشكّكون أن اليهود هم شعب الله المختار لأن لا يمكن لله أن يأمر بقتل النساء والاطفال والابرياء. هذا ما جاء على لسان تاكر كارسلون وهو من أهم اعمدة تيّار ماغا فأحدث زلزالا في المجموعة الانجيلية. في مطلق الاحوال يشهد العالم تحوّلات جذرية في النظرة للكيان وللعقيدة التي تطرحها المجموعات اليمينية الدينية المتطرّفة ما يساهم ايضا في تغييرموازين القوّة.
لقد جنّد نتنياهو في زيارته الاخيرة لواشنطن الاوليغارشية اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة للاستيلاء على وساءل الاعلام الاميركية وخاصة المنصّات في وسائل التواصل التي نشرت الصور الصادرة عن غزّة وخاصة تلك التي صوّرها جنود الاحتلال وهم يرتكبون المجازر. اشار هذا التقرير في فقرة اعلاه عن تلك المحاولة بعد أن استدركت القيادة الصهيونية في الكيان وفي الولايات المتحدة اهمية معركة الوعي ومعركة الادراك التي خسرها من جرّاء “الطوفان”. لكن هناك شكوك أنه حتى مع السيطرة على وسائل الاعلام ووسائل التواصل هناك إمكانية لترويج رواية مناصرة للكيان ومعادية لفلسطين.
أما فيما يتعلّق بمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار في غزّة فإن عنوان المعركة على عاتق القوى المناهضة للمشروع الصهيوني هو اسقاط مشروع الانتداب على غزة وإعادة التأكيد على الهوية الفلسطينية التي لا يشير إليها مشروع الرئيس الاميركي لوقف اطلاق النار. كما أن مسألة إعادة إعمار غزّة لا يمكن أن تتم دون قاعدة سياسية. ما تطرحه مبادرة ترمب هو مشروع انتدابي فقط لا غير (إضافة لبعد الصفقة العقارية كجعل غزّة ريفيارا شرق المتوسط!) ويغيّب الارادة الشعبية الفلسطينية. وبما أن تلك الرؤية السياسية يشوبها الكثير من العوائق وإمكانيات التنفيذ سياسيا وعسكريا فإن إعادة الاعمار لا يمكن أن تتم إلاّ على يد الفلسطينيين وضمن رؤيتهم السياسية وليست رؤية أي مشروع انتدابي أو صهيوني. وليس من المؤكّد أن الدول العربية التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ قادرة على تنفيذ ذلك المشروع وخاصة في غياب دول وازنة كبلاد الحرمين واليمن والجمهورية الاسلامية في إيران، وروسيا والصين، وأهم من كل ذلك الممثل الفعلي للشعب الفلسطيني، أي المقاومة الفلسطينية. فموازين القوّة ليست في صالح المشروع الصهيو – اميركي وموازين القوّة في الميدان والعالم هي التي فرضت على ترمب الضغط على حكومة الكيان لوقف النار. ليس هناك خطّة بديلة قابلة للتنفيذ وهذا يختلف بشكل جذري عن الرغبات والتمنّيات الصهيونية أو الاميركية. لذلك ما حصل في شرم الشيخ لا يتجاوز مشروع عناوين عريضة تخفي العجز الاميركي والصهيوني في القضاء على المقاومة وتنفيذ المشاريع الكبرى لدى الادارة الاميركية.
الجزء الرابع: التحوّلات في المشهد العربي
سيقارب التقرير في هذا الجزء أولا مسألة مراجعة التحالفات والاصطفافات العربية فيما يتعلّق بالعلاقات الدولية وتداعياتها على الدور والنفوذ الاميركي، وثانيا التحوّلات في المشهد السوري، وثالثا، مواقف الحكومات العربية من الابادة الجماعية في غزة، ورابعا مواقف الجماهير العربية من التطبيع، وخامسا، المشهد في السودان، وسادسا قضية تفعيل الشارع العربي وآليات العمل السياسي، وسابعا، طرح بعض الافكار لتفعيل الشارع العربي والمؤتمر القومي العربي.
أولا- التحوّلات في الخيارات والسياسات عند اركان النظام العربي
يعتبر كثيرون من المحلّلين والمراقبين أن “طوفان الاقصى” احدث زلزالا كبيرا في الوطن العربي. فالنظام العربي الموروث من الحقبة الاستعمارية أصبح يواجه تحدّيات مفصلية ناتجة عن التحوّلات في موازين القوّة في الاقليم وفي العالم. ويجب الاعتراف أن النخب الحاكمة في الوطن العربي كانت قد بدأت في منتصف العقد المنصرم مراجعة لخياراتها وسياساتها التي حكمتها منذ رحيل الزعيم الخالد الذكر جمال عبد الناصر. ففي الحقبة التي تلت رحيل الزعيم اعتبرت النخب الحاكمة أن 99 بالمئة من اوراق اللعبة في الإقليم هي بيد الولايات المتحدة وان بوّابة استرضاءها هي التعامل مع الكيان الصهيوني المؤقّت. لكن فشل تقديم الحماية لبلاد الحرمين من الصواريخ والمسيّرات اليمنية على المنشئات النفطية التابعة لشركة ارامكو كما استهداف السفن التابعة لدولة الامارات العربية طرحت مسألة جدوى تلك الحماية المكلفة في شراء الاسلاحة الاميركية التي لم تبرهن عن أي فعّالية وعن الاستثمارات التي تُفرض عليها لتعويم الاقتصاد الاميركي المترهّل خاصة فيما يتعلّق بالقضايا المالية. وإضافة لذلك، فإن النخب العربية لاحظت مدى تراجع نفوذ الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص في السيطرة على شؤون العالم سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا كما اوضحت الحرب في اوكرانيا وفشل الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي في كسر الهجوم الروسي. أضف إلى ذلك صعود الصين اقتصاديا وسياسيا والان عسكريا فإن ذلك أصبح عاملا مؤثرا في الحسابات العربية.
أما إقليميا فأن التغيير الذي حصل في سورية خلط الاوراق بشكل يصعب تحديد التوجّهات المستقبلية لسورية وانعكساتها على المشهد العربية. ونجاح الجمهورية الاسلامية في إيران في صدّ العدوان الصهيوني عليها ومنعه من تحقيق أهدافه تلازم أيضا مع الرد الآيراني على الولايات المتحدة التي استهدفت المفاعلات النووية. وأخيرا، لا بد من تسجيل أن العدوان الصهيوني على قطر شكّل صدمة بالغة الاهمية في العقل العربي وخاصة بعد انكشاف الدور الاميركي في العدوان.
لاحظت التقارير السياسية السابقة للمؤتمر القومي العربي في السنوات الاخيرة التحرّكات التي قامت بها بعض الدول العربية كبلاد الحرمين ومصر على سبيل المثال. فالخطوات التي اتخذتها حكومات تلك البلاد تشير أن منحى استقلاليا نسبيا ظهر في القرار السياسي والاقتصادي. ويمكن القول أن دول اساسية في النظام العربي بدأت في إعادة النظر في تموضعها السياسي والاقتصادي أقليميا وعالميا. فعدد من الدول العربية التحقت بمنظومة البريكس وهذا تحوّل لا يُرضي الادارة الاميركية. عنوان المرحلة هو أيجاد نوع من التوازن في العلاقات مع الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا ومع دول المجموعة الاوراسية ومنظومة البريكس ومتفرّعاتها.
فما هي الخطوات التي اقدمت عليها هذه الدول؟ للتذكير، فبالنسبة لبلاد الحرمين كانت الخطوة الاولى تأكيد دورها في استقرار سوق النفط بعيدا عن الحاجات الاميركية. فالتفاهم مع روسيا اوجد اوبيك + الذي صمد أمام الضغوط الاميركية في حجم ضخّ النفط وفقا لمقتضيات الادارات الاميركية المتعاقبة. الخطوة الثانية كانت في تحسين وتطوير العلاقات السياسية مع روسيا التي تلتها تحسين العلاقات مع الصين. هذا مهّد لخطوة ثالثة رعتها في البداية روسيا ووتولتها فيما بعد الصين في انجاز التقارب مع الجمهورية الاسلامية في أيران. وابعاد ذلك التقارب شكّل نقطة تحوّل في المعادلات الاقليمية والتوازن السياسي الاقليمي. وتطوّر تلك العلاقات بين البلدين وصلت إلى أجراء مناورات بحرية مشتركة تمهيدا لترسيخ قاعدة جديدة لامن الخليج ومن بعده أمن المنطقة أنه بيد الدول الاقليمية وليس بيد الغرب أو الولايات المتحدة. كما أن بلاد الحرمين ساهمت في عودة سورية قبل رحيل النظام إلى الجامعة العربية بعد انقطاع دام اكثر من عقد. والقرار الاكثر خطورة هو قرار بلاد الحرمين بعدم تجديد تسعير النفط بالدولار والمباشرة في تسعير برميل النفط باليوان للصادارات الى الصين. هذه الخطوة تشكّل ضربة قوية لهيمنة الدولار في العالم عبر انخفاض الطلب على الدولار بسبب عدم تسعير البرميل بالدولار. ويضاف إلى كل ذلك المشاركة في منظومة البريكس دون قبولها رسميا للعضوية. فهذه سلسلة من القرارات تشير إلى مصالح بلاد الحرمين أصبحت هي التي تتحكّم بقررات المملكة وليس لتحقيق أهداف الولايات المتحدة. هذا لا يعني الابتعاد عن الولايات المتحدة التي ما زالت تربط مصالح اقتصادية كبيرة تتجاوز 3 تريليون دولار ناهيك عن التسليح لها لكن هامش الحرّية أصبح أكبر في تحرّكها الدولي والإقليمي.
أما باللنسبة لمصر فلا بد من الاشارة أنها رفضت المشاركة في العدوان على اليمن بناء على طلب الولايات المتحدة في إدارة بايدن كما في إدارة ترمب. ومصر اتخذت قرارا بتنوّع تسليحها وعقدت صفقات مع كل من روسيا والصين ما اغضب الولايات المتحدة. وعلى الصعيد السياسي تمّ التقارب مع الجمهورية الاسلامية في إيران بعد أن انقطعت العلاقات لمدة خمسة عقود تقريبا ما يدلّ على أن الرهان الغربي على استمرار الانقسام في غرب آسيا رهان خاسر. ومصر أصبحت أيضا عضوا في منظمة البريكس ما يفتح صفحة علاقات جديدة بعيدة عن المحور الغربي والاميركي. هذه بعض الاجراءات التي تدلّ على أن الحكومات العربية بدأت بمراجعة خياراتها وتحالفاتها وكانت التقارير السياسية السابقة المقدمة للمؤتمر القومي كانت قد أشارت إلى أمكانية حصولها ونشهد اليوم صحّة الاستشراف. اعادة النظر في الخيارات والتحالفات لا تعني بالضرورة القطيعة مع الغرب أو الولايات المتحدة. ومصر ما زالت متمسّكة باتفاقيات كامب دافيد وتزيد من التبادلات التجارية مع الكيان خاصة في قطاع الطاقة حيث اصبحت مصر المنتجة للغاز تستورد الغاز من الكيان! والسؤال يصبح إلى متى؟ فالدول العربية أصبحت بشكل عام تعي أن الغرب يتراجع في العالم وأن موازين القوّة لم تعد لصالحه. فالوتيرة في التغيير ما زالت بطيئة نسبيا لكنها قائمة.
أما في اليمن فقد أشرنا اعلاه الى التحوّل الكبير في ميزان القوّة في الاقليم عبر الموقف المساند والصريح للقضية الفلسطينية والدعم العسكري والسياسي للمقاومة في فلسطين. والمواجهة مع قوى تحالف العدوان في العقد الماضي دون أن يستطيع التحالف التفوّق على اليمن، بل العكس فإن اليمن خرج من تلك المواجهة أقوى سياسيا وعسكريا.
والمواجهة على مدى السنتين الماضيتين مع البحرية الاميركية دون أن تستطيع الاخيرة تغيير موقف اليمن من محاصرة الكيان الصهيوني بحرا وفي تجارته الخارجية ايضا دليل على القفزة النوعية في المكانة الاستراتيجية لليمن عمليا وليس افتراضيا. كما ان تحالفات اليمن مع الجمهورية الاسلامية في إيران والتفاهمات مع روسيا والصين كرّست الدور الاقليمي الصاعد لليمن.
لكن اليمن يواجه تحدّيا من قبل دولة الامارات. فالاخيرة تدعم الحركة الانفصالية في جنوب اليمن كما أنها أقامت حزاما من القواعد البحرية في الجزر اليمينة للسيطرة على خليج عدن وذلك بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكيان المؤقت. لكن هذه السلسلة من القواعد التي هدفها السيطرة على الممرات البحرية لم تردع ولم تمنع اليمن من استهداف السفن المتجّهة إلى مرافئ الكيان المؤقّت. هذه القواعد ستزيد من التوتر وزعزعة الاستقرار في تلك المنطقة وقد تمتد إلى القرن الإفريقي حتى وسط القارة في تنافس إماراتي أميركي صهيوني مع الدور المتنامي للصين وروسيا.
اما في الجزائر فما زالت متمسّكة بخيارها الداعم للقضية الفلسطينية ومدار تحرّكها الفاعل والفعّال هو في القارة الإفريقية في مواجهة تمدّد النفوذ الصهيوني. كما أن اداء الجزائر في الامم المتحدة شكّل سندا كبيرا للقضية ومشاركتها في ادّعاء جنوب إفريقيا على قيادات الكيان المؤقت لارتكابها جرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية يؤكّد دعمها للمقاومة والشعب الفلسطيني. فكون الجزائر بعيدة نسبيا عن ساحة القتال لم يمنعها من خوض معارك دبلوماسية في الامم المتحدة ومؤخّرا في دعم الحركات الانقلابية في الساحل الغربي الافريقي ضد المستعمر القديم الفرنسي. فهذا يندرج في إطار التغيير في المسارات، أي في تراجع الغرب وصعود دول الجنوب الاجمالي.
في المغرب العربي نشهد انفصاما بين خيارات الدولة والحراك الشعبي الداعم لفلسطين. وعند اعداد هذا التقرير نشهد تظاهرات احتجاجية مطلبية من قبيل جيل “زاد” أي جيل الشباب الذي يطلب التغيير في الاداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذه الظاهرة المطلبية تتلازم مع المظاهرات المؤيّدة لفلسطين ما يضع النظام الحاكم امام استحقاقات وخيارات أحلّها مرّ له.
أما العراق فما زال يرزح تحت وطأة النفوذ الاميركي من جرّاء الاحتلال وحالة الانقسام الداخلي. غير أن صعود القوى الشعبية المساندة للمقاومة والمناهضة للاحتلال الاميركي في العراق يفرض على النخب الحاكمة الاخذ بعين الاعتبار ان التجاذبات الاقليمية في الساحة العراقية لن تمنع القوى الشعبية من مساندة القضية الفلسطينية سياسيا وعمليا. لذلك هناك ضرورة متابعة نتائج الانتخابات المقبلة في العراق لمعرفة التوجّهات في المجتمع العراق والخيارات الممكنة والسياسات الناتجة عنها.
ثانيا- الموقف العربي الرسمي من الابادة الجماعية في غزة
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تلك التحوّلات في بعض مواقف الدول العربية انعكست على موقفها من الابادة الجماعية في غزّة على مسمع ومرأى العالم اجمع؟ الاجابة السريعة قد تقول لا لأنه لم يصدر عن الحكومات العربية أي موقف عملي يردع الكيان ويضغط على الغرب وخاصة الولايات المتحدة لوقف الابادة. من الواضح أن الحكومات العربية، وكل لأسبابه الخاصة، فلسطين ليست أولوية بل عنصر ازعاج في استقرار علاقاتها مع الولايات المتحدة. فنظرية تا 99 بالمئة من أوراق اللعبة التي ذُكرت اعلاه هي التي تفسّر “الانزعاج” من المسألة الفلسطينية. وبالتالي، فإن معظم الحكومات العربية لا تناصر المقاومة بل ربما تسعى لإلغائها. فهذه الدول لم تقتنع أن المقاومة قد تكون عنصر قوّة في تفاوضها مع الولايات المتحدة والكيان المؤقّت.
غير أن مواقف الحكومات العربية ومعها معظم حكومات الدول الاسلامية مرّت بتحوّلات لا يمكن تجاهلها وإن لم ترتق لمستوى المواقف الحازمة تجاه ما حصل في غزّة والضفة الغربية. كما أن هذه الحكومات في المرحلة الاخيرة كأنها بدأت تعي خطورة المشروع الصهيوني تحت قيادة زمرة متطرّفة لا تكترث إلى القوانين والمواثيق والمعاهدات وحتى موازين القوّة. فهي ماضية في تحقيق ما تُسميه الدولة اليهودية التي تشمل كل جغرافية فلسطين المحتّلة بل تشمل ايضا كل سورية ولبنان والاردن وشرق نهر النيل والثلت الشمالي للجزيرة العربية. فكيانات هذه الدول مهدّدة بشكل مباشر وصريح في وجودها من قبل العدو الصهيوني.
عقدت الدول العربية والاسلامية منذ بداية “طوفان الاقصى” ثلاث قمم لم تأت بمواقف عملية بل اكتفت بالتنديد وربط الاستقرار ومشاريع التطبيع في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية. وهذه القمم كانت أقلّ سؤا من القمم السابقة التي لم تجعل القضية الفلسطينية محورا اساسيا من اهتماماتها، بل ربما تجاهلتها وحاولت تكريس فكرة العداء للجمهورية الاسلامية في إيران كعدو للدول العربية.
ليس من المؤكّد أن السيطرة على منصّة تيك توك وتوظيف المؤثرين في الولايات المتحدة سيمكّن اللوبي الصهيوني من استعادة نفوذه وتلميع صورة الكيان. فما حصل من الصعب محوه وخاصة عند الجيل الشاب الاميركي الذي يقود الانتفاضة على سياسات الكيان والادارة الاميركية الداعمة له. أضف إلى ذلك هناك مصداقية الادارة على المحك إذا لم تنجح في منع ازمة مالية ضخمة محتملة خلال السنة الانتخابية، فكل الجهود لكبح الرأي المضاد لسياسات الادارة الداعمة للكيان قد تذهب في مهب الريح.
اما بالنسبة للرأي العام العربي فيجب التمييز بين التأييد للقضية الفلسطينية وبين دعم بعض فصائل المقاومة. وهذا التمييز يعكس حالة الحذر في الشارع العربي تجاه من يقود الصراع مع الكيان. لكن ما حصل وما زال يحصل في غزّة ساهم إلى حد كبير في ردم الفجوة بين التأييد للقضية الفلسطينية والفصائل التي تقود المقاومة في غزّة وفلسطين. خيار المقاومة لم يعد موضع شكّ بل تأييد وإن لم يتم التعبير عن ذلك في الشارع العربي. والشارع العربي إن لم يخف في يوم من الايام تعاطفه مع القضية الفلسطينية إلاّ ان موقف الدول العربية بشكل عام تراواح بين العداء المعلن للمقاومة وتحميلها المسؤولية الكاملة لما يحصل من جراّء العمل المقاوم بالنسبة للخسائر البشرية والمادية، وبين التأييد اللفظي للقضية الفلسطينية دون استعمال أي من اوراق القوّة التي يمتلكها النظام الرسمي العربي. والبعض يضع مؤتمر الدول الاسلامية في نفس الخانة من الدعم اللفظي للقضية دون اقرانها بعمل جدّي. لكن التدقيق في مسار هذه القمم العربية والاسلامية قد تشير إلى تحوّلات تُقارب في فقرة لاحقة. هناك بعض الدول العربية كالجزائر واليمن وإلى حدّ ما العراق تدعم المقاومة ومعهم سورية قبل التغيير في النظام السياسي. فالمظاهرات المليونية التي تخرج اسبوعا بعد اسبوع في اليمن وضعت السقف لمدى التحرّك الذي يحظى بالدعم الرسمي والمفقود في الدول العربية.
معركة كسب الرأي العام العالمي ساهمت في تغيير موازين القوة وتعديله من الميل المطلق للكيان إلى نوع من التوازن النسبي في المواجهة في الميدان. فالكيان رغم كل قدراته العسكرية لم يستطع أن يحسم المواجهة مع المقاومة رقم الحصار ورغم ضيق المساحة ورغم الجغرافيا المسطّحة ورغم السكوت العربي خاصة من قبل دول الطوق والجزيرة العربية باستثناء اليمن. لكن بالمقابل لم تستطع المقاومة الحاق الهزيمة البينية العسكرية بالكيان وإن ما تقوم به هو استنزاف قوى العدو وترهّل امكانياته والنيل من معنوياته. الوقت هو لصالح المقاومة أن استطاعت ان توازن بين الكلفة الباهظة الذي يدفعها الغزّاوييون وبين الانجازات الميدانية والسياسية التي تحققها.
ثانيا-التحوّلات داخل الكيان: من بن غوريون إلى مائير كاهان إلى بن غفير وسموتريش
من تبريكات “طوفان الاقصى” والحرب التي تلتها هو كشف مدى التحوّل الذي أصاب الكيان الصهيوني المؤقت. فالكيان اليوم غير الكيان الذي أسسه بن غوريون في 1948 والمجتمع الصهيوني ببنيته العرقية اليوم ليس تلك البنية في الايام الاولى. فالعنصر الشرقي لليهود حلّ مكان العنصر الغربي أو الاشكنازي العلماني. العنصر الشرقي تلمودى الهوى لا يعترف بالقوانين والمواثيق الوضعية بل فقط بتعاليم التلمود الذي هو “تفسير” منحرف للتورات. يمكن القول أن تلك الفئة توازي “داعش” في الاسلام من حيث الانحراف والتوحّش. النخب العربية الحاكمة ما زالت تنظر إلى الكيان كأنه هو هو لم يتغيّر منذ 1948 عندما كان دولة لليهود بينما اليوم أصبح دولة يهودية من المستحيل التساكن والتعايش معها من منظور تلمودي. هذا المنحى للكيان الصهيوني كان قد اطلقه مائير كاهان في السبعينات من القرن الماضي. وكان يُعتبر طرحه على هامش المجتمع الصهيوني بينما اليوم اصبح التفكير والمزاج السائد حيث البشرية يجب أن تخضع لشعب الله المختار وأن القوانين الوضعية الموروثة يجب أحلال مكانها تعاليم التلمود. كما أن جغرافية الكيان المطلوبة لم تعد مقتصرة على فلسطين التاريخية بل أصبحت تشمل كل من لبنان وسورية والاردن والثلث الشمالي من الجزيرة العربية والضفة الشرقية لنهر النيل في مصر. ولم يخف نتنياهو ذلك الطموح بل أعلنه مرارا وتكرارا ونشر خارطة غرب آسيا الجديدة حيث الكيان الصهيوني حلّ مكان الكيانات التي نشات بسبب سايكس بيكو. والغريب أن النخب الحاكمة في الدول العربية المستهدفة من قبل نتنياهو لم تتفاعل مع هذا الطرح وكأنها لم تسمعه أو تعتبره جادا.
فاذا كانت هناك شكوك حول هذا المفهوم الجديد فنشير إلى تصريح الرئيس الاميركي ترمب أن مساحة الكيان صغيرة ويجب أن تتوسع. وللمزيد من الوضوح تولّى المبعوث الاميركي لسورية ولبنان توماس باراك في شرح مسقبل المنطقة حيث على جميع السكان في الاقليم أن يخضعوا بدون قيد أو شرط إلى الحكم الصهيوني. كما أن مفهوم السلام في الاقليم مفهوم يعود إلى ما يحدّده الكيان.
“طوفان الاقصى” فرض على هذه القمم اولوية القضية الفلسطينية وربط كافة مشاريع المعدّة للمنطقة من قبل الغرب وخصوصا من قبل الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية كشرط مسبق لأي “تطبيع”. فكان المسار قبل “الطوفان” التطبيع خارج سياق حلّ قضية الشعب الفلسطيني. إلاّ أن موقف بلاد الحرمين في هذاالاطار كان واضحا ومتكرّرا منذ بداية “طوفان الاقصى” ما اربك الادارة الاميركية في كل من ولاية بايدن وترمب. وما جاء على لسان سموتريش وزير المال في الحكومة الصهيونية أن الكيان لن يقبل التطبيع مع بلاد الحرمين إذا ما أصرّت على إقامة الدولة الفلسطينية يؤكّد مدى المأزق التي وقعت فيه الادارة الاميركية التي تسعى إلى ضمّ بلاد الحرمين إلى الاتفاقيات الابراهيمية. طبعا، هذه المواقف لم توقف الابادة التي استمرّت على يد حكومة الكيان المؤقّت غير مكترثة لمواقف الدول العربية طالما الولايات المتحدة كانت وما زالت داعمة لها، على الأقلّ حتى الساعة. لكن بالمقابل، فإن الابادة في غزّة اصبحت عبئا على الادارة الاميركية الحالية بسبب التحوّلات الداخلية في الرأي العام الاميركي الضاغط والرافض والغاضب لسياسات الادارة تجاه غزّة. الدول العربية صعّدت تدريجيا كلامها تجاه العدو الصهيوني وخاصة بعد العدوان الصهيوني على قطر مستهدفا قيادات حماس المجتمعة لبحث مبادرة الرئيس الاميركي. وكأن مشروع المبادرة كان خديعة لجمع القيادات الفلسطينية في مكان واحد لاستهدافها! هذه ما قد حصل بالنسبة لقيادات المقاومة في لبنان وحتى في الجمهورية الاسلامية في إيران حيث اتبعت الادارة الاميركية خديعة طرح مبادرات للتفاوض إما لتخفيف حدّة المواجهة المقاومة أو لجمع قيادتاها لاستهدافها مرّة واحدة.
الكلام الذي سمعناه في قمّة الدوحة لم نسمعه من قبل. فالرئيس المصري يعتبر الكيان الصهيوني عدوّا رغم وجود معاهدة سلام معه. هناك من اعتبر هذا الكلام هو فقط لإرضاء الشارع المصري الغاضب لعجز أو رفض الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مادية لوقف الابادة ونصرة غزة وبالتالي فلا يجب البناء عليه. هذا افتراء لأن هناك سلسلة اجراءات اتخذتها الحكومة المصرية اقلقت وما زالت تقلق الكيان والولايات المتحدة وهي في تموضع القوّات المصرية في سيناء خارج سياق اتفاقيات كامب دافيد ونشر منظومات صواريخ للدفاع الجوّي. ولا يجب اغفال الموقف الواضح والصارم الرافض لتهجير الغزّاويين إلى سيناء بغض النظر عن الدوافع لذلك الرفض. فجزء كبير من المخطط الصهيواميركي في غزة استند إلى إمكانية التهجير فاصطدم بالرفض المصري القاطع. كما أن الرئيس المصري اقترح انشاء قوّة عربية مشتركة لمواجهة اطماع العضو. وهذه نقلة نوعية لأن المقتراحات السابقة لتشكيل قوّة عربية مشتركة كانت لمواجهة الجمهورية الاسلامية في إيران. العدوان على الجمهورية الاسلامية من قبل الكيان المؤقّت والادارة الاميركية اوجد مصطلحات في الخطاب السياسي في بلاد الحرمين لم تكن موجودة بل كانت مستبعدة كاعتبار العدوان على ايران عدوانا على دولة “شقيقة”. فجأة لم تعد الجمهورية الاسلامية في إيران العدو بل دولة شقيقة والكيان اصبح هو العدو! هذه تحوّلات مهمّة جدّا في السياسة لكنها لم تترجم على الارض بسبب تعقيدات المشهد والمصالح الكبيرة المرتبطة بالولايات المتحدة على صعيد الدول وعلى صعيد المصالح الخاصة للحكّام.
لكن هذا الكلام الجديد تلازم مع مرونة كبيرة تجاه الرئيس الاميركي لأسباب عدة. السبب الاول قد يكون المصالح الذاتية والحسابات السياسية للحكّام العرب. السبب الثاني، هو ان الدول العربية التي تفاوضت مع الرئيس الاميركي وجدت أنه أكثر تحرّرا من الرؤوساء السابقين من التبعية للكيان وحكومة نتنياهو. فالضغوط التي مارسها الرئيس الاميركي على نتنياهو تمثّلت بانذار له خاصة بعد العدوان على قطر. فهذا العدوان كاد يطّير أي امكانية للتطبيع وللمشروع الاميركي للمنطقة. ولن يسمح الرئيس الاميركي لرئيس وزراء الكيان ان ينسف مشاريعه في المنطقة بدءا من الاتفاقات الابراهيمية إلى تشكيل كتلة اقتصادية سياسية تستطيع ردع التقدّم الروسي والصيني. أما السبب الثالث للمرونة العربية هو اعتراف الرئيس الاميركي ان المزاج الداخلي في الولايات المتحدة لم يعد لصالح الكيان وخاصة داخل الحزب الجمهوري الذي كان يراهن عليه نتنياهو، وخاصة من بين الشباب في القاعدة الانجيلية المتصهينة. فهذه الاعتبارات جعلت الحكومات العربية التي تفاوضت مع الرئيس الاميركي تتجاوز التغييرات التي ادخلها نتيناهو على ما تمّ الاتفاق عليه، خاصة أن الاتفاق أوقف أولا القصف على غزّة، وثانيا، أدى إلى وقف التهجير، وثالثا اعاد طرح قضية الدولة الفلسطينية وإن كانت خطّة تنفيذ ذلك غامضة. فهذه “مكاسب” اعتبرتها الحكومات العربية المطبّعة والمفاوضة مع الولايات المتحدة يسمح لها بتسجيل نقاط في مواجهة الكيان. لكن السؤال هل هذه الرهنات ستصمد؟
العبرة ستكون في مواقف وسلوك الحكومات العربية وخاصة بلاد الحرمين ومصر في المستقبل المنظور فيما يتعلّق بالتطوّرات المحتملة في غرب آسيا كعدوان جديد إما على الجمهورية الاسلامية في إيران أو على لبنان أو على اليمن أو على العراق بعد التصريحات الاستعراضية للرئيس الاميركي بأنه “أوجد السلام”. كما أن سلوك الدول العربية في تعاملها مع القضية الفلسطينية هو رهن إقتناعها أن الكيان الصهيوني كما هو الآن ليس معنيا لا بالتطبيع ولا بالسلام بل بالسيطرة المطلقة على مقدّرات المنطقة. هذا هو أحد مغازي العدوان على قطر التي لم تكن الحكومات العربية للتوقّع أنها ستستهدف من قبل الكيان المؤقّت. وكما تمّت الاشارة إليه اعلاه فإن المصالح المالية الضخمة للدول العربية وخاصة دول الجزيرة العربية قد تحول دون اتخاذ اجراءات صادمة تجاه الكيان على الاقل في المرحلة الحالية التي قد تتغيّر بشكل سريع بسبب التغيير في موازين القوّة وخاصة بالنسبة للتطوّرات في المشهد الداخلي الاميركي.
ثالثا- الموقف من التطبيع
مقاربة التطبيع تكون على مستوى محورين مختلفين. المحور الاول هو محور الحكومات العربية وهنا يجب التمييز بين الدوّل المطبّعة والدول “المرشّحة للتطبيع إذا ما سمحت الظروف المحلّية” كما جاء على لسان الرئيس الاميركي في رسالة لولي العهد في بلاد الحرمين محمد بي سلمان. أما المحور الثاني فهو محور الجماهير العربي.
المستوى الاوّل
فبالنسبة للمحور الرسمي العربي فإن التطبيع الذي فّرض في ظروف موضوعية محدّدة كظرف كامب دافيد ووادي عربة واتفايات اوسلو وفيما بعد السودان ودولة الامارات والبحرين والمغرب، فهذا التطبيع يواجه تساؤلات حول “المنفعة” السياسية والاقتصادية وقبل كل ذلك “الحماية” الاميركية لهذه الحكومات. في السنوات السابقة اقام المؤتمر القومي العربي سلسلة مؤتمرات وندوات حول التطبيع قُدّمت فيها أوراق تجرد المكاسب، إن وجدت، لدول المطبّعة. فالمنفعة كانت احادية الاتجاه أي لصالح الكيان الصهيوني وأن وعود “السلام” بالرخاء والازدهار الاقتصاد لم تتحقق فحسب بل تدهورت الاوضاع الاقتصادية في كل من مصر والاردن. اما السودان فما زال يرزح تحت وطأة الحرب الداخلية التي تغذّيها بعض الدول الخليجية. وفي دول الخليج المطبّعة فهناك هجمة من الكيان الصهيوني عليها لم يغيّر أي شيء في بنيتها الاقتصادية بل زادت من حدّة النفور بين الوافدين الصهاينة واهل تلك الدول.
أما “الجائزة الكبرى” التي يبنى عليها كل من الادارة الاميركية والكيان المؤقّت فهي استدراج بلاد الحرمين إلى التطبيع. وخطّة بايدن لطريق اقتصادي يربط الهند بالكيان الصهيوني عبر الجزيرة العربية أجهضه “طوفان الاقصى” كما دفع بلاد الحرمين على ربط أي تطبيع مستقبلي بحل القضية الفلسطينية وخاصة في إقامة دولة فلسطينية رغم المحاولات الاميركية والصهيونية لفصل التطبيع عن حلّ القضية. المسألة تعود في آخر المطاف إلى تقدير موازين القوّة عند الاطراف المعنية. فالتطبيع هو هدف أميركي قبل أن يكون هدفا صهيونيا لآن ذلك الهدف هو إقامة كتلة جغرافية اقتصادية سياسية في مواجهة الكتلة الاوراسية التي تضمّ كل من الصين وروسيا والجمهورية الاسلامية في إيران. التطبيع حاجة أميركية أولاّ وأخيرا تحت راية “السلام والاستقرار” في المنطقة. موازين القوّة لا تسمح بذلك خاصة مع تراجع القدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الاميركية أمام التقدّم الاقتصادي والعسكري والسياسي للكتلة الاوراسية وما يدور في فلكها في دول الجنوب الاجمالي. الدول العربية تدرك التغيير في موازين القوّة ولذلك أقدمت على خطوات لا ترضى عنها الولايات المتحدة ذكرت اعلاه.
المستوى الثاني
المستوى الثاني لمقاربة التطبيع هي على مستوى الجماهير العربية التي كانت وما زالت رافضة للتطبيع. والعدو الصهيوني فشل في أجراء أي تغيير في المزاج الشعبي تجاهه رغم ضخ الاموال في المنصّات ووسائل التواصل والاعلام المموّلة من جهات خليجية لخلق مزاج ايجابي تجاه الكيان. وكما اشار التقرير فإن المظاهرة الشعبية التي حصل خلال مباريات كأس العالم في قطر في 2022 شكّلت هزيمة مدوية للكيان ولمروّجي التطبيع معه. ومناهضة التطبيع بدأت منذ اللحظات الاولى لاتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني التي لم تترجم إلى قبول شعبي للعلاقة مع الكيان. وعلى مدى العقود الماضية وخاصة في السنوات العشرة الماضية كانت حركة القوى الشعبية المناهضة للتطبيع ناشطة في معظم أقطار الامة. التنسيقيات القطرية لمناهضة التطبيع ناشطة وتحظى بدعم مكوّنات التيّارات السياسية. فالكتلة التاريخية محقّقة في مجال مكافحة التطبيع. هنا لا بد من الاشارة إلى دور مكوّنات المؤتمر العربي العام كالمؤتمرالقومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والجبهة التقدّمية العربية ومؤسسة القدس ومؤتمر الاحزاب العربية في دعم المبادرات من مؤتمرات وندوات عربية ودولية لمواجهة التطبيع.
ومناهضة التطبيع كانت له نتائج ملموسة خاصة فيما يتعلّق بمقاطعة البضائع الاميركية التي تنتجها شركات تدعم الكيان الصهيوني أو تعمل فيه. وتراجع المبيعات في شركات كبيرة كمكدونالت وستاربكس في عدد من الدول العربية دليل على ذلك وينقض زعم المطبّعين ان لا جدوى من المقاطعة. واليوم تعمل التنسيقيات على دعم مقاطعة الكيان ليس في البضائع فحسب بل في كل المجالات الثقافية والجامعية والرياضية خاصة في الدول الاوروبية التي تستجيب لتلك المقاطعة. فالمقاطعة هي ترجمة مادية لمواجهة التطبيع التي تحاول بعض الحكومات ترويجه ولكنها تصطدم بالغضب الشعبي. وبما أن موازين القوة في العالم تتغيّر لصالح القوى المناهضة للغرب وللصهيونية في دول كانت محسوبة كمعاقل للكيان الصهيوني فإن سقوط التطبيع في الوطن العربي أصبح مسألة متى وليس مسألة إذا.
رابعا- التحوّلات في المشهد السوري
التحوّل الكبير الذي حصل في المعادلة الإقليمية وخاصة في جبهة المقاومة هو خروج سورية من المعادلة بعد رحيل نظام الاسد وإحلال مكانه نظام جديد. ليس هدف التقرير مقاربة اسباب التغيير بل مقاربة المشهد القائم وما يمكن أن يحصل على ضوء التجاذبات الاقليمية والدولية القائمة في وحول سورية.
في البداية كان هناك ترحيب في سورية للتغيير لاعتبارات مذهبية لا داعي الخوض فيها. ولكن كان هناك تغييب في الإدراك لخطورة ما حصل والتهديد الوجودي لسورية كدولة صاحبة سيادة وتاريخ ودور. فالطامعون الإقليميون بسورية هدفهم الرئيسي هو استهداف السيادة والتاريخ والدور العربي والاقليمي الذي قامت به سورية على مدى العقود السبعة التي تلت الحرب العالمية الثانية. فتغلّب النزعة المذهبية على الوعي الوطني والقومي كان خسارة لجبهة المقاومة في مواجهة الكيان المؤقت وأطماع كل من الولايات المتحدة تركيا في جغرافيا سورية. في هذا السياق كان هناك اجماع ان الرابحين في التغيير الذي حصل هم كل من الكيان المؤقت وتركيا والولايات المتحدة وإلى حدّ ما بعض الدول في الخليج العربي. واعتبر الكثيرون أن الاطراف الدولية ستتقاسم سورية مع مشاركة عربية تغطّى المشهد الجديد.
غير أن واقع الحال هو أن التغيير الذي حصل أظهر على السطح التناقضات الجوهرية بين “الرابحين” من رحيل النظام حيث الاجندات الخاصة بهم تصطدم بشكل مباشر وصريح مع بعضها بعض. اهم التناقضات هي بين اجندة الكيان الصهيوني المؤقت والاجندة التركية. فإذا كانت الاجندة التركية تسعى إلى الحفاظ على الجغرافية السورية موحّدة ولكن تحت سيطرتها فإن اجندة الكيان تسعى إلى سورية مقسّمة ضعيفة منزوعة السلاح. هذا هو مغزى العدوان على المنشئات السورية السياسية والعسكرية وخاصة استهداف مقرّ الرئاسة ووزارة الدفاع. الاعتبارات الامنية هي واجهة التوسّع الصهيوني في الاراضي السورية بينما الاجندة التركية تسعى إلى استعادة دور وبريق السلطنة العثمانية. إما الاجندة الاميركية فعينها على حقول النفط السورية والحفاظ على وجود ما عبر دعم الحالة الكردية. أما اجندة الهيئة الجديدة الحاكمة في دمشق فما زالت غامضة لكنها تسعى للحصول على شرعية ودعم دولي. والمشهد الاقتصادي في حالة سيئة قسوى وامكانية ضبط مكوّنات السلطة من انفلات امني ليست واضحة. فاحداث الساحل السوري والسويدا تدلّ على ان السلطة المركزية عاجزة عن الحفاظ على مكوّنات المجتمع السوري المتنوّع. القلق الذي يسود المجتمع السوري مشروع لكن ليس في الافق ما يمكن أن يُعدّل المشهد. وطالما كان الاعتبار الطائفي والمذهبي هو ما يتحكّم بكافة مكوّنات سورية فإن الجرح الذي أصاب ذلك النسيج لن يشف بشكل سريع، هذا أذا كان الشفاء ممكنا. والحلّ الوحيد هو العودة إلى خطاب وطني تحت مظلّة قومية عربية تنسجم مع تاريخ ودور سورية. الخطاب الفئوي آفاقه مسدودة ولن يؤدّي إلاّ إلى التجزئة والضعف والزوال.
الكيان الصهيوني يسعى إلى إبرام اتفاقيات امنية مع سورية تجعل فيها الاجواء السورية مفتوحة للطيران الحربي الصهيوني. هذا يعني أقصاء أي دور لتركيا. فالسؤال هو هل ستقبل تركيا بذلك الوضع وهل ستصطدم عسكريا مع الكيان؟ من جهة أخرى، اذا نجح الكيان في إبرام تلك الاتفاقات فماذا يمنع أن يستهدف الاردن أولا كمركز لتهجير الفلسطينيين من الضفة وثانيا من ضم الاردن ضمن رؤية “اسرائيل الكبرى” التي يُبشّر بها رئيس وزراء الكيان؟ عند ذلك الحين، أليس الامن القومي لبلاد الحرمين مستهدفا بشكل مباشر من قبل الكيان، وأين “ألحماية” الاميركية؟ لذلك إن توقيع أي اتفاقية بين سورية والكيان يتطلّب موافقة كل من تركيا وبلاد الحرمين. لذلك من الصعب التوقّع أن هذا سيحصل ما يعنى أن الكيان سيعود إلى الضغط العسكري على السلطة القائمة في دمشق التي قد لا تستطيع الصمود. فهل توافق الولايات المتحدة على فوضى جديدة لا يستطيع أحد ضبط إيقاعها لتضارب المصالح؟
ولا يجب ان يغيب عن البال ان لكل من روسيا والجمهورية الاسلامية في إيران مصالح في سورية وأن التسرّع في اعتبارهما خارج الخارطة السياسية الجديدة في سورية امر غير دقيق. فهناك محادثات جارية بين النظام الجديد وروسيا وأيضا مع ايران. لذلك الترقّب هو ضرورة في المرحلة الرهنة قبل ان تنجلي الامور بشكل واضح والذي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار مزاج الشعب في سورية.
فالاجندات المشبوهة لتلك الاطراف الدولية تصطدم مع يقين الشعب السوري. فوفقا لاستطلاعات “المؤشر العربي” التابع للمركز العربي للابحاث ودراسة السياسات” في قطر فإن 78 بالمئة من السوريين يرون أن الكيان الصهيوني المؤقّت أكثر تهديدا للمنطقة العربية وأن 74 بالمئة يرفضون الاعتراف بالكيان. كما أن 75 بالمئة يعتبرون أن الامة العربية واحدة و70 بالمئة لا يريدون أي تسوية مع الكيان. وهناك 65 بالمئة يعتبرون أن القضية الفلسطينية قضية العرب. من جهة اخرى هناك 70 بالمئة يعتبرون أن الكيان المؤقّت يتدخل في الشأن السورية ويدعم فئة ضد الفئات الاخرى. فهذه الاحصائيات تعكس نفس سورية وتاريخها وأن المستقبل لا يمكن أن يرسمة الكيان أو تركيا أو الولايات المتحدة. لكن حتى الساعة وعند اعداد هذا التقرير لم يلح بالافق من هي الجهة التي ستقود الانتفاضة على الوضع القائم. والجدير بالذكر هو أن تقاعس الدول المانحة، عربيا ودوليا، في توفير الاستثمارات والمساعدات المالية ستساعد على الاطاحة بنظام لم يقدّم أي شيء سواء تغيير هوية مذهب الحاكم.
خامسا- السودان: حرب الهيمنة والإخضاع
دخلت الحرب المفروضة على السودان، والرامية إلى إخضاعه وبسط النفوذ الغربي – الصهيوني عليه، عامها الثالث. وقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين السابقتين والحالية للمؤتمر تطوراتٍ مهمة في ملف الحرب، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولاً: التطور في مسرح العمليات الميدانية
تمكن الجيش السوداني، بمساندة المقاومة الشعبية والقوات المشتركة، من تحقيق تقدم عسكري نوعي، نتج عنه تحرير ولاية الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار، كما تمكن من الحفاظ على مدن رئيسة من السقوط في يد مليشيا الدعم السريع في إقليم كردفان مثل الأبيض وبابنوسة ، ويسعي لتحرير بقيةالمدن في هذا الإقليم ، بينما تتركز عمليات الجيش لتحرير مدن إقليم دارفور خاصة بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع على مدينة االفاشر بعد عمليات هجومية استمرت زهاء ما يقارب العامين وقد شنت قوات الدعم السريع 267 هجوما من كل الاتجاهات خلال الفترة الماضية علي المدينة مما اضطر الجيش لتجنيب مآل التدمير الكامل الخروج منها وقد فرض عليى الفاشر حصاراً محكماً استمر لنحو عام ونصف، و استعانت المليشيا بالدعم الخارجي من عتاد حربي وسلاح بجانب المرتزقة من أمريكا الجنوبية وافريقيا ومن شرق ليبيا لاسقاط مدينة الفاشر واستكمال حلقات السيطرة على دارفور بشكل كامل تمهيداً لإعلان دولة منفصلة.
ارتكبت قوات مليشيا الدعم السريع جرائم حرب بشعة وانتهاكات شنيعة ضد مواطني الفاشر وقتل خلال يومي 27-28اكتوبر 2025م ما زيد عن 4000 الف من الأبرياء المدنيين العزل اغلبهم من النساء والأطفال وهم يفرون من المدينة ، وقد ادانت الحكومات العربية والغربية هذه الجرائم بجانب ادانات من الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية ، كما اعتقلت واختطفت ما يربو عن الخمسة الف من المواطنيين من سكان الفاشر .
من التطورات المهمة هو قدرة الجيش السوداني الي نقل المعارك وحصرها في نطاق ولايات دارفور وأجزاء من غرب وشمال كردفان ، بعد كانت المليشيا تتواجد في العاصمة وولايات الوسط وتهدد ولايات الشمال .
حققت الحكومة السودانية تقدماً مهماً في إعادة بعض الخدمات إلى المناطق التي تم إجلاء مليشيا الدعم السريع منها ( ولايات الخرطوم – الجزيرة – سنار شمال النيل الأبيض )، الأمر الذي يسّر عودة نحو (13) مليون نازح ولاجئ إليها، وهو ما يُبشّر بعودة طوعية للسكان الأصليين إلى مواطنهم التي طردتهم منها المليشيا.
نشطت مليشيا الدعم السريع خلال هذا العام في استخدام الطائرات المسيّرة التي وستهدف المراكز الخدمية محطات إنتاج الكهرباء والمياه، والمطارات، والمستشفيات، ودور العبادة، والأسواق، مما أدى إلى زيادة حجم دمار البنى التحتية وتفاقم معاناة المواطنين.
خلال فترة حصار مدينة الفاشر من جميع الاتجاهات، منعت المليشيا دخول الغذاء والدواء والوقود وبقية المساعدات الإنسانية ، ما أدى إلى تدهور أوضاع سكان المدينة البالغ عددهم نحو (900) ألف نسمة. واضطر السكان إلى تناول أعلاف الحيوانات بعد نفاد الغذاء، ويعيشون أوضاعاً إنسانية تشبه إلى حد كبير ما يعيشه سكان غزة من حيث انعدام مقومات الحياة واستمرار القصف اليومي.
وقد نزحوا الان الى مناطق اخري تركين مدينتهم وهروباً من القتل الجماعى ، ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراراً في 13 يونيو 2024 بفك الحصار عن المدينة وإغاثة سكانها وسحب القوات التي تطوقها، إلا أن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بتنفيذه، كما لم يتخذ المجلس أي إجراء يوفر احتياجات السكان المحاصرين، الأمر الذي وفر الغطاء السياسي الخارجي لاجتياح الفاشر واحتلالها..
توسّع إمداد دولة الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع بالعتاد العسكري وبالمرتزقة من دول متعددة، من بينها كولومبيا، حيث اعترف رئيسها بمشاركة بعض مواطنيه في القتال ضمن صفوف المليشيا وقدم اعتذاراً رسمياً للسودان. كما وفرت أبوظبي طرق إمداد من بعض دول جوار السودان مثل تشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا، إضافة إلى شرق ليبيا، واستخدمت قاعدتها العسكرية في بونتلاند الصومال غير المعترف بها دولياً كمحطة وسيطة لنقل العتاد والمرتزقة.
ثانياً: التطورات السياسية والدبلوماسية
وظّفت الإمارات علاقاتها مع كينيا في خدمة مشروع الحرب في السودان، واتخذت من العاصمة الكينية نيروبي منصة للعمل السياسي الخاص بمليشيا الدعم السريع والمجموعات السياسية المتحالفة معها (تحالف الحرية والتغيير/ صمود وتأسيس). وقد أسهم ذلك في إعادة تنظيم العمل السياسي للمليشيا عبر آليتين:
تحالف صمود، المكلّف بأدوار سياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي.
تحالف تأسيس، المعني بتوفير الغطاء السياسي للحكومة الموازية داخل دارفور وفي عموم السودان.
شكّلت مليشيا الدعم السريع وحلفاؤها حكومة موازية للحكومة المعترف بها دولياً، في استنساخ لتجربة إنشاء حكومتين في ليبيا، وذلك في فبراير/شباط من هذا العام، واتخذت من مدينة نيالا في دارفور عاصمةً ومقراً لها. ويشير هذا التطور إلى دخول مشروع تقسيم السودان، الذي ترعاه قوى دولية وإقليمية داعمة للمليشيا، مرحلة التنفيذ العملي.
أعادت المنظومة الغربية، ممثَّلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تشكيل الآلية الرباعية التي تسببت بشكل مباشر في إشعال الحرب، بعد أن تنازلت بريطانيا عن مقعدها لمصر، لتنضم الأخيرة إلى كل من أمريكا والإمارات والسعودية. وسعت هذه الدول إلى إعادة تشكيل المشهد السوداني من خلال الإبقاء على مليشيا الدعم السريع كعنصر فاعل في الحاضر والمستقبل، وإنقاذها من الفناء، وتمكين المجموعات السياسية المتحالفة مع الغرب (تحالف الحرية والتغيير في طوريه: صمود وتأسيس) من مفاصل السلطة في السودان، مع استبعاد القوى السياسية المناهضة للمشروع الغربي ذي الطابع الاستعماري.
وقد دعم الاتحاد الأوروبي مساعي الرباعية، في مشهد يعكس وحدة الموقف الغربي تجاه الأوضاع في السودان، إلا أن هذه المواقف والمخططات قوبلت برفض واسع من القوى الوطنية والحكومة السودانية.
وبسبب هذا الرفض، فتحت الولايات المتحدة الأمريكية خطاً مباشراً للتواصل مع الحكومة السودانية، بدأ بلقاء جمع مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسعد بولس، برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في سويسرا في أيلول/سبتمبر الماضي، تلاه انطلاق مباحثات ثنائية بين البلدين في واشنطن. في الاسبوع الثالث من الشهر الماضي.
وتتناول هذه المباحثات قضايا متعددة، منها:
العلاقات الثنائية، بما في ذلك تأكيد النفوذ الأمريكي على السودان والاستئثار بموقعه وموارده الاقتصادية، ولا سيما الموارد المعدنية وموارد الطاقة والزراعة والساحل السوداني على البحر الأحمر.
العلاقات السودانية الإماراتية، باعتبار الإمارات شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة ومكلفة بتمثيل مصالحها وتوجهاتها في إفريقيا والشرق الأوسط.
أمن “إسرائيل” والتطبيع
العلاقات السودانية مع كل من روسيا والصين وإيران
ووقف الحرب، إضافة إلى إعادة تشكيل السلطة في السودان.
التشديد على اقصاء التيار الوطني الإسلامي من المشهد السياسي بالكامل في السودان.
ثالثاً: تحديات ومهددات السودان والأمن القومي العربي
يتضح من خلال هذه المعطيات مدى خطورة الأوضاع في السودان، وما تكشفه من حجم التحديات الجسيمة التي تواجهه وتستهدف وجوده واستقلاله الوطني وموارده وموقعه الجيوسياسي، وهو ما يشكّل تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن القومي العربي عامة، وللأمن القومي المصري خاصة.
وتفرض هذه الأوضاع على مصر اتخاذ خطوات حاسمة في دعم السودان ومؤسسات دولته، ولا سيما المؤسسة العسكرية التي تمثل الضامن الرئيس لبقاء الدولة السودانية واستقرارها. كما يتطلب الموقف المصري الجديد تحرّراً من الضغوط الممارسة عليها عربياً من قِبَل أبوظبي، ودولياً من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن أمن مصر مرتبط عضوياً بأمن السودان ووحدته واستقلاله.
وفي السياق ذاته، تُملي هذه المعطيات على النخب والشعوب العربية ضرورة توفير أوسع وأقوى دعم ممكن للسودان في مواجهته لهذه المخاطر الجسيمة التي يتصدى لها منفرداً.
يتطلب الموقف الضغط على الحكومات العربية لاتخاذ مواقف اقوي تجاه محاولات فرض الامر الواقع على السودان والمضي قدما في مخطط تقسيمه ولن تكون دارفور هي المحطة الأخيرة .
اتخاذ مواقف حاسمة من الحكومة الموازية وتحذير الدول العربية والإسلامية والافريقية وبقية دول العالم من خطر التبعيض وتقسيم الدول والسيطرة على مواردها ومكافأة المليشيات المتمردة بدمجها في السلطة .
وتقتضي الأوضاع الحالية في السودان تكثيف الاتصالات وحملات التوعية الشعبية وتحريك الجماهير العربية عبر الأحزاب والمنظمات والهيئات الشعبية والتيارات النقابية للتنبيه بأبعاد ومرامي المشروع الصهيوني الغربي المستهدفة الامة وكياناتها القائمة .
تنسيق الجهود مع التنظيمات والقوى السياسية والتجمعات الدولية الشعبية الفاعلة لاطلاق اكبر حملة سياسية وحقوقية ضد ما يجري في السودان من مؤامرات ، إعداد كتاب اسود بعدة لغات حول هذا الموضوع الخطير وهو سابقة ستكرر في عديد البلدان .
سادسا- الشارع العربي: اسباب ضعف الحراك الشعبي
إذا كان “طوفان الاقصى” قد جرف معادلات أقليمية ودولية، وأذا جرف مفاهيم سياسية واخلاقية كان يروّجها الغرب، وإذا أجهض مشاريع أقليمية ودولية تضع الامة العربية تحت وصايات غربية وصهيونية فإن “الطوفان” طرح إشكالية الشارع العربي الذي تحرّك دعما له ولكن بوتائر وأشكال مختلفة أوجدت قناعة عند العديد من المناصرين لفلسطين أن ذلك الشارع لم يتحرّك بالشكل المطلوب. فهناك مروحة واسعة في تهمة عدم التحرّك أقصاها عدم التحرّك المطلق وأقلّها التحرّك النسبي والمحدود وغير الفعّال. وتتناقل تلك التهم دون التدقيق في يقين هذا الموضوع لأن ربما التحصّن المعنوي والمعلومات لدى تلك الفئات المنتقدة ليس كافيا ولا يصمد أمام السيل من حملات التضليل والتحقير بالجماهيرة العربية.
الجماهير العربية تحرّكت وبنسب متفاوتة. فاليمن أعطى اعلى مستويات التحرّك وذلك منذ ما قبل “طوفان الاقصى” وفي ذروة العدوان عليه من قبل التحالف العربي الدولي. وخلال “الطوفان” كانت الجماهير المليونية تملؤ الساحات اليمنية. أما في المغرب، فكانت المظاهرات المليونية لمناهضة التطبيع قبل “الطوفان” وفيما بعد لنصرة غزّة. وفي عمّان ومدن الاردن كانت أيضا مظاهرات كبيرة تأييدا لغزّة وإن لم تكن بمستوى ما حصل في اليمن. التغطية الاعلامية للحراك اليمني والمغربي والاردنى لم تكن لتعكس ضخامة الحراك. اما في سائر الدول العربية فكانت مظاهرات متقطّعة وأقلّ حجما.
من جهة اخرى فإن المقاومة بفلسطين ولبنان والعراق واليمن مقاومة شعبية أولا وأخيرا. وهي ولدت من رحم الشعب وليس من رحم النخب الحاكمة أو المتحكّمة. وبقاؤها رغم كل الهجوم عليها يعود لأن شرائح وازنة للشعب في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن تحتضن المقاومة والإّ لما استطاعت الصمود. والعلاقة بين هذه الجماهير والمقاومة علاقة عضوية متطوّرة وصلت إلى مرحلة أن الجماهير التي تحتضن المقاومة أصبحت متقدّمة على المقاومة. وبالتالي تعطي هذه العلاقة حصانة لقيادات المقاومة إذا ما فرضت الظروف عليها ممارسة المرونة في التكتيكات والصلابة في الثوابت. وهذه العلاقة الفريدة لم تكن لتحصل لولا نوعية القيادات ومناقبيتها التي أعطتها المصداقية في بيئاتها الحاضنة. وبسبب هذه العلاقة استطاعت قيادات المقاومة ابراز تلك البراعة في إدارة المواجهة والمفاوضات مع العدو والولايات المتحدة وحتى مع الدول العربية التي تمارس الضغوط عليها.
هذا يدفعنا لمقاربة اسباب الضعف النسبي وليس غياب الشارع العربي كما يروّجه البعض. في الحقيقة، هناك عدّة اسباب طرحها كثيرون من المهتمّين بشأن الشارع العربي. اولى الاسباب التي يجمع عليها الكثيرون من المثقفين المتغرّبين الذي يسعون إلى قيادة تلك الجماهير هي حالة القمع الموجودة في الدول العربية. لكن هناك رأي آخر يعتبر أن حالة القمع لا تُفسّر إلاّ جزئيا البرودة في الحراك الشعبي. ففي الخمسينات والستينات حتى منتصف السبعينات كانت الجماهير تتحرّك في غياب الانظمة الديمقراطية التي يسعى إليها عدد من المثقّفين المتغرّبين. ويمكن لفت النظر أن في الغرب، في تلك الانظمة التي تتدّعي الديمقراطية، هناك تشريعات تُجرّم مساندة فلسطين وانتقاد الكيان. هذا لم يمنع تلك الجماهير من التظاهر بأحجام ملفتة للنظر أجبرت النخب الحاكمة في الدول الغربية وبما فيها الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار مواقف الجماهير وإن لم تقدم إلاّ في بعد الحالات على اتخاذ إجراءات ردعية بحق الكيان المؤقّت. فمستوى الوعي والالتزام بالقيم الاخلاقية اقوى من الالتزام بمشيئة الحكّام وبالتالي كان الخروج إلى الشارع. وإذا سلّمنا جدلا ان القمع السلطوي هو العائق امام التحرّك فالمعادلة تصبح بين ما يحدث من ابادة في غزة وقساوة الممكنة للحكومات العربية. القمع الحكومي لا يرتقي ككلفة لمن يريد نصرة الشعب الفلسطيني وإيقاف الابادة.
هذه المعادلة هي سقوط اخلاقي وغياب الجرأة في مواجهة الواقع السياسي في الدولة القامعة.
إذا، إن لم يكن القمع هو السبب الرئيسي للبرودة النسبية للحراك الشعبي العربي فما هي الاسباب الاخرى التي قد تساهم في فهمها. اذا سلّمنا أن الجماهير العربية متعاطفة بالفطرة مع القضية الفلسطينية والمقاومة فهذه الجماهير بحاجة إلى من يقودها. وقيادة الجماهير هي مسؤولية الاحزاب والمؤسسات الشعبية والنقابية أو ما يعتبره البعض المجتمع المدني الذين يشكّلون متن الحياة السياسية في الوطن العربي، هذا إن كانت هناك حياة سياسية قائمة في الاقطار العربية. فما قيمة الانتخابات إذا كانت المشاركة الشعبية متدنّية جدّا كما حصل في عدد من الدول العربية التي أجرت مثل تلك الانتخابات؟ فعدم اقدام الاحزاب وكافة القوى على تحمّل مسؤولية قيادة الجماهير تعود إلى فقدان المصداقية عند القيادات السياسية لدى الجماهير وذلك لعدّة اسباب. وفقدان هذه المصداقية هو انعكاس للحالة الحكومية العربية خاصة فيما يتعلّق بالانقسام والتجزئة. فالسبب الاول في الانقسام والتجزئة أو حتى الشرذمة هو الحسابات الضيّقة والذاتية التي تتحكّم في سلوك تلك القيادات في الحكومات كما في المجتمع. فهناك قيادات هدفها العلاقة مع السلطة او العمل للوصول إليها وبالتالي لن تقدم على أي خطوة قد تهدّد تلك العلاقة او الهدف. والذاتية هي عدم قدرة على وضع الاولويات في إطارها الصحيح، بل التركيز على ما يمكن الاضاءة على مصالح تلك القيادات، او التركيز على التنافس . فالاولوبة التي كان يجب أن تكون هي وحدة القوى في مواجهة التحدّيات الداخلية والخارجية. هذا يأخذنا إلى السبب ثالث، حيث الاولوية عند هذه القيادات ليست القضية القومية بل قضايا لا تُغضب الحاكم. هناك تسليم ضمني أن القطر والحكومة القطرية هو سقف الحراك السياسي المسموح به وليس هناك قدرة أو رغبة في دفع الثمن لتغيير ذلك. هذا الضعف في التمسّك بالقضية القومية والهوية القومية هو في رأينا احد الاسباب الرئيسية لفقدان المصداقية لهذه النخب. فإذا كانت تلك النخب تحسب الف حساب في طرح القضية القومية فلماذا الاستغراب في “برودة” الشارع العربي؟ بالمناسبة، النخب العربية في الخارج ما زالت محافظة ومتمسّكة بهويتها القومية وشاركت وقادت حراكا جماهيريا في الشوارع الغربية ما يعني أن التحرّك الشعبي في الوطن العربي بحاجة إلى السردية القومية للتحرّك.
هذه الاسباب ليست من الخيال بل من التجربة التي راقفت المؤتمر القومي العربي منذ نشأته في مطلع التسعينات من القرن الماضي. حاول المؤسسون عبر العقود الماضية الحفاظ على استقلالية القرار والخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبنّي المشروع النهضوى العربي وخيار المقاومة في وجه الاحتلال سواء كان صهيونيا أو أميركيا أو غير ذلك. وقد نجحوا بذلك رغم الجهود التي بذلتها الحكومات والقوى التابعة لها داخل المؤتمر وخارج المؤتمر لتقويض تلك الاستقلالية. لم تفلح وبالتالي كانت محاصرة المؤتمر من قبل تلك القوى حتى الساعة، أي لم تكن محصورة من قبل الدول العربية أو الإقليمية بل أيضا بنسب متفاوتة من قبل بعض المكوّنات السياسية الوازنة في الوطن العربي والمتواجدة داخل المؤتمر. فالاجندات الضيّقة للعديد من القوى والفصائل حالت دون توحيد الجهود ودعم المبادرات التي تصدر عن جهات ليست من كنف تلك القوى. وإذا وافقت على مجهود مشترك كان الثمن في تسليط الاضواء على من يدعم المبادرات. الانانية والذاتية والحسد تتحكّك في إجهاض العمل المشترك.
اما على الصعيد السياسي فحالة التجزئة والانقسام بين القوى السياسية تعود إيضا إلى مواقف تلك القوى في محطّات مفصلية استهدفت الامة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن الانقسام كان قائما عند احتلال العراق وهناك من استثمر سياسيا في الاحتلال. وما تلا الاحتلال من فتنة طائفية ساهم في تكريس الانقسام العربي. ولا يجب التقليل من حالة الانقسام التي اثقلت العمل الفلسطيني من جرّاء عملية اوسلو الذي ما زال قائما حتى الساعة. وهناك انقسام اكثر حدّة كان في الحرب التي شُنّت على وحدة سورية تحت غطاء ما سُمّي ب “الربيع العربي”. فالقوى السياسية المتناحرة للوصول إلى السلطة في سورية جعلت الخصومة مع منافيسها اولوية بدلا من التنبّه ان العدو الصهيوني واربابه في الغرب يستهدفون كل الاقطار العربية والقوى السياسية. وهذه القوى السياسية ليست محصورة في المشهد السوري بل لها امتدادات على صعيد الوطن العربي سواء كانت “قومية” الاتجاه أو “اسلامية” المنبت أو ليبرالية أو يسارية المنهج. فثقافة الاقصاء عبر التخوين أو التكفير تحكّمت بسلوك تلك القوى. كما لا يجب اغفال العدوان على اليمن وما أدّى من انقسامات داخل التيّار القومي والتيّار الاسلامي. طبعا، هناك استثناءات مهمة.
هذا هو جوهر مفهوم الكتلة التاريخية التي نسعى إلى تحقيقها في الوطن العربي حيث ندرك أنه ليس هناك من تيّار واحد أو قوّة واحدة باستطاعته (ا) تحقيق الاهداف. فتكامل قوى التيّار القومي والاسلامي واليساري والليبرالي أصبح شرط الضرورة والكفاية لإنجاح إي مشروع استراتيجي لتحقيق نهضة الامة. وهذه النهضة تبدأ في تحقيق التحرير لكفاة الاقطار العربية من الاحتلالات المباشرة كما من الاحتلالات الافتراضية للإرادة الوطنية لتصل إلى الوحدة السياسية. والوحدة السياسية هي شرط للتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والتجدّد الحضاري. التشاور بين مكوّنات المجتمع هي الصيغة لتحديد الخيارات والسياسات. أما اسس الحكم فهي مبينة على العدل أولا وأخيرا لأن العدل يعني المسائلة والمحاسبة. والمحاسبة تعني التكليف والتكليف لا يمكن أن يحصل إن لم تكن هناك إرادة حرّة. فالحرّية هي في مضمون العدل وإلاّ لما كان للعدل أن يكون.
سابعا-افكار حول ترويج الموقف السياسي والتعبئة في معركة الوعي والادراك
الفكرة الاولى هي احياء المؤتمرات والندوات العربية والدولية لدعم فلسطين وإسقاط مشاريع انتدابية جديدة وكأن التاريخ الحديث لم يعط الدروس الكافية حول فشل الحلّ الانتدابي. وهذا الحل يعكس ضحالة التفكير عند المستعمرين الجدد/القدامي حيث لم يتعلّموا من دروس التاريخ عند بلورة الافكار والمشاريع. المؤتمرات والندوات برهنت عن فعّاليتها في السابق واليوم الظرف الدولي أكثر ايجابية تجاه المبادارات التي يجب أن يطلقها المؤتمر القومي العربي أو مبادرات من قبل رموز المؤتمر ومكوّناته.
الفكرة الثانية هي أطلاق مبادرات لنصرة غزّة ومناهضة التطبيع عبر التفاعل مع الشبكات التي أقيمت خلال “طوفان الاقصى” والتي تفاعلت مع الشارع الغربي. فعلى سبيل المثال، يمكن التنسيق مع مبادرات التي أطلقها منتدى سيف القدس لنصرة غزة في التبرّعات، والوقفات التضامانية في وقت واحد كإشعال شمعة، أو أضراب عن الطعام. بالمناسبة، فإن شبكة “منتديات سيف القدس” كانت مبادرة من عضو في المؤتمر القومي العربي الاستاذ ناصر قنديل فشاركنا في أطلاقها. واليوم، بعد اربع سنوات أصبح للمنتدى حضورا على الصعيد الشعبي في كافة الاقطار العربية يُترجم بعدد المشاركين والمتابعين للحلقات وعددهم بالالاف. فنحن نعيش عصر المنصّات الاعلامية المكثّفة. والعلاقات الشبكية تسهام في ترجمة الافكار إلى أعمال تخلق أمرا واقعا في المشهد السياسي. وهذا نوع من تجسيد مفهوم الكتلة التاريخية بين تيارات الامة والتيّارات الدولية المتعاطفة مع القضية. المناخ الدولي بسبب “طوفان الاقصى” اكثر استجابة لتلك المبادرات.
الفكرة الثالثة هي اللجوء إلى التكنولوجية “الشعبية” للتعبير والترويج والتعبئة. اعضاء المؤتمر القومي العربي يمكنهم أن يروّجوا مواقف المؤتمر من كافة القضايا على صفحاتهم في وسائل التواصل إن كانوا يستعملون تلك الوسائل. كما يمكن تحضير سلسلة فيديوهات صغيرة تركّز على المواقف التي يريد المؤتمر دعمها وترويجها. سيكون للشباب القوّامة في تحضير وترويج تلك الافكار عبر وسائل التواصل. لذلك فإن إدخال هذا الموضوع في برامج عمل مخيّم الشباب سيكون ضروريا لتفعيل وترويج مواقف المؤتمر من كافة القضايا.
فليس كل من انتمى الى تلك التيّارات تبنّى المواقف لتلك القوى وهذا ما يجعل إمكانة تصحيح المشهد ممكنا وإلاّ ما كان ليستمرّ المؤتمر القومي العربي.
وما زالت بعض القوى تعتقد أنها ستكون من “الفرق الناجية” للوصول إلى السلطة إذا “تفهامت” مع المحتل أو قبلت بالتدخل الخارجي في الشأن الوطني والقومي. فاحتلال العراق والحرب على سورية ساهما في تعميق الحذر بين الكتل التاريخية كالقوى القومية والقوى الاسلامية والقوى اليسارية والقوى الليبرالية. فالعديد من بين هذه القوى استثمر بشكل أو بأخر في التعاون مع المحتل كما في حال العراق، ومع التحالف الدولي للقضاء على وحدة سورية ودورها في الإقليم وخاصة فيما يتعلّق بالصراع مع الكيان الصهيوني، أو أيضا في تمكين التقسيم في السودان وداخل كل قسم من السودان المقسّم، أو تدمير الدولة في ليبيا، أو دعم العدوان على اليمن. هذه الخيارات الخاطئة في مراحل مختلفة من التاريخ الحديث انعكست على وعي الجماهير العربية التي اهتزّت ثقتها بتلك القوى السياسية التي تسعى إلى قيادتها. تجربة “الربيع العربي” شهدت تحرّكا كثيفا من الجماهير التي آمنت بأجندات الاصلاح والتغيير لكن القوى المهيمنة على ذلك الحراك استغلّت الظرف لفرض اجندتها على حساب التعاون مع جميع القوى التي شاركت في الحراك. فكيف يمكن لهذه الجماهير ان تثق بتلك القوى السياسية التي ساهمت في الخديعة في “الربيع العربي” وفي المآسي الكبرى التي أصابت الامة في كل من العراق وسورية والسودان واليمن وليبيا ولبنان والجزائر في العشرية الدامية؟ تصحيح المشهد ممكن ولكن يتطلّب مجهودا كبيرا أوّله الجرأة على مراجعة المواقف وتبنّي الميمات الاربعة التي أطلقها احد مؤسسين المؤتمر الاستاذ مع بشور منذ 2003 في دورة المؤتمر القومي السنوية التي عقدت في صنعاء. فهذه الميمات يجب أن تتحكّم بسلوك كل من يريد أن يعمل في الشأن القومي والوطني. فالميم الاولى هي المراجعة، والميم الثانية هي المسائلة، والميم الثالثة هي المصالحة، والميم الرابعة هي المقاومة . إن لم تحصل تلك المراجعات والمسائلات والمصالحات والمقاومة لكل تدخّل خارجي فمن الصعب التوقّع ان الجماهير ستعيد الثقة الى تلك القوى السياسية التي خذلتها كما خذلتها الحكومات العربية.
والان، إذا افترضنا أن المراجعات المطلوبة قد تمّت أو على طريق الاتمام يبقى السؤال كيف يمكن تفعيل الشارع العربي؟ عند الكثيرين، هناك تقييم لفعّالية الشارع العربي مبني على ما كان يحصل في الخمسينات والستينات ومطلع السبعينات. الظروف الموضوعية التي كانت تتحكّم بالمشهد السياسي آنذاك لم تعد قائمة خاصة بعد الخيارات التي اتخذتها النخب العربية الحاكمة بعد رحيل الخالد الذكر جمال عبد الناصر. آنذاك، الحراك الشعبي في الشارع كان ربما الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الموقف الشعبي. أما اليوم، فالتكنولوجيا في التواصل أتاحت الفرصة للتعبير بشكل مباشر ومكثّف وإن كانت تلك الوسائل من صنع الغرب. المهم هنا أن وعيا شعبيا عما يحدّث في العالم وفي الوطن العربي قد نتج خارجا عن سيطرة النخب الحاكمة. السؤال هل أصبحت تلك الوسائل للتواصل البديل عن الحراك الشعبي؟ طبعا لا، ولكن لا يمكن أخفاق دوره في تكوين الرأي العام. والغرب بشكل عام والعدو بشكل خاص بذل جهودا كبيرة جدأ عبر العقود الماضية لتغيير المزاج العربي تجاه القضية الام ولتحويل الاهتمامات إلى قضايا إما لتساعد العدو كتفكيك التماسك الاجتماعي الداخلي أو لإحلال أعداء افتراضيين بدلا من العدو الحقيقي. لكن أيضا، كانت وسائل التواصل منصات لنقل المعلومة والوعي خاصة أن وسائل الاعلام التقليدية فقدت مصداقيتها في العالم حيث أصبحت أدوات تضليل وكذب ودعايات بدلا عن ادوات تنقل المعلومة. فالمعلومة أساس المعرفة والمعرفة أساس القوّة والقوّة لا تكتمل إلاّ بالوحدة.
المعلومة لم تعد حكرا على أي جهة أو أي مؤسسة. في الماضي كانت مؤسسة الحزب الوسيلة الرئيسية لنقل المعلومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت وسيلة التنظيم والتعبئة، وكانت تلك المؤسسة احدى ادوات الحراك السياسي والاجتماعي في أي بلد. اما اليوم، فأصبحنا في عصر العلاقات الشبكية حيث التواصل يتجاوز حدود الجمهور الحزبي. كما أن مفهوم الحزب هو مفهوم فرز بينما القضايا الاساسية التي تهم الشعوب تتطلّب التجمّع والشمولية. العلاقات الشبكية تسمح بذلك بينما الثقافة الحزبية تجعل التواصل الشبكي أمرا يصعب عليها الاستيعاب والتعامل معه وبه. هذا لا يعني أن الحراك الشعبي أصبح خارج إطار العمل التنظيمي بل أن شكل العمل التنظيم أصبح مختلفا عن الموروث الحزبي. هذا موضوع يستحق النقاش في العمق للخروج بصيغة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحد الادنى في الانضباط كما هو متجذّر في المؤسسة الحزبية، وتأخذ بعين الاعتبار التنوّع في مكوّنات المجتع وبالتالي الضرورة لصيغة مرنة تستطيع أن تضم الجميع.