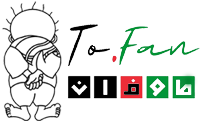كتب عبد الفتاح ماضي..
رغم امتلاك الدول العربية عديداً من عوامل القوة التي يمكن توظيفها لخدمة القضية الفلسطينية، لكن معظم هذه العوامل تُركت من دون تفعيل. فقد توجّهت دول عربية إلى نيويورك لحضور ما عرف بـ”المؤتمر الدولي لحلّ الدولتين” (28-30 تموز/يوليو 2025)، وعادت بإعلان لن يكون مصيره مختلفاً عن مصير عشرات القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ما دام تعطيل سياسة المبادرة والتأثير مستمرّاً، في وقتٍ يفعّل فيه الطرف الآخر أدواته، مدعوماً بتحالفات إقليمية ودولية.
نعم، يتضمّن الإعلان بعض الإيجابيات، من بينها اتفاق 16 دولة عربية وأجنبية على إدانة حرب الإبادة المستمرّة في قطاع غزّة منذ نحو 22 شهراً، ومطالبتهم بالوقف الفوري لها، ووقف سياسة التجويع، ومنع أي محاولاتٍ للتهجير القسري، إلى جانب الدعوة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وبدء عملية الإعمار، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ومن الإيجابيات كذلك الالتزام بمرجعية قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، التي تُدين الاحتلال والاستيطان، وتؤكّد حقّ تقرير المصير وحقوق اللاجئين، من دون الإشارة إلى قرارات محدّدة، غير أن هذه الإيجابيات تقابلها مغالطات، وأخطاء استراتيجية، تستوجب التوقّف عندها.
أولوية النظام الأمني الإقليمي على الحلّ العادل
أولاً: مغالطة إدانة الضحية. تمثّل إدانة المقاومة المسلّحة للاحتلال، والمطالبة بنزع سلاحها، خطأً أخلاقياً بالدرجة الأولى، إذ من المعروف أن دولة الاحتلال كيان استيطاني إحلالي منذ اليوم الأول. كما أنه خطأ سياسي واستراتيجي، إذ ما الذي سيدفع الطرف الأقوى (دولة الاحتلال المدعومة خارجياً) إلى التراجع أو تقديم تنازلات، إن لم تكن هناك مقاومة تفرض عليه كلفة ما؟ أليس تاريخ حركات المقاومة ضدّ الاستعمار شاهداً على ذلك؟ فلماذا تتصوّر بعض الحكومات العربية أن فلسطين ستكون استثناءً من هذه السُّنّة الكونية: حيثما وُجد احتلال، وُجدت مقاومة مسلّحة؟ ولماذا لا تُوظّف المقاومة ورقة ضغط تخدم ما تطرحه هذه الحكومات من حلول للصراع؟
ثانياً: مغالطة الحياد الزائف للغرب. إن الحديث عن “ضمانات دولية قوية” يفتقر إلى المعنى الواقعي، فهناك بالفعل عشرات القرارات الدولية التي تُدين الاحتلال وتدعو إلى انسحابه وتضع أطراً وضمانات مختلفة، غير أن عدم تنفيذها يعود، من جهة، إلى الرفض الأميركي والغربي، ومن جهة أخرى، إلى تخلّي الدول العربية عن استخدام ما تملكه من أوراق ضغط للتعامل مع هذا الرفض. ومن ثمّ، يقتضي المنطق (إذا أراد دعاة حلّ الدولتين تفعيل هذه الضمانات) أن يتوجّهوا إلى الولايات المتحدة تحديداً، وأن يوظفوا ما بأيديهم من أدوات وموارد لممارسة ضغط فعلي، ربطاً لاستثماراتهم ومصالحهم بتحوّل ملموس في الموقف الأميركي، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبات المجرّدة، أو توهّم أن الطرف الآخر سيقدّم هذه الضمانات طواعية من دون أن يُجبر عليها.
ثالثاً: مغالطة إدارة الأزمة بدلاً من حلّها. القول إن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع يُعدُّ خطأً استراتيجياً، لأنه لا يعالج جذور الأزمة، ولا يلبّي المتطلّبات الأساسية لتحقيق هذا الحلّ. فالصراع يدور بين قوة احتلال تمارس تمييزاً عنصرياً قائماً على أساس ديني ضدّ نحو خُمس سكّانها، وتتبنّى قوانين وسياسات عنصرية موثّقة، كتب عنها باحثون إسرائيليون وغربيون. إنها “دولة” لم تحدّد لنفسها حدوداً جغرافية، خلافاً لسائر دول العالم، وتمارس توسّعاً عسكرياً خارجياً مستمرّاً، وتخوض اليوم حرب إبادة باعتراف منظّمات دولية وشخصيات مرموقة، ويُلاحق قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
فكيف يمكن للوثيقة أن تتجاهل هذه المعطيات؟ وكيف يُتصوَّر أن تلتزم حكومة يقودها متّهمون بارتكاب جرائم حرب في أيّ اتفاق سلام؟ لماذا لا يصرّح الإعلان أن الاحتلال، والتمييز العنصري، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي جوهر الصراع؟ ولماذا لا يطالب الدول الغربية بامتثال قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا لا يدعو الشعب الإسرائيلي إلى اختيار قيادة جديدة غير ملاحقة قضائياً؟ ولماذا لا تُدرج هذه المتطلبات جزءاً أساساً من أيّ تسوية ممكنة، تماماً كما يطالب الاحتلال دوماً بقيادة فلسطينية منسجمة مع شروطه؟
رابعاً: مغالطة الإفراط في التركيز على الجانب الأمني وأولوية الاستقرار على العدالة. وردت عبارة “الاندماج الإقليمي” في الوثيقة تسع مرّات من دون تعريف دقيق أو توضيح مباشر لمضمونها. إلا أن ما يبدو واضحاً هو أن هدف “حلّ الدولتين” قد رُبط بشكل عضوي (أو باقتران كاثوليكي إن جاز التعبير) بهذا “الاندماج الإقليمي الكامل”، الذي يدعو إليه الإعلان. فقد ورد في الوثيقة أن إنهاء الصراع “سيمكّن من اندماج إقليمي كامل”، كما جاء فيها أن “الاندماج الإقليمي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدفان مترابطان”، وأن “إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهو جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي”، وأن من بين الأهداف أيضاً “تمكين الاندماج الإقليمي، وصولاً إلى بناء هيكل أمني إقليمي يعزّز الاستقرار”.
تُوحي هذه العبارات بأن الاندماج هو الغاية النهائية، وأن الصراع يجب أن يُزال بأيّ صيغة لتمكين هذا الاندماج، حتى لو أُفرغ حلّ الدولتين من محتواه العادل. كما توحي بأن هذا الحلّ سيكون مشروطاً بالانخراط في منظومة أمنية إقليمية يُرجّح أن يكون للاحتلال فيها دور مهيمن. غير أن الواقع يفرض معادلة معاكسة: فجوهر المشكلة هو الاحتلال، والغاية المنشودة هي إنهاؤه، وإنهاؤه هو الطريق الحقيقي نحو السلام والاستقرار.
خامساً: مغالطة التكرار العقيم. فكما يُقال: “الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتتوقّع نتائج مختلفة”. يصرّ الإعلان على إعادة طرح حلّ الدولتين، وهو الحلّ الذي ما فتئت الحكومات العربية تروّجه منذ مبادرة قمّة بيروت عام 2002، من دون أن يلقى أيّ اهتمام من جانب دولة الاحتلال، أو دعم فعلي من الولايات المتحدة. بل على العكس، استمرّ الطرفان في تقديم مقترحات أدنى بكثير، ومحاولة فرضها، بدءاً من جورج بوش (الأب) وبيل كلينتون، وصولاً إلى الاتفاقات الإبراهيمية، التي أقدمت بموجبها حكومات عربية على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال مباشرة، من دون ربط ذلك بأيّ تقدّم حقيقي في القضية الفلسطينية.
سادساً: مغالطة التبادل غير المتكافئ وسياسة الابتزاز الناعم للضحية. لقد طالب المؤتمرون في إعلانهم الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال وقيادته بتقديم التزامات وشروط تفوق بكثير ما طُلب من قوة الاحتلال. فقد ورد في الإعلان عدد كبير من الالتزامات التي اعتُبرت شروطاً أساسية لتحقيق “حلّ الدولتين”، كما تتصوّره الوثيقة. من هذه الشروط ما يُعدُّ التزامات سياسية ومؤسّساتية تمسّ جوهر الوضع الفلسطيني الداخلي، مثل تسليم قطاع غزّة للسلطة الفلسطينية، وإنهاء حكم حركة حماس، وتشكيل لجنة إدارية انتقالية تعمل تحت مظلّة السلطة فور وقف إطلاق النار، وتوحيد غزّة والضفة تحت سلطة “دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”. كما طُلب تنظيم انتخابات عامّة ورئاسية خلال عام واحد، تكون شفّافةً وديمقراطيةً وتحت إشراف دولي، مع اشتراط أن تقتصر المشاركة فيها على الأحزاب التي تلتزم بـ”برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والتزاماتها الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”. كما تضمّن الإعلان اشتراط الالتزام الصريح بالحلّ السياسي السلمي، ونبذ العنف والإرهاب (أي إسقاط خيار الكفاح المسلح)، إضافة إلى القبول بترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف، شريطة احترام السيادة الفلسطينية، وتحت حماية دولية.
ليس هذا فحسب، إذ إن هناك التزامات أمنية، منها إعادة هيكلة الوضع الأمني، وقبول تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بدعم دولي من أجل إنهاء وجود أيّ فصائل مسلحة خارج إطار السلطة، واحتكار السلطة الفلسطينية عمليات إنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي، ودعم نشر بعثة استقرار مؤقتة دولية بطلب من السلطة وتحت مظلّة الأمم المتحدة.
وهناك التزامات إدارية مثل تنفيذ برنامج إصلاح شامل، وتحسين الحوكمة والنزاهة والشفافية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير تقديم الخدمات العامّة، وتحسين بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية. فضلاً عن إصلاح النظام الضريبي والعمل من أجل الاندماج الكامل في النظام المالي والنقدي الدولي، بجانب الاستعداد لتسلّم خدمات اللاجئين بدلاً من “أونروا”. وهناك كذلك التزامات فكرية وتربوية، فتحت مسمّى مكافحة التحريض والتطرّف، طُلب من الفلسطينيين تنفيذ برامج لمحاربة التحريض وخطاب الكراهية والتطرّف العنيف، وتحديث المناهج التعليمية، وإشراك المجتمع المدني في الحوار والمصالحة المجتمعية. وأخيراً، هناك التزامات خطابية ودبلوماسية؛ إذ رحّب الإعلان ببيان الرئاسة الفلسطينية، الذي أكّد التزام حلّ سلمي ورفض العنف، وأن الدولة الفلسطينية ستكون غير عسكرية. ويبدو أن هذه العبارة الأخيرة تعكس مطلب أن تكون الدولة الفلسطينية المنشودة منزوعة السلاح كما يردّد سياسيون عرب عديدون.
جاء الحديث عن جُلّ هذه الالتزامات الفلسطينية بلغة حازمة ومباشرة، كما في عبارة: “أكّدنا ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في…”، و”بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فوراً للعمل في غزّة تحت مظلة السلطة الفلسطينية”.
في مقابل هذه الالتزامات كلّها المفروضة على الطرف الفلسطيني، نصّت الوثيقة على مجموعة من الالتزامات المطلوبة من دولة الاحتلال، بلغة يمكن وصفها (في الحدّ الأدنى) بأنها مراوغة وغير ملزمة. فقد ورد بعضها في صورة دعوة موجّهة إلى دولة الاحتلال لإصدار “التزام علني وصريح بحلّ الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة”. فيما جاء بعضها الآخر في صيغة مطالبة مشتركة للطرفَين الفلسطيني والإسرائيلي، مثل: “دعونا الطرفَين إلى مواصلة الجهود لضمان التزام أحزابهما السياسية بمبادئ اللاعنف، والاعتراف المتبادل، وحلّ الدولتين”، و”رحّبنا بالجهود الجارية لتحديث المناهج الدراسية الفلسطينية، ودعونا إسرائيل إلى القيام بجهد مماثل”، فضلاً عن دعوة الطرفَين إلى استئناف المفاوضات.
يعكس هذا التوجّه اختلالاً واضحاً في توازن توزيع المسؤوليات، ويجسّد نمطاً من الابتزاز الناعم للضحيّة، حيث تُحمَّل السلطة والشعب الفلسطيني أعباءً ثقيلةً ومفصّلةً، في مقابل غياب التزامات واضحة وموازية تُفرض على دولة الاحتلال، التي ما تزال تمارس عدوانها، وترفض الانصياع للقرارات الدولية، وتواصل سياساتها الاستيطانية والعنصرية من دون رادع.
ما العمل؟ هل من بديل ممكن؟
يكشف إعلان نيويورك مغالطات استراتيجية عميقة عديدة، فعلى الرغم مما تضمّنته من تأكيد بعض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لكن بنيته العامّة، وأسلوب توزيع الالتزامات بين الضحية والجلّاد، يكشفان اختلالاً جوهرياً في المنهج والرؤية. أيّ مقاربة جادّة لتحقيق حلّ تاريخي عادل لا يمكن أن تتجاهل حقيقة الاحتلال باعتباره جوهر الأزمة، ولا أن تُقايِض حقوقاً وطنية مشروعة باعتبارات أمنية أو مصالح إقليمية. كما لا يمكنها أن تُراهن على تغيير سلوك دولة استعمارية من دون تكلفة حقيقية تُجبرها على إعادة الحسابات، سواء عبر مقاومة فاعلة أو ضغوط دولية مدروسة.
حلّ الصراعات والأزمات الدولية لا يتم بمجرّد مناشدة طرف لآخر أو مطالبته بالتزامات شكلية، بل يتطلّب امتلاك إرادة سياسية واعية تستهدف تغيير ميزان القوة بين الطرفَين من خلال سياسات ومواقف عملية، تقوم على تفعيل عناصر القوة الكامنة. وينطبق هذا المنطق سواء على دعاة حلّ الدولتَين، أو مناصري تحرير كامل التراب الفلسطيني، أو حتى من يطرحون إقامة دولة واحدة لجميع مواطنيها. فدولة الاحتلال تنتهج منذ عقود سياسة ثابتة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيعه عبر تغيير الواقعَين الديمغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة عام 1967، على وضع باتت معه فكرة قيام دولة فلسطينية في هذه الأراضي أمراً مستحيلاً من دون تفكيك شامل للمستوطنات. وقد نُفّذت هذه الاستراتيجية عبر أدوات القوة العسكرية، وبدعم غربي واسع النطاق سياسياً وعسكرياً واستخبارياً، فضلاً عن سياسة خداع ممنهج، ولا سيّما في إطار ما عُرف بـ”مسار أوسلو”.
منذ التسعينيّات تركت الدول العربية الساحةَ لخصم يفرض الوقائع في الأرض، ويفرغ المبادرات السياسية من مضمونها
في المقابل، اكتفت الحكومات العربية، منذ التسعينيّات، برفع شعار “السلام خيار استراتيجي”، من دون أن تُترجم هذا الخيار إلى أدوات ضغط حقيقية من شأنها إقناع الطرف الآخر بالتنازل أو الاستجابة. لقد كان بإمكانها، لو امتلكت الإرادة، العمل على تعديل موازين القوة لصالح موقفها السلمي، أو حتى دعم خيارات أكثر عدالة واتساقاً مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. لكنّها تركت الساحةَ فارغةً لخصم يواصل (بدعم أميركي واضح) فرض الوقائع في الأرض، وإفراغ كلّ المبادرات السياسية من مضمونها.
ليس المطلوب اليوم من الحكومات العربية إصدار إعلان جديد يعيد تكرار أخطاء الماضي، بل إعادة توجيه سياساتها نحو معالجة جوهر المشكلة. يبدأ ذلك بإجراء مراجعة جادة للواقع السياسي العربي وأسباب ضعف المواقف تجاه الاحتلال: هل هو غياب الإرادة السياسية؟ أم قيود داخلية تتعلّق بالمصالح الاقتصادية والنُّخب الحاكمة؟ أم ضغوط خارجية؟ أم غياب تصوّر شامل لطبيعة الصراع؟ تلي ذلك ضرورة تقييم الكلفة الاستراتيجية للمواقف الضعيفة الحالية، في ظلّ استمرار الاحتلال في فرض وقائعه، وترسيخ تحالفاته مع القوى الكبرى، بما يكرّس هيمنته الإقليمية ويقوّض أيَّ مشروع سياسي عربي مستقلّ.
وعلى هذا الأساس، تصبح الحاجةُ ملحّةً إلى تبنّي رؤية سياسية جديدة، تُفعّل عناصر القوة المعطّلة عربياً، وتربط العلاقات الخارجية للدول العربية بالمواقف من القضية الفلسطينية وفق منطق المصالح المتبادلة. تشمل هذه الرؤية الانفتاح على دول الجنوب والبرلمانات العالمية، ومنظّمات المجتمع المدني الدولية، واستثمار التحالفات غير الرسمية مع النشطاء والمؤثّرين، وتحريك ملفّات قانونية في محكمة العدل الدولية وغيرها من منابر أممية، إلى جانب إعادة تعريف الصراع في الخطاب العربي الرسمي قضية تحرّر وحقوق إنسان، لا ملفَّ نزاع بين طرفَين متساويَّين. كما يتطلّب الأمر الاستقواء بالشعوب من خلال إصلاح الداخل العربي، وتفعيل دولة القانون والمؤسّسات، واستثمار الطاقات الوطنية، ودعم البحث العلمي المستقلّ والإعلام الاحترافي، وإنتاج سردية قانونية وأخلاقية متعدّدة اللغات تُخاطب الرأي العام العالمي، لا الحكومات وحدها. فلا استقرارَ يُبنى على الظلم، ولا سلامَ يتحقّق بالتنازل من طرف واحد، ولا مستقبلَ لأيّ مشروع عربي من دون عدالة تُنصف فلسطين وشعبها.