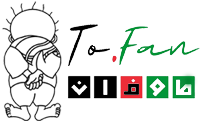المقاومة بين الوعي الثوري والوعي العقائدي
من تحرير الأرض إلى إعادة إنتاج التبعية
لم تكن المقاومة المسلحة، في السياق العربي، مجرد فعل عسكري أو ردّ فعل على عدوان خارجي، بل كانت دومًا تعبيرًا عن موقع طبقي وتاريخي في بنية الصراع مع الإمبريالية. إنّ الفارق الجوهري بين مفهوم المقاومة لدى التيارات الشيوعية العربية وبين التيارات الإسلامية لا يُختزل في المرجعية العقائدية، بل في طبيعة الوعي الذي يُنتج الفعل المقاوم، أي في موقعه من البنية الاجتماعية والسياسية التابعة.
حين تطرح الحركات الشيوعية مفهوم المقاومة، فإنها تنطلق من رؤية ترى الصراع بوصفه مواجهة شاملة مع منظومة رأسمالية إمبريالية تُنتج التبعية والنهب في المحيط. هنا، لا يكون السلاح غاية ولا شعارًا تعبويًا، بل وسيلة في مشروع تحرري هدفه إعادة بناء المجتمع على قاعدة الانعتاق الطبقي والاستقلال الاقتصادي والسياسي. فالمقاومة الشيوعية، كما تجلت في تجارب فلسطين ولبنان واليمن، كانت ترى في المواجهة مع الاستعمار والصهيونية امتدادًا للمواجهة مع البنية الداخلية التابعة، أي مع الأنظمة العربية العميلة التي تمثل الامتداد المحلي للمركز الإمبريالي. بهذا المعنى، تكون المقاومة المسلحة جزءًا من مشروع ثوري شمولي، لا لتحرير الأرض فحسب، بل لتغيير شروط إنتاج العبودية ذاتها.
في المقابل، تبرز المقاومة الإسلامية، وعلى رأسها تجربة حزب الله، بوصفها نمطًا آخر من الوعي المقاوم، يتحرك داخل حدود البنية القائمة لا خارجها. فهي تقاوم العدو الخارجي من موقع الانتماء الأيديولوجي الديني، لا من موقع الصراع الطبقي التاريخي. المواجهة هنا تأخذ شكلًا دفاعيًا أخلاقيًا أكثر من كونها فعلًا تحرريًا جذريًا. العدو محدد بصفته اعتداءً على “الأمة” أو “الهوية”، لا بوصفه تجسيدًا لعلاقات إنتاج وهيمنة رأسمالية عالمية. ولهذا، فإن هذه المقاومة، رغم بطولاتها وتضحياتها، تبقى محصورة ضمن النظام الاجتماعي والسياسي القائم، بل وتعيد إنتاجه في كثير من الأحيان.
وحين نقارن بين المشروعين، نرى أن المقاومة الإسلامية تفتقر إلى وعي الصراع بوصفه صراعًا بنيويًا بين قوى إنتاجية وقوى احتكارية عالمية. فهي لا تُسائل علاقة السلطة القائمة أو الاقتصاد الريعي أو الدولة الطائفية بالهيمنة الإمبريالية، بل قد تبررها أو تتحالف معها مرحليًا تحت شعار “وحدة الموقف” ضد العدو. إنّ مفهوم “الاستكبار العالمي” في خطابها يقفز فوق التحديد المادي للعلاقات الإمبريالية، فيتحول إلى تجريد أخلاقي يجعل الإمبريالية “شرًا معنويًا” لا بنية مادية يمكن تفكيكها. وبهذا، تُفرغ المقاومة من معناها الثوري، لتتحول إلى فعل دفاعي عن الذات الجماعية، لا إلى فعل هجومي لتغيير شروط التاريخ.
ويبقى السؤال قائمًا.
هل يصحّ توصيف المقاومة الإسلامية بأنها “حركات مناهضة للإمبريالية”؟
الجواب يتوقف على معيار جوهري.
هل يشكّل مشروعها خطرًا بنيويًا على المنظومة الإمبريالية وأدواتها في الداخل؟
الواقع يشير إلى أن أغلب هذه الحركات، رغم عدائها المعلن للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لم تنتج مشروعًا اقتصاديًا أو سياسيًا خارج حدود التشكيلة الرأسمالية التابعة، بل غالبًا ما اندمجت فيها عبر آليات التمويل، والتحالفات الإقليمية، والتوازنات الطائفية. فالعداء السياسي لا يكفي لجعل المقاومة “مناهضة للإمبريالية” بالمعنى العلمي، لأن الإمبريالية ليست عدوًا سياسيًا فقط، بل علاقة إنتاج وهيمنة عالمية تتجسد في السوق والسلطة والثقافة.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنّ الفعل المقاوم الإسلامي في لحظاته الميدانية الكبرى، كما في حرب تموز أو معارك غزة، شكّل خرقًا فعليًا لإرادة السيطرة الإمبريالية الصهيونية، وأسهم موضوعيًا في إضعافها. غير أن هذا الأثر لا يتحول إلى مشروع تحرري شامل إلا إذا اقترن بتحول في الوعي الطبقي والسياسي، أي إذا خرج من أسر “الهوية” إلى أفق “التحرر”. فالمقاومة التي تبقى محصورة ضمن حدود الطائفة أو المذهب أو الأمة المغلقة، محكومة بأن تتحول إلى ذراع محلية في صراع دولي، لا إلى قوة ثورية تقلب شروطه.
لقد أظهرت التجربة أن المقاومة الإسلامية حين تحوّلت إلى بنية سلطوية في لبنان وغزة، بدأت تتماهى تدريجيًا مع منطق الدولة القائمة، اقتصاد ريعي، بيروقراطية حزبية، وتحالفات طبقية جديدة مع القوى التقليدية. بهذا المعنى، انتقل الوعي المقاوم من موقع النقد إلى موقع التبرير، ومن موقع الثورة إلى موقع إدارة التوازن.
ومع ذلك، لا يُختزل الصراع في ثنائية “الإسلامي مقابل الشيوعي”، إذ يمكن للوعي الطبقي أن يتجلى داخل أشكال دينية حين تنفصل عن منطق الطائفة وتلتحم بمشروع تحرري مادي. فالثورية ليست نقيض الإيمان، بل نقيض الاستسلام.
إن المقاومة، لكي تكون فعلًا ضد الإمبريالية، يجب أن تكون ضد كل أشكال التبعية، بما فيها التبعية الداخلية. عليها أن تُسائل السلطة، وتفكك الاقتصاد الريعي، وتواجه التحالف الطبقي المحلي المرتبط بالمركز الإمبريالي. أما المقاومة التي تُصيغ نفسها في إطار ديني صرف، فتبقى مهددة بالتحول إلى أداة تعبئة منضبطة تستمد شرعيتها من الإيمان لا من المشروع التحرري.
في النهاية، الصراع بين النموذجين (الشيوعي والإسلامي) هو صراع بين وعيين:
وعي يرى في التحرر مسارًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الإنسان والعالم على أسس جديدة، ووعي يرى التحرر خلاصًا عقائديًا من “العدو الخارجي”. الأول يسعى لتغيير شروط الوجود، والثاني يسعى لحماية شروطه القائمة.
إن التحرر لا يكون من الخارج إلا بقدر ما يكون من الداخل؛
فمن لم يحرر وعيه من التبعية، لن يحرر أرضه من الاحتلال.
عبدالله عبدالله