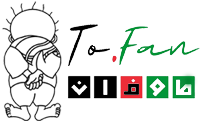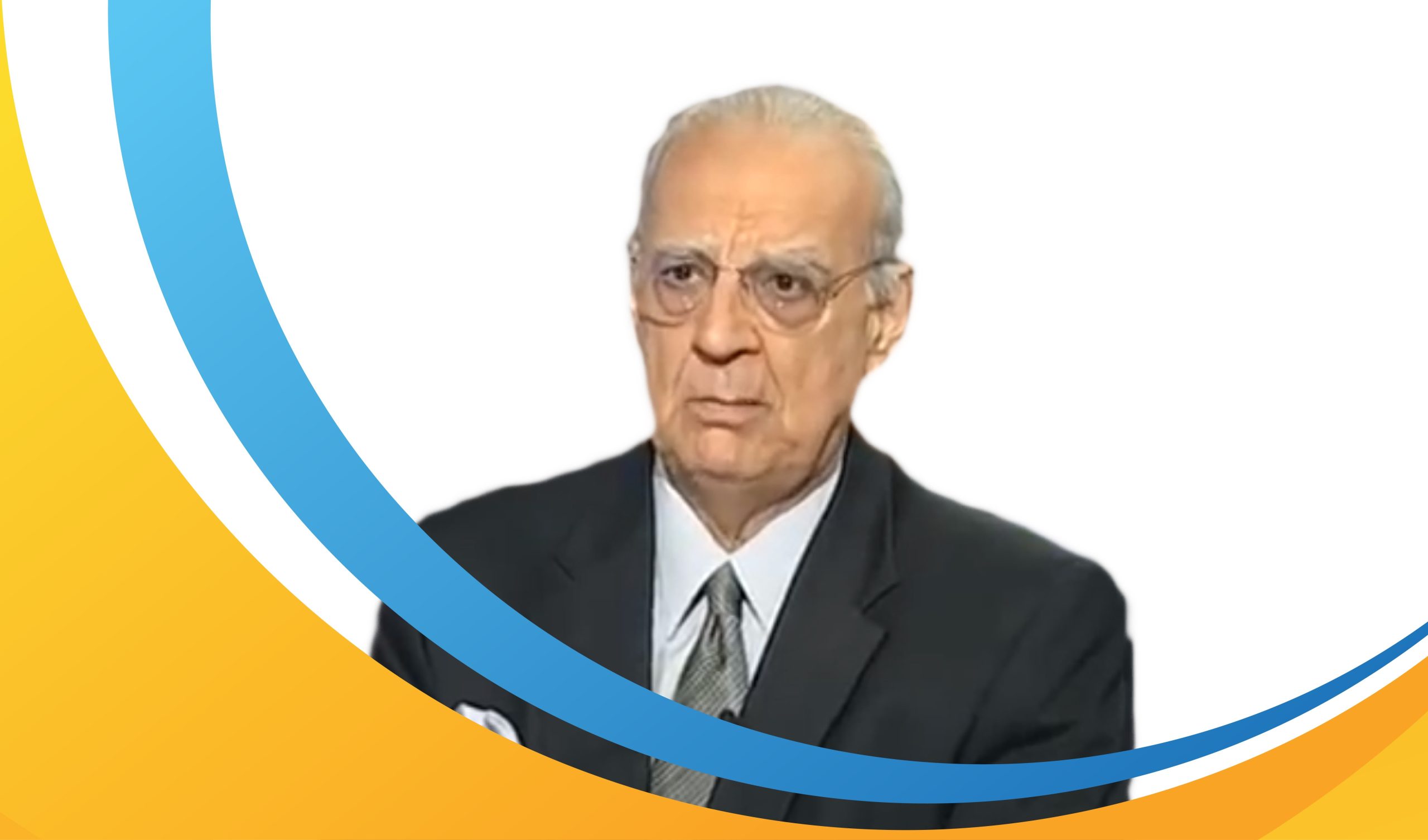تمهيد
أود في هذه الورقة التي تأخذ طابع المحاولة وفقا للمفهوم الغربي (essay) طرح تساؤلات حول بعض المفاهيم الأساسية التي تشكّل قاعدة السياسات الاقتصادية المتبعة سواء كانت في العالم أو في مختلف أقطار الوطن العربي. ويعود ذلك إلى قناعة ترسخت مع الزمن وبسبب تجاربنا التي امتدت على أكثر من أربعة عقود في البحث والعمل في الميدان التنموي، قناعة بأن الإطار النظري القائم لحلّ مشكلات المجتمع لم تعد قادرة على رسم الحلول الممكنة. ولا يمكننا أن نخفي تحفظّاتنا على العديد من ما يعتبر من المسلمات في التحليل الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتبعة في الغرب والتي فرضت على النخب الحاكمة في الوطن العربي بسبب الغزو الثقافي الذي رافق الاستعمار وما بعد الاستعمار الغربي لمعظم الأقطار العربية لتكريس مبدأ الدولة القطرية على حساب مفهوم الوحدة ومضمونها. والهدف من هذه الورقة حث مختلف الاقتصاديين العرب على مراجعة منهاج الفكر الاقتصادي وبالتالي السياسات الاقتصادية بشكل تكون أولا منبثقة من واقعنا ومن تراثنا العربي الإسلامي وثانيا لطرح مقاربة جديدة يمكن تعميمها على مختلف الأمم والشعوب. ذلك أن نموذج العمل الاقتصادي (business model) القائم حتى انفجار الأزمة المالية وصل إلى طريق مسدود ولم يعد صالحا لمعالجة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنه وعن البيئة المُعولمة التي فرضت نفسها على الجميع بسبب الثورة التكنولوجية في المواصلات والتواصل والنقل.
المنطلق الأوّل لهذه المقاربة هو أن الاقتصاد ليس علما رياضيا قائما بحد ذاته، بل هو أقرب إلى السياسة، بل ربما هو السياسة بحد ذاتها، ولكن بلغة الأرقام. وبالتالي من الأفضل التكلّم عن اقتصاد سياسي بدلا من اقتصاد مجرّد من لباسه السياسي كما هو دارج في الجامعات الانكلوسكسونية تحت مصطلح (economics). المنطلق الثاني هو أن ما هو معروف بالاقتصاد الكلاسيكي أو الليبرالي أو الوضعي الذي يعتمد آلية الأسواق والتنافس لترشيد استعمال الموارد والاستثمارات هو اقتصاد مبني على فرضيات تحتم النتائج التي يصل إليها وتشكّل قاعدة السياسات الاقتصادية. غير أن هذه الفرضيات إماّ هي غير واقعية في أحسن الأحوال أو غير صحيحة في أسوائها. والمأزق الذي يقع فيه مجمل النظريات والسياسات الاقتصادية يقرّ بشكل أو بآخر بالثغرات القائمة في قاعدة الفرضيات. لكن هناك إصرار من المجتمع الاقتصادي المسيطر في الجامعات الغربية على اعتبار النتائج التي وصلت إليها النظرية ما زالت مقبولة وإن كانت فرضياتها المبنية عليها عرضة للشك والمراجعة. هذا هو المأزق أي بشكل مبسّط هو الإقرار بنتائج النظريات والسياسات المنبثقة عن فرضيات مشكوك بصحتها مهما كلّف الأمر. وبناء على ذلك فإن المقاربات المختلفة للإقتصاد العربي بشكل عام والمبنية على تلك النظريات لا تستطيع حلّ مشكلات المجتمع في الدول النامية والمتقدمة. أما فيما يتعلّق بالمجتمع العربي فواقع الحال يفرض إعادة نظر شاملة في أدوات التحليل.
المنطلق الثالث هو أن ثقافة إنتاج الثروة في الوطن العربي مفقودة أو مغيّبة أو مهمّشة بشكل متعمد. ويحّل مكانها اقتصاد ريعي يوّلد ثقافة استهلاكية وثقافة توزيع مترسخة منذ أكثر من ألفي سنة وتعتمد على الولائات الفئوية التي تسود النظم السياسية القائمة. وبالتالي، فإن السياسات الاقتصادية المعتمدة سياسات تهدف إلى تمركز الثروة في يد المجموعات الملتفة حول العائلات الحاكمة والمتحكمة بمقاليد الوطن في مختلف الأقطار وفقا لبنى سياسية فئوية بامتياز سواء كانت قبلية، أو عشائرية، أو طائفية، أو مذهبية، أو مناطقية، أو قطاعية منفردة، أو مجتمعة. وهذه الأنظمة الفئوية حوّلت منطق الدولة والقانون إلى وسيلة تؤمن ديمومة النظام القائم وتعتمد الفساد كأدآة توزيع المنافع والمواقع وفقا للولائات المذكورة أعلاه. ويمكن للقارئ العودة إلى البحث المفصّل الذي تقدمنا به في ندوة عن البنية الاقتصادية والأخلاقيات في الوطن العربي، ندوة أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد في تشرين الأول 2008 .
أما المنطلق الرابع فهو الإقرار بأن طبيعة الاقتصاد العربي اقتصاد ريعي يولد ثقافة اللامجهود واللامبادرة وتجنب المخاطر لمنع ثقافة المسائلة والمحاسبة التي تزعج الفئات الحاكمة والمتحكمة بمقاليد الوطن العربي.
المنطلق الأول: الاقتصاد هو السياسة، ولكن بلغة الأرقام
علم الاقتصاد هو علم الندرة خاصة إذا ما أقيمت المعادلة بين الطلب المرتكز على الشهوات المختلفة والتي لا يحدّها شيء والإمكانيات لإشباع تلك الشهوات أو العرض بشكل عام والمحدود نسبيا بسبب الندرة. لذلك نشأت ضرورة “عقلنة” أو “ترشيد” استعمال الموارد عبر آلية الأسعار التي تحدّ من الطلب وتحفّز العرض للسلعة أو الخدمة.
وبالتالي يصبح السعر أو القيمة الضابط للعرض والطلب. والعقلنة هي بحد ذاتها نوع من العمل أو الخيار السياسي إذ تمّ ترتيب الأولويات وفقا لقيم الضرورة والمنفعة. وحتى ضمن الضرورة والمنفعة تراتبية تعكس خلفيات وخيارات سياسية تجعل من فرضية الندرة أساسا لعمل سياسي. ولهذه النظرية المبنية على الندرة خلفية سياسية مهمتها الحفاظ على مصالح النافذين أو ضرب مصالح أخصام الفئات الحاكمة. فالاقتصاديون مشهورون بالبدء في استنتاجات ذات طابع سياسي بامتياز ومن ثمة ينتقلون بتحليل عكسي للوصول إلى النتيجة التي بدأوا منها سواء كانت سياسة التجارة الحرة أو سياسة الحماية الجمركية أو أي موضوع آخر (الخصخصة مثلا). واستطرادا يمكن القول أن الاقتصاد ليس إلاّ السياسة، ولكن بلغة الأرقام. والقرار الاقتصادي سياسي وسياسة بامتياز وبالتالي نرى أن النظرية الاقتصادية بشكل عام تعطي الغطاء “العلمي” إذا جاز الكلام للقرار السياسي الذي لا بمكن أن يُبرر إلا عبر ذلك الغطاء “العلمي”.
فنظرية الريع على سبيل المثال في الاقتصاد التقليدي أو الكلاسيكي هي نموذج عن الخلفية السياسية للنظرية . لقد حاول الاقتصاديون، من آدم سميث إلى دافيد ريكاردو إلى جون ستيوارت ميل إلى هنري جورج، عبر نظرية الريع تبرير سياسية فرض الضرائب على أصحاب الأملاك العقارية الذين يجنون دخلا دون أي مجهود. فكانت نظرية القيمة وفائض القيمة في الاقتصاد السياسي الفرنسي والبريطاني والتي تبرز الريع كفائض دون مجهود. وبالتالي النقد الموجه للعائلات الممتلكة للعقار التي تمارس تلقائيا سلوكا احتكاريا يحدّ من النشاط الاقتصادي المنتج ويحدّ من النمو والتنمية . ويضيف هدسون أن الأرض ما زالت عاملا أساسيا في تكوين الثروة حتى في عالمنا الصناعي والتكنولوجي وأن معظم “الأرباح الرأسمالية” ناتجة عن ارتفاع أسعار الأرض. أما التحوّل الذي حصل فهو تغييب دور الأرض في صلب الفكر الاقتصادي الحديث . كما أن “الأرباح الرأسمالية” أصبحت الوجه الحديث للريع خاصة تلك الأرباح التي تتحقق في الأسواق المالية حيث ارتفاع قيمة الأوراق المالية من أسهم وسندات ليست بالضرورة مرتبطة بنتائج المؤسسة التي أصدرت تلك الأوراق. فالمضاربة هي عنصر أساسي لتكوين الريع المالي الناتج وليس المجهود الإنتاجي.
من هنا نرى أن آلية السوق كضابط للتجاوزات في السلوك أصبحت ضربا من الوهم. والنظرية الكينيزية لتحفيز الطلب الإجمالي (aggregate demand) خير دليل على إخفاق السوق كنظرية ضابطة للتوازن. وليست تدخلات الاحتياط الفدرالي الأميركي للملمة تداعيات الفضائح المالية والانهيارات للمؤسسات المالية الضخمة كبير سترنز ((Bear Stearns وليمان (Lehman) إلا خير دليل على فشل “السوق” في ضبط الأمور! وقد جاء في دراسة منذ خمسة وعشرين سنة تقريبا نشرت في كبيرة المجلّات الدورية الاقتصادية الأميركية، أنه إذا اعتبر توزيع الدخل في مجتمع ما هو ناتج عن لعبة المصادفة (أو المشيئة الإلهية في ثقافتنا!) بحيث ينقسم الناس إلى أفراد ناجحين محظوظين يحصلون على أكبر قدر من الريع، وآخرين فاشلين لم يحالفهم الحظ أو الكافاءة في الحصول على الريع بأشكاله المختلفة ، نرى مدى صحّة ذلك الوصف للمجتمعات العربية.
إن السياسات الاقتصادية المتبعة في الغرب تنبثق عن إطار فكري يرفع إلغاء القيود والمراقبة للنشاطات الاقتصادية إلى مرتبة نهاية التاريخ. هذا وقد مرّت الولايات المتحدة بتحوّلات أساسية منذ إدارة الرئيس ريغان. فالأفكار السياسية والاقتصادية المحافظة التي ظهرت منذ تلك الفترة تهدف إلى القضاء على الثورة التي شكّلها ” النيو ديل” (New Deal) أي الصفقة الجديدة التي أقامها الرئيس فرانكلين روزفلت والتي زرعت جذور دولة الرعاية (welfare state) كحل جذري لمنع الكساد الاقتصادي الذي عمّ الولايات المتحدة خلال الثلاثينات من القرن الماضي والذي كان ليسهّل انتشار الشيوعية بعد نجاح الثورة البلشفية. أما روّاد الفكر المناهض للثورة فهم المرشح الرئاسي السابق باري غولدواتر والرئيس رونالد ريغان، ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريت ثاتشر صاحبة النفوذ في تفكيك دولة الرعاية وسلطة النقابات في بريطانيا والولايات المتحدة، والاقتصادي النمساوي الأصل فريدريتش فون هايك (الأب الروحي للثورة الاقتصادية اليمينية) والاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل والمعادي للفكر الكينيزي ميلتون فريدمان. كما ساهمت مؤسسات الأبحاث-خزّانات الفكر-في ترويج المواقف والأفكار المؤيدة لأولوية الأسواق وتقلّص دور القطاع العام . إحدى الوسائل في تلك الهيكلية الفكرية المتبعة هي إزالة البعد السياسي من الآلية الفكرية في الاقتصاد. ومن هنا نرى تعليم الاقتصاد الصرف (pure economics) المهتم أساسا بنظرية التوازن الاقتصادي علما أن الاقتصاد الصرف نوع من الوهم والضلال.
أضف إلى ذلك أن العلماء الرياضيين برهنوا استحالة تحديد منحنيات العرض والطلب بغية الوصول إلى التوازن النظري بتقاطعها وبالتالي أصبحت نظرية التوظيف أو الاستخدام الكامل نظرية غير صحيحة من خلال مفهوم التوازن . وهنا تكون النتيجة الأساسية السياسية لذلك الفكر: فإذا استحال تحقيق الاستخدام الكامل فلا جدوى إذا من إتبّاع سياسات اقتصادية ترمي إلى تحقيق هدف مستحيل! وبالتالي تمّ بناء الإطار النظري للسياسيين للتخلّي عن اتبّاع سياسات لتحقيق الاستخدام إلاّ بالحد الأدنى التي تفرضه المقتضيات السياسية والاجتماعية. كل ذلك يؤدّي إلى ضرورة مراجعة الأسس في الفكر الاقتصادي. وبالفعل أصبح الفكر الاقتصادي الحديث منظومة فكرية مجرّدة بعيدة عن الحقائق الاقتصادية.
إن طلاّب الاقتصاد في الغرب مستاءون من طريقة التعليم ومن مضمون التعليم وخاصة في الجامعات الكبرى . ويفيد البحث الميداني أن الاقتصاديين الشباب يتساءلون عن جدوى ما يدرسونه في الجامعات ومدى نفع ذلك لمجتمعاتهم. فالمقالات في المجلات المختصة لا تفيد ولا تزيد في فهم المعضلات التي تواجهها المجتمعات ولا تؤدي إلى حلول واقعية. وهناك بوادر للتمرّد في بعض الجامعات الغربية وخاصة في فرنسا إلاّ أن ذلك التمرّد ما زال محصورا، ولكن النقاش مستمر لمعالجة مضمون التعليم .
هناك بعض الاقتصاديين أكثر صراحة وجراءة ينتقدون بشدّة صحّة الفكر النيو كلاسيكي. بل يذهبون إلى أبعد من ذلك ويقولون إنه خاطئ. فعلى سبيل المثال نظرية التجارة الحرّة ركن أساسي من الفكر النيو كلاسيكي وتداعيات تلك النظرية واضحة بأبعادها السياسية. وتقول النظرية أن التجارة الحرة ” جيدة” لكافة الأطراف وتذهب بعيدا في “تفسير” وتبرير التجارة التي أصبحت العنصر الأساسي للسياسة الخارجية للدول الصناعية والمتقدمة. كان ذلك صحيحا بالنسبة للإمبراطورية البريطانية وهي إلى حد بعيد تنطبق على الإمبراطورية الأميركية الصاعدة . والإدارات الأميركية المتعاقبة سعت وما زالت بشكل مكثّف إلى فرض الاتفاقيات التجارية والأسواق التجارية الحرة مع الدول التي تتماشى مع سياساتها عبر إقناعها بأن تلك الاتفاقات تخدم مصالح تلك الدول. لكن منافع التجارة الحرة لا تعود إلى الأطراف المتعاقدة في التبادل إلاّ إذا توفرّت الشروط النظرية لتحقيق المكاسب منها. والواقع أن تلك الشروط غير متوفّرة ولن تتوفّر. إن التفوق النسبي هو القاعدة المبرّرة للتجارة الحرّة غير أن الاقتصاديات الناشئة تفتقر إلى هيكليات اقتصادية متجانسة مع الولايات المتحدة إضافة إلى التفاوت بين وظائف الإنتاج (production functions) لتحقيق الشروط النظرية للتجارة. أضف إلى ذلك عدم التوازن في القدرة التفاوضية بين الدول الناشئة والدول الصناعية المتقدمة فأي اتفاق يعكس موازين القوى بين الفرقاء وهذا ما أدى إلى فشل دورة المنظمة العالمية للتجارة في كانكون. والجدير بالذكر وجود كتابات عديدة تنتقد نظرية التجارة الحرّة، ولكن ذلك خارج إطار البحث.
بالمقابل نرى الحكومات العربية تسعى بشدّة لتحقيق “إتفاقيات شراكة” سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الدخول في منظومة المنظمة العالمية للتجارة أو إنجاز “شراكة إستراتيجية” مع الولايات المتحدة علما أنها ستكون الطرف الخاسر اللهم إذا استثنينا الفئات المسيطرة على مقاليد الحكم والثروة في تلك الأقطار!
المنطلق الثاني: الفرضيات الخاطئة أو غير الواقعية في النظرية الاقتصادية الوضعية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية.
التماهي بين السياسة أو السياسات الاقتصادية و”العلم” الاقتصادي المزعوم الذي أشرنا إليه في الفقرات السابقة يعود في الأساس إلى الفرضيات التي تحدد آفاق وأطر النظرية الاقتصادية. الفقرات التالية ستعرض بشكل سريع على سبيل المثال وليس الحصر بعض الفرضيات الجوهرية لذلك الفكر الاقتصادي الغربي ونأمل أن تصبح حافذا للاقتصاديين العرب للبحث في هذه المواضيع والخروج من مسلّمات مدمّرة للفكر الإنساني.
أولا: فرضية الندرة.
كما أشرنا أعلاه “الندرة” هي المبرر الأول لضرورة “عقلنة” وترشيد استعمال وسائل الإنتاج لتحقيق الحد الأدنى من التوازن بين رغبات الفرد وأو المجتمع اللامتناهية والإمكانيات الموجودة لتحقيقها. والمسلّم هو أن تلك الإمكانيات أو وسائل الإنتاج محدودة. والقس روبرت مالتوس (1766-1834)، أحد الأباء المؤسسين للفكر الاقتصادي الكلاسيكي بلور نظرية تشاؤمية حول مستقبل البشري مبنية على التباين في زيادة نسبة السكان وزيادة نسبة الموارد. فالأولى كانت بمعدلات هندسية بينما الثانية كانت بنسبة معدلات رياضية – أي أن كارثة المجاعة كانت تحدّق بالبشرية. لذلك عُرف الاقتصاد أيضا بالعلم الكئيب ((dismal science.
لكن الوقائع أثبتت أن الإنسانية استطاعت تجاوز تلك الصعوبات عبر الاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي زادت من أنواع، وسائل الإنتاج، وإنتاجيتها، وفعّاليتها. غير أن شبح المجاعة والشح ما زال يهدد أقطارا وشعوبا بأكملها، ولكن ليس بسبب الندرة الطبيعية للموارد، بل بسبب سوء استعمال الإنسان لها. ورغم كل ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام الكلية للإنتاج الزراعي في العالم فإن التوازن قد يتحقق، بل ربما هناك من فائض في المواد الغذائية. لكن الممارسات الاحتكارية للمؤسسات والدول التي تنتج الفوائض الغذائية خلقت اللاتوازن بين العرض والطلب. وكذلك الأمر بالنسبة لكافة السلع الأساسية. فعلى سبيل المثال وليس الحصر إن الإنتاج النفطي العالمي يفوق الطلب بمعدل مليون برميل يومي. لكن المضاربات المالية والإلتواءات أو الإعوجاجات القطاعية (sectoral distortions) هي من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار النفط. طبعا يمكن الاستفاضة في النقاش حول هذا الموضوع وعرض الآراء المتباينة فيه غير أنه خارج إطار البحث. الفكرة الأساسية هي أنه إذا دققنا في أسباب النقص بين العرض والطلب سنجد أن في الأغلبية الساحقة لتلك الحالات، كي لا نقول جميعها، أن النقص سواء في الطلب أو العرض هو من فعل الإنسان، أي أنه بالإمكان السيطرة عليه. لذلك لا بد من إعادة النظر في مفهوم الندرة أو على الأقل استبعادها كسبب أساسي حتمي وطبيعي للتباين بين العرض والطلب. الندرة في رأينا من صنع الإنسان وميله للسيطرة والهيمنة والتحكم لمصلحته سواء كانت فردية أو فئوية. ولنا في ذلك الموضوع الكثير من الكلام، ولكن في مكان آخر.
الملفت للنظر أن الندرة غائبة في ثقافتنا. جاء في القرآن الكريم عدد من الآيات تفيد أن النعم موجودة بوفرة، بل لا يستطيع الإنسان عدّها وإحصائها: “وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها” (ابراهيم 34). لكن هناك عدة إشارات أن الندرة من صنع الإنسان فالتوصيات عديدة في عدم التبذير والإسراف والهدر. وليست سورة يوسف إلا خير دليل على ضرورة حسن التدبير لمواجهة سنين العجاف. على كل حال إن تواجد الموارد والنعم بوفرة لا يغني المرء عن ضرورة، بل واجب السعي والعمل لكسبها. لكن ما تراكم من عادات وقيم مغلوطة بشأن العمل وقيمته (أنظر في فقرة لاحقة لتحليل ابن خلدون) أدّت إلى تفشّي ثقافة اللامجهود واقتناص مجهود الغير كأساس مكوّن للثروة.
من جهة أخرى لا بد من لفت الانتباه إلى دور الدعاية التجارية التي تخلق حاجات عند جمهور المستهلكين تؤدي إلى تحويل إمكانياتهم المالية كالمدخرات التي يمكن أن تصرف في آماكن أخرى على الحاجيات الأساسية أو في استثمارات منتجة، إلى إشباع الحاجات الجديدة والاصطناعية وغير الضرورية، كل ذلك تحت نظرية/فرضية حرية الإختيار للمستهلك أو الفرد. واستطرادا نشير إلى ما جاء في القرآن الكريم لعدد من الآيات المتعلقة بحب الإنسان للمال والمظاهر من اللباس الفخمة ووسائل النقل والقصور إلخ لذلك أجاب القرآن على سؤال عن النفقة قال: “يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو” (البقرة 219)، والعفو من المال ما زاد عن الحاجة. أي الحاجة هي الأساس وما زاد عنها يجب إنفاقه في الحسنات أو في المشاريع المنتجة. أي بمعنى آخر يجب ضبط الإنفاق حسب الحاجة وكبح الجموح إلى إبراز مظاهر الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يفيد وخاصة نزعة الإستدانة المفرطة لتحقيق ذلك الاستهلاك. ولسنا في إطار التحدّث عن الاقتصاد الإسلامي غير أننا ندعو الاقتصاديين العرب أن يبحثوا ويتعمقوا في التراث الغني الذي يمكن الاستخراج منه أدوات تحليل جديدة أو متطورة بشكل تتلائم مع الواقع العربي.
ثاينا: عقلنة الإنسان
تقوم النظرية الاقتصادية على فرضية عقلنة الإنسان. فالفكر الغربي أفرز ما يُسمّى بالإنسان الاقتصادي (homo oeconomicus) اي الإنسان العاقل الذي يفكّر ويستعمل العقل لتحقيق الحالة المثلى أو الأثلية (optimization). وهذه الفرضية مبنية على منظومة فكرية اساسها نقد الفكر التنويري الذي أبعد الدين عن تسيير أمور المجتمع. يشير الدكتور جورج قرم في مؤلفه حول “المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين” أن الثورة المضادة للفكر التنويري والفكر الاشتراكي أفرزت فكرة ذلك “الإنسان العاقل” الذي يعي مصلحته الاقتصادية أكثر من أي طرف آخر وخاصة الدولة التي تحاول أن تتدخل في شؤون الانسان . أي هناك بعد سياسي ديني إذا جاز الكلام لتلك الفرضية مما يعزز ما أشرنا إليه في المنطلق الأول من هذا البحث حول الجوهر السياسي ل”علم الاقتصاد” وبالتالي “علمية” فرضية العقلنة تصبح في أحسن الأحوال منقوصة وفي أسوائها خاطئة.
لكن ما هو مفهوم العقلنة؟ إذا نظرنا إلى الأدبيات المعاصرة نجد أنه هناك تباين في التعريف كما يشيرالاقتصادي الهندي آمارتيا سين الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد . إن القيام بما يلزم لتأمين الرفاهية الفردية وأو الاجتماعية قد تكون وسيلة لتعريف “العقلنة”. غير أن الاقتصاد الكلاسيكي لا ينظر إلى العقلنة من هذه الزاوية، بل عبر تحقيق الحد الأقصى للمصلحة الفردية سواء عبر الثروة أو عبر إشباع الرغبات. ويذهب البعض إلى القول إن المصلحة الخاصة توازي أخلاقيا قانون الجاذبية . من هذا المنطلق نفهم كلام مارغريت ثاتشر التي قالت إنه ليس هناك أي شيء اسمه “المجتمع” بل هناك مجموعة أفراد! أي المبدأ النفعي المادي الدارويني (قانون القوي) هو سمة “العقلنة” في الاقتصاد الوضعي الكلاسيكي. أما التداعيات السياسية والاجتماعية لتلك النظرة فهي واضحة وتصب في تبرير تمركز الثروة في يد القلّة على حساب “محمع الأفراد” الذين يشكلون المجمتع.
لكن حتى ذلك المفهوم النفعي لتلك الفرضية ضربتها عرض الحائط سلوك الناس سواء بوعي كامل أو تحت تأثير الدعاية التي خلقت في النفوس حاجات لم تكن موجودة في الأصل. فالدعاية التجارية هدفها خلق أو دفع إلى المزيد من الاستهلاك والطلب لسلع وخدمات قد لا تكون في الأساس ضرورية لتحقيق سعادة الإنسان أو حتى لإشباع حاجات أساسية كالأكل والسكن واللباس، والطبابة، والتعليم، والتنقل. وتوقعات وآمال الناس قد لا تكون مبنية على اعتبارات عاقلة ومعقولة وقد تؤدي في آخر المطاف إلى “خربطة” النماذج الاقتصادية. لقد أشار الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في مؤلفه الشهير “النظرية العامة للإستخدام، والفائدة، والنقد” (1936) إلى دور التوقعات (expectations) في العديد من الحالات التي يصعب احتسابها بدقة . والمضاربات المالية في مختلف البورصات خير دليل على العامل النفسي اللاعقلاني الذي يتحكم بقرار الانسان. فالجشع والخوف محرّكان أساسيان لسلوك الإنسان الاقتصادي كما أشار أحد أبطال الفيلم الأميركي الشهير للمخرج اوليفر ستون “وال ستريت”! (Greed is good!).
ثالثا: آلية الأسعار والأسواق الحرّة
نتيجة لمفهوم الندرة برزت ضرورة ترشيد استعمال الموارد للوصول إلى الحالة الأكثر إفادة أو الأمثلية. وهذه الأمثلية تتحقق وفقا للفكر الاقتصادي الوضعي السائد عبر آلية الأسعار التي يحددها تقاطع العرض والطلب. غير أن القوانين المرافقة لذلك الأمر في النظرية الاقتصادية تشير إلى نوع من التحليل الدائري (circular reasoning). فمن جهة سعر السلعة يحدده السوق أي تفاعل العرض والطلب. ومن جهة أخرى يتفاعل العرض والطلب وفقا لاعتبارات عديدة منها السعر. فالسعر هو السبب والنتيجة في آن واحد. ولكن حتى إذا تجاوزنا تلك المعضلة التي هي أكثر من شكلية نقع في مطب الفرضيات التي ترافق نظرية السوق وتحديد الأسعار. هذه الفرضيات صارمة ومحددة كضرورة تحديد الفترة الزمنية التي تتمّ فيها معالجة الموضوع، وضرورة تثبيت العوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر في تحديد الطلب والعرض كعدد السكان والدخل القومي والأذواق والعادات السائدة إلخ. هذه المتغيرات “المثبتة” تحت مصطلح “كل شيء آخر ثابت” أو (ceteris paribus assumption). هذه الفرضية في ثبوت المتغيرات الأساسية تحدّ من صحة النظرية التي تريد التركير فقط على ثنائية الكمايات المطلوبة/المعروضة مع السعر فقط لا غير. وقد أشار إلى ذلك كبير الاقتصاديين النيوكلاسيكيين الفرد مارشال في مؤلفه المميز “مبادئ الاقتصاد” الذي حذّر من الإفراط في التحليل والتكهن لسلوك العملاء الاقتصاديين . أذكر في ذلك السياق ما كان يؤكده أستاذي الجامعي المرحوم نديم خلف الذي كان يحذّرنا أن القيمة الاسقاطية للنظرية الاقتصادية مقيّدة وقد لا تتحقق شروطها. كما أشار ايضا الفرد مارشال أن النظرية قد تكون مفيدة لشرح ما حصل أكثر من التكهن حول ما يمكن أن يحصل . لذلك نرى الإخفاقات المتكررة لتكهنات الاقتصاديين الذين يبرعون في تفسير لماذا لم تتحقق توقعاتهم!
وهناك أدبيات كثيرة في نظرية الأسعار وآليات السوق تدّل على التباين في الاجتهادات والنظريات. لكن إذا دققنا في تلك النظريات نرى أن هناك خلفية واضحة لكل منها. فإطلاق حرية الأسعار عبر “حرية الأسواق” تؤدي في آخر المطاف إلى تمركز اقتصادي في يد القلّة وهذا ما أوضحه معظم الاقتصاديين النيوكلاسيكيين من الفرد مارشال إلى ادوارد شامبرلين إلى جون روبنسن. فالأسواق الحرة تؤدي إلى الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات الكبرى المتمكنة من التأثير على الأسواق وعلى المؤسسات التشريعية. في هذا السياق نشير أن جورج ستيغلر وآخرون، أوضحوا أن التنظيمات والقيود للأسواق هي نتيجة جهود القوى الضاغطة ((pressure groups سواء كانت تجمعات اقتصادية أو عمّالية أو بيئية . من جهة أخرى هناك تيّار فكري يقرّ بأن السوق الحرّ يؤدي في معظم الحالات إلى انحرافات قد تأتي بكوارث وانهيارات.
فعلى سبيل المثال يُدرّس في برامج الماجستر في إدارة الأعمال (MBA programs) عن الإخفاقات في آليات السوق الناتجة عما يُسمّى بالعوامل الخارجة عن سيطرة للمشروع الاقتصادي (externalities) سواء كانت في الإنتاج أو في الإستهلاك. وهذه العوامل قد تكون إيجابية أو سلبيةexternal economies or diseconomies)) وفي كلا الحالتين تبرّر تدخّل التشريعات الضابطة إما للتحفيذ في حال كانت تلك العوامل الخارجة عن سيطرة المشروع إيجابية أو لفرض الضرائب الرادعة إن كانت سلبية . وبالنتيجة هناك إقرار ضمني (وفي بعض الأحيان صريح) بأن آلية الأسعار والسوق قد لا تأتي بالحل الأمثل على الأقل في المدى القريب. إي أن ما قاله كينز أن المهم هو الفترة الزمنية القصيرة “لأننا في المدى الطويل نكون من بين الأموات”!
رابعا: الاستدلال الحشوي (tautological reasoning)
بناء على ما سبق نرى أن صرامة الفرضيات وكثرتها في التحليل الاقتصادي الوضعي الكلاسيكي تؤدي إلى إستنتاجات لا تخلو من الاستدلال الحشوي أو تحصيل الحاصل. وبالتالي تفقد النظرية الاقتصادية قيمتها الاستشرافية لعدم تجاوبها مع الواقع العملي. من هنا يمكن أن نفهم الإخفاقات في التنبؤات الاقتصادية وحصول الإخفاقات وتدافق التفسيرات لتلك الإخفاقات التي كان يجب التنبؤ بها وتجنبها. فما قيمة النظريات التي تؤدي بطبيعتها إلى انحرافات؟ أليست نظرية التنافس الحرّ والأسواق الحرّة مؤدية بشكل شبه حتمي إلى تمركز النشاط الاقتصادي بيد القلة المحتكرة وبالتالي تحدث الإعوجاجات القطاعية والفجوات الاقتصادية والاجتماعية؟
المنطلق الثالث: غياب ثقافة إنتاج الثروة والمجهود في الوطن العربي
كنا قد أشرنا في دراسة سابقة عن غياب ثقافة إنتاج الثروة والمجهود في الوطن العربي واستبدالها بثقافة التوزيع علما أن ثقافة التوزيع الموجودة في الفكر الاقتصادي الغربي وُجدت للتخفيف من الإعوجاجات التي تولدها نظريات الإنتاج وفقا للمفاهيم الفلسفية/الدينية لإنتاج الثروة. والمقصود بذلك ما يُسمى بالأخلاقية البروتستنتية ونمو الرأس المالية، أي نظرية ماكس ويبر. أما في الوطن العربي فمفهوم إنتاج الثروة مربتط باقتناص مجهود الغير سواء عبر الغزو أو عبر التبادل التجاري وذلك منذ ما قبل الإسلام وبعده. واللغة الحديثة عن ذلك المفهوم لإنتاج الثروة يتلازم مع ما يُعرف في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية بالريع الاقتصادي وحديثا بالريع المالي كظاهرة للتطوّر الرأس المالية المعاصرة .
من جهة أخرى نلاحظ أن معظم الأدبيات الاقتصادية العربية المعاصرة مُستمدّة من الفكر الاقتصادي الغربي (حتى الشق الاقتصادي للمشروع العربي النهضوي الذي يجرى مناقشته في فقرات تالية) مما يؤكد مدى الغزو الثقافي الغربي للعقل العربي المعاصر. والفكر الغربي حاول محو الفكر الاقتصادي العربي وخاصة الإسلامي للعصر الذهبي. يقول جوزيف شومبيتر الاقتصادي النمساوي الشهير بالحرف الواحد: “أما فيما يتعلّق بموضوعنا (يقصد تاريخ الفكر الاقتصادي البشري)، يمكننا بكل آمان القفز فوق خمس مائة عام حتى زمن القديس تومى الأكويني (1225-1274)، حيث مؤلفه الجامع الديني (Summa Theologica) يمثل خلاصة الفكر البشري” . أي هناك فراغ كبير في الفكر الاقتصادي البشري امتد منذ نهاية الحقبة اليونانية حتى فكر أكويناس، متجاهلا عن قصد أو غير قصد المساهمات العديدة العربية الإسلامية في الاقتصاد وخاصة المالية العامة لكل، على سبيل المثال وليس الحصر، من ابن المقفع (720-756)، وأبو يوسف الدمشقي (المتوفي عام 798)، والطرطوشي (1049-1126)، والماوردي (972-1058)، والغزالي (1058-1118)، وطبعا ابن خلدون (1332-1406). أما في مجال الدورات الاقتصادية ((business cycles فهناك مساهمات البيروني (973-1048) ومسكويه (932-1030)، والطرطوشي مجددا والعلامة ابن خلدون. أما فيما يتعلق بنظرية النقد والأسعار نعود أيضا إلى الغزالي وابن القيّم (1292-1406) والمقريزي (1363-1442). لايسعنا في هذا البحث التحدّث بالتفصيل عن تلك المساهمات يكفي أن نقول إنها سبقت بعدة قرون مساهمات الاقتصاديين الكلاسيكيين من منتصف وآواخر القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين. كل ذلك للتأكيد أنه يوجد في تراثنا أدوات التحليل المناسبة للواقع الاقتصادي العربي وما علينا نحن الاقتصادييون العرب إلاّ تجديد وتطوير ذلك الفكر.
ولا بد من لفت النظر أن تشخيص الواقع الاقتصادي العربي ما زال يرتكز على أدوات تحليلية أشرنا أعلاه إلى ضرورة إعادة النظر بها. فعلى سبيل المثال جاء في مسودة “المشروع العربي النهضوي” الذي أعدّه مركز دراسات الوحدة العربية مع عدد من “الباحثين والخبراء” تشخيص لذلك الواقع ننقله كما يلي:
” مظاهر التراجع هو التدهور المروّع في معدَّلات النموّ الناجم – أولاً – عن فساد السياسات الاقتصادية الرسمية، وعن الانتقال من الاقتصاد الموجَّه إلى الاقتصاد الحرّ دون ضوابط، وما استتبعه ونجم عنه من بيع ممتلكات الدولة والشعب إلى أفراد خرج أكثرُهُم من رحم بعض فساد القطاع العام والنهب المنظم للثروة وللمالية العامة…، والناجم – ثانياً – عن سياسات الاستدانة وتبعاتها الخطيرة على مالية الدولة، والانصراف المتزايد عن القطاعات الإنتاجية إلى قطاع التجارة والخدمات ومجمل أشكال الاقتصاد الطفيلي ثالثاً، والناجم رابعاً عن سوء التدبير للفجوة المتزايدة بين الموارد والسكان وسوء تدبير المال العام والإنفاق على برامج التنمية وهدر الموارد وسوء تدبير برامج تنمية الأسرة.
وكان لذلك التدهور المروّع كلفته الاجتماعية الكبيرة: البطالة المتزايدة، والتهميش الاجتماعي، والفقر المتفاقم، وتدهور مركز الطبقة الوسطى في المجتمع، وإفراغ الأرياف من ساكنيها وترييف المدن، ثم ما تولَّد عن ذلك من ظواهر كالعنف الاجتماعي، والعنف السياسي، وتحلُّل منظومة القيم، وتفكُّك الأسرة، وخراب النظام التعليمي.
لقد انهار الأمن الاقتصادي والغذائي في الوطن العربي بنتيجة ذلك كلِّه. وفي امتداد انهياره، زحف الفقر ليشمل قطاعاتٍ عريضةً من السكان، وازدادت الفوارق الطبقية بشكل فاحش ومخيف، وارتفعت درجة الاحتقان الاجتماعي الداخلي، وباتت البلاد العربية مرتعاً لأنواعٍ من التناقضات والصراعات الاجتماعية تهدّد بزعزعة استقرارها وتعريض أمنها الاجتماعي للخطر.” (انتهى الاقتباس)
هذه الفقرات الهامة لتشخيص الواقع الاقتصادي العربي تستوجب عدة ملاحظات:
أولا- إذا كنّا نوافق بشكل عام على تراجع في الواقع الاقتصادي العربي عبر تراجع معدّلات النمو إلا أن سبب ذلك التراجع ليس مرتبطا بحد ذاته بالتحوّل من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد حر. كان الأصحّ القول بأنه حصلت تحوّلات في السياسات الاقتصادية نحو اقتصاد ريعي بدلا من اقتصاد إنتاجي ومنتج. فالاقتصاد الريعي يتلائم مع طبيعة النظم السياسية القائمة والتي تحوّلت إلى نظم فئوية تستند على توزيع الريع وفقا لولاءات الفئة أكانت قبلية، أو عشائرية، أو طائفية، أو مذهبية، أو مناطقية، أو قطاعية منفردة، أو مجتمعة. فالنظام الفئوي الذي يتلازم مع التسلّط والاستبداد يوزّع الريع وفقا لسلّم التقارب من مراكز القرار. كما أن النظم الفئوية مرتبطة بشكل وثيق مع مراكز القرار الخارجية لدعمها بعد ما افتقرت إلى الشرعية السياسية التي تبرر قيامها. فالاقتصاد الريعي يعفي النظام الفئوي من المحاسبة والمسائلة وينمّي ثقافة اللامجهود والمبادرة والمخاطرة.
ثاينا- أما فيما يتعلّق بسياسات الاستدانة فهي منبثقة عن طبيعة الاقتصاد الريعي وثقافة الاستهلاك التي ترافقه كما أشرنا في بحثنا المذكور. كما أن الاقتصاد الريعي منكشف على الخارج ويخضع بالتالي للإملاءات الخارجية التي تأتي عبر “توصيات” المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولية والمصرف الأوروبي للإستثمار مثلا.
ثالثا- ولنا في البطالة المتفشية والمتفاقمة في الوطن العربي حديث قوامه أن البرامج التعليمية من الصف الابتدائي حتى الجامعة لا تُخرّج الكفاءات المطلوبة لدعم اقتصاد إنتاجي، بل لملء الوظائف التي مهمتها تدوير الفوائض المالية الناتجة عن مصادر الريع الخارجية كالنفط والغاز. وبالتالي نشهد طفرة الاقتصادي الطفيلي في عدد من دول الجزيرة العربية ولبنان ومصر تتلازم مع بطالة متفاقمة خاصة بين الشباب. كما أن تلك البرامج التعليمية لا تشجّع العقل النقدي تجنبا لتنمية ثقافة المسائلة والمحاسبة للنظم القائمة.
وبالتالي نرى تصوّر مسودة المشروع العربي النهضوي في فصله الخامس عن التنمية المستقلة تصوّرا ناقصا وخاليا من التشريح الموضوعي للواقع الاقتصادي العربي في سياقه التاريخي وفي المحاولات البائسة لانخراطه في الاقتصاد المعولم. فالعالم لا يريد من هذا الوطن إلاّ ثرواته وبالتالي يشجّع على استمرار الواقع وإن مع بعض الإصلاحات الشكلية التي تكرّس هيمنة الفئات الحاكمة وتحدّ من الصعود الأفقي لفئات اجتماعية قد تكون أكثركفاءة. وعلى ما يبدو هناك تسليم بواقع العولمة وصعوبة إمكانية تحقيق تنمية مستقلّة. فقد جاء في المسودة تعريف موارب أي غير مباشر لتلك التنمية عبر تحديد خمسة “مبادئ” لا تعالج طبيعة الاقتصاد الريعي وإمكانية الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي. وإذا حرصت المسودة على نفي العلاقة بين التنمية المستقلة والاكتفاء الذاتي إلاّ أنها لم توضح كيف يمكنها “توفير السلع العامة الأساسية وضمان الأمي الغذائي والمائي”. وإذا كنا نؤيد ضرورة تحقيق تلك الغايات فمن الضروري أيضا معالجة سبل تأمينها وهذا ما تفتقده المسودة.
فالكلام عن التكامل العربي كلام جميل وقومي بامتياز، ولكن في ظل الاقتصادي الريعي السائد يبقى السؤال: كيف يمكن تحقيق ذلك التكامل؟ أما الرؤية الغريبة التي اعتمدتها المسودة لبناء التنمية المستقلة فلا ندري كيف يمكن “إقامة التنظيم المجتمعي الذي يمكن أن يحمل غايات التنمية في الوطن العربي”. وإذا أضافت المسودة أنه يتحقق ذلك في “تضافر قطاعات المجتمع الثلاثة (الدولة، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني) مع خضوعها لمعايير الحكم الصالح”، نرى قي ذلك بصمات ثقافة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي التي تتجنب معالجة البنية السياسة وبنية الدولة في الأقطار العربية. فعن أي دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني نتكلّم؟ عن المجتمع الفئوي؟ عن الدولة التي تحكمها أسروالتي تتلاشى مؤسساتها؟ عن مجتمع مدني مرآة للواقع الفئوي والخاضع لمشيئة السلطة القائمة؟ وجميعها تستمدّ قوتها من التبعية الخارجية بشكل أو بآخر. لذلك لا بد من مراجعة الأدوات التحليلية والخلفية السياسية لتلك الأدوات قبل الشروع في مشروع غير قابل للحياة بصيغته الحالية.
أما المحور الثاني فهو “بناء الطاقات الإنتاجية العربية” وهذا ربما بيت القصيد، ولكن كيف؟ المسودة تكتفي بسرد سلسلة من التوصيات دون أي تفسير ك “تنمية الموارد” (كيف؟) وتعبئة الادخار (كيف وضمن أي سياسة نقدية ومالية وتجارية؟) أما ما تعتقده المسودة “ضمان أقصى استفادة من رأس المال البشري العربي في الداخل، مع العمل على توظيف الإمكانات العربية الهاربة، سواء فس صورة رؤوس أموال نازحة أو طاقات علمية بشرية مهاجرة” فهي تمنيات لن تتحقق ما دامت البنية الاقتصادية القائمة بنية ريعية مستندة إلى نظام فئوي وثقافة تحقّر المجهود وتُحيّيد المحاسبة والمسائلة.
أما المحور الثالث، وهو بناء التكامل العربي فأي بنية اقتصادية يمكن أن تتكامل مع بنية أخرى في الوطن العربي؟ ألم تستلزم فشل مختلف المحاولات للتكامل العربي وقفة لدراسة أسباب ذلك الفشل؟ وبالتالي كيف يمكن التوصية بالتكامل طالما لا نعرف أو لا نريد أن نعرف أسباب الفشل؟ وكيف يكون ذلك التكامل عندما تكون دالات الإنتاج متشابهة للغاية وبالتالي مفهوم التكامل يصبح شبه مستحيل بسبب عدم معرفة مواقع التفوق النسبي بين الأقطار العربية؟ أي أين التفوق النسبي الذي يبرر نمو التجارة البينية بين الأقطار العربية كخطوة أولى على التكامل؟ فالأقطار العربية ما زالت تستورد حاجاتها (التي لا تنتجها ولا يُسمح لها بإنتاجها) من خارج الوطن العربي. فعن أي تكامل نتكلّم؟ والغريب في كل ذلك أن مركز دراسات الوحدة العربية أقام أكثر من ندوة ونشر عدة أبحاث في ذلك الموضوع إذا أن مسودة المشروع لا تبني على القاعدة المعرفية التي أعدّها المركز خلال العقود الثلاث الماضية. وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الذي يعكس واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يتم التكلّم عنه إلاّ بشكل موارب وخجول. لتلك الأسباب وجدت من المفيد إعادة التذكير ببعض ما جئت به في دراستي عن الاقتصاد الريعي (دراسة من أكثر من سبعين صفحة!) كخطوة أولى للبحث في مشروع تنموي يفي بالغرض المطلوب.
المنطلق الرابع: الاقتصاد الريعي وثقافته وتداعيات تلك الثقافة
في هذه الفقرات التالية سيتمّ استعراض النتائج الأساسية للبحث السابق المذكور أعلاه عن الاقتصاد الريعي السائد في الوطن العربي .
الريع هو أحد مكوّنات الدخل القومي الذي يجمع أيضا الرواتب والأجور، الفوائد المالية، والأرباح الناتجة عن المشاريع الاقتصادية. جاء في “لسان العرب” تعريف للريع أنه “النماء والزيادة”، كما أضاف: قيل”هي الزيادة في الدقيق والخبز”. ومن مشتقات المصطلح “أرض مَريعة بفتح الميم، أي مُخصبة”. وينقل ابن منظور عن ابي حنيفة “أراعت الشجرة” أي كثر حملها، قال: “وأراعت الإبل: كثر ولدها”. كما أن “كل زيادة ريع”. أما البعد الثاني للمصطلح فهو مفهوم العود والرجوع كما حدّده أيضا “لسان العرب”. والبعد الثالث للمفهوم جاء من القرآن الكريم: أتبنون بكل ريع آية” بمعنى مكان مرتفع. كما لا بد من الإشارة إلى ما جاء في “المقدمة” لإبن خلدون عندما تكلّم عن “فوائد العقار والضّياع”. فيقول “أن القصد باقتناء الملك من العقار والضياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقه فيه ونشؤهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب” . فالعقار يدّر ريعا دون مجهود ما من مالكه ويعتبر من التأمين ضد المستقبل! في هذا السياق أشير إلى أن بن خلدون ميّز قبل 400 سنة من آدم سميث بين الربح والريع عندما أنّب الضعيف الذي لا يستطيع الكسب بالسبل الطبيعية فيلجأ إلى الحفر في الأرض لإستخراج المعادن وبيعها لتمويل الترف الذي كان يتنعّم به . والريع كما جاء في “لسان العرب” يساهم في تكوين الثروة كما كانت تفهم في ذلك الحين.
ومصادر الثروة آنذاك كانت التجارة والزراعة والغنيمة أي اقتناص الثروة من الغير! وعند “حصول الكثرة البالغة منه والعالي في جنسه وقيمته في المصر…ربما امتدّت إليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب” . فالغنيمة مفهوم أساسي في الثقافة العربية في تحديد الثروة والأمثال عديدة نحن بغنى عن سردها في هذا البحث.
إذا، الريع في “لسان العرب” مرتبط أولا بالزراعة وخاصة بتلك الأرض الخصبة التي تنتج أكثر من غيرها . كما أن الثروات الحيوانية هي أيضا مصدر للريع أي الزيادة الناتجة عن خصوبة الحيوان وخاصة الإبل. من هنا تتبلور مفاهيم عديدة أولاها المردود المتكاثر وغير المرتبط بمجهود ما. فخصوبة الأرض أو الإبل ليست ناتجة عن مجهود إنساني، بل بقدرة خارجة عن إرادة الإنسان . من هنا تبلّور الفضل الإلهي ويعزز ذلك المفهوم عدد من الآيات القرآنية التي تربط بين الرزق ومشيئة الله والتي تمّ استخدامها عن غير صواب لتبرير المفهوم الريعي كمصدر للثروة. والمعلوم أن القرآن الكريم يحثّ بشكل واضح على العمل والنشاط الاقتصادي وأن التحوير في التفسير هو من فعل الإنسان وما رافقه من انحطاط سياسي واقتصادي وثقافي في العالم العربي والاسلامي في القرون الأخيرة. لذلك يمكن القول أن ثقافة إنتاج الثروة عبر المجهود مُغيّبة إلى حد كبير في التراث العربي وإن كانت هناك تكاليف قرآنية واضحة تحثّ على العمل من أجل الكسب.
أما في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية للريع كما تُدرّس في الجامعات الغربية فالمنظّر الأول لها هو دافيد ريكاردو في مؤلفه المفصلي “مبادئ الاقتصاد السياسي والتكليف الضرائبي” الذي صدر عام 1817. حدد ريكاردو الريع كما يلي: “هو ذلك الجزء من إنتاج الأرض الذي يُدفع إلى صاحب الأرض كبدل لاستعمال القوى غير الفانية للأرض” . والمصطلح في أدبيات ريكاردو هو كلمة “rent” الذي يقترن دائما بمفهوم بدل الإيجار للشقق أو المنازل أو لأي نوع من العقار. غير أن التعريف الدقيق يبرز عدة عناصر يمكن تعميمها إلى عدد كبير من وسائل الإنتاج أو السلع أو المواقع الجغرافية أو حتى النشاطات. إن ما يربط جميع تلك السلع والنشاطات هو عنصر الندرة بالعرض وعدم إمكانية الاستبدال بسلعة أو نشاط أو موقع مماثل يعطي نفس النتيجة لمن يقدم على استعمالها. كما أن هناك اعتراف ضمني بالعامل الاحتكاري لموارد الإنتاج أو للسلعة المنتجة أو عدم وجود أي بديل مقبول للمورد أو للسلعة.
والملفت للنظر في نظرية الريع هو ارتباط عامل الإنتاج الأساسي لسلعة لها الطابع الإستراتيجي وإن لم يكن محصورا بذلك بالضرورة. ففي مطلع قرن التاسع عشر كانت الحروب النابليونية قد فرضت حصارا على بريطانيا العظمى أدّى إلى ندرة في مستويات العرض للقمح. أي بمعنى آخر كان القمح (السلعة الغذائية النمطية) السلعة الإستراتيجية بامتياز. أما اليوم، فيمكن استبدال القمح بالنفط أو اي سلعة لها طابع إستراتيجي ونادرة! أما الأدبيات في الاقتصاد السياسي الحديث فتعمّم مفهوم عامل الإنتاج إلى مصطلح أكثر شمولية وهو مفهوم العامل الداخل ((input مقارنة مع العامل الخارج ((output أو المنتوج. الشمولية في التعريف ضرورية لإدخال عناصر جديدة في تكوين مصادر الثروة والانتقال من عوامل الإنتاج الطبيعية كالأرض مثلا والعمل ورأس المال إلى مفاهيم أكثر تفاعلا ومساهمة في إنتاج الثروة كالموقع الجغرافي المميّز والخدمات المميّزة وكل من يمتلك السيطرة على سلعة أو خدمة ما مطلوبة في الاقتصاد الوطني أو الدولي ولا بديل فوري لها.
من جهة أخرى تُدرّس في معظم الجامعات الغربية نتائج الممارسات الاحتكارية في الأسواق التافسية الاحتكارية. هذا المفهوم هو الفائض الاستهلاكي المعروف باللغة الإنكليزية ب consumers’ surplus الذي يحاول اقتناصه المحتكر. هذا الفائض الذي يعود إلى المحتكر هو ريع بامتياز لأنه ليس ناتجا عن مجهوده الخاص، بل ناتجا عن موقعه الاحتكاري وتحكّمه بالكميات المعروضة. كما أن الأرباح الاحتكارية الناتجة عن الفائض بين سعر المبيع ومتوسط الكلفة للوحدة المنتجة هي أيضا ريع بامتياز. فكلما زاد ذلك الفارق كلما زادت نسبة السلطة الاحتكارية (degree of monopoly power). هذا بشكل سريع جدا ما يتعلّمه الطالب في السنة الأولى من برنامج الليسانس أو البكالوريوس في الاقتصاد.
أما على الصعيد العربي فلا بد من لفت الانتباه إلى ضرورة التمييز بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية التي يتكلّم عنها الباحثون. فهناك نوع من الخلط بين المفهومين حيث يُستعمل المصطلحان بشكل غير دقيق في الأبحاث. وإذا صعب التكلّم عن الاقتصاد الريعي دون التكلّم عن الدولة الريعية أو ايّهما فإن الفارق واضح بين الدولة ومؤسساتها والاقتصاد الشامل لتلك الدولة.
صحيح أن الدولة تختزل في كثير من الأحيان المجتمع واقتصاده غير أن طابع الدولة يعطي البعد السياسي والمؤسسي قبل أي شيء آخر بينما المجتمع وأو الاقتصاد يعالج الآليات التي يتّم من خلالها النشاط الاقتصادي بما فيه البعد السياسي. ونستطيع القول إن الدولة الريعية هي جزء من الاقتصاد الريعي ويتمّ البحث في الدولة من خلال مقارنة حجم الدولة في الاقتصاد ومصادر موارده .
ويركّز العديد من الباحثين في الدولة الريعية على الطابع الخارجي للريع، أي أن مصدره خارجي. فكما جاء في أطروحة الدكتوراه للباحثة ابتسام محمد سهيل فالدولة الريعية تعرّف “باعتبارها الدولة التي تستمد معظم دخلها، وبشكل أساسي ومنتظم من مصادر خارجية” . هذا التمييز ابتكره حازم ببلاوي في أعماله حول الدولة الريعية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي . أعتقد أن ذلك الوصف غير دقيق. فإذا كنت لا أنكر الطابع الخارجي لبعَض مصادر الريع التي تشكل أساس الثروة في عدد كبير من الأقطار العربية إلاّ أن الريع له مصادر داخلية لا تقّل أهمية عن المصادر الخارجية، بل ربما “أعرق” إذا جاز الكلام من الأخيرة. هناك ذهنية البحث عن الريع والتي تتبين في السعي الداخلي للحصول على مواقع إستراتيجية وامتيازات في الأسواق الداخلية كإجازات الاستيراد، أو الحماية الجمركية، أو إعفاءات ضرائبية، أو جمركية .
ويبرّر أصحاب نظرية المصدر الخارجي للريع بأن “وجود أشكال للريع الداخلي أو المحلّي، حتى وإن كان بنسبة كبيرة، إلا أنه لا يساعد على بلورة النمط الخاص بالاقتصاد الريعي” . وتضيف الباحثة أن “وجود ريع داخلي لا بد وأن يكون مستندا بالضرورة إلى قطاعات إنتاجية داخلية أو خارجية محليّة تشترك مع العناصر الريعية في الاستحواذ على نسبة أو قسم من هذا الناتج المحلّي نتيجة لتمتع هذه العناصر الريعية بمزايا خاصة أو قانونية أو فعلية” . وتستند الباحثة على أعمال حازم ببلاوي للتأكيد على أولوية العنصر الخارجي للريع . غير أن اختلافي مع هذه الحجة يعود إلى تغييب أولا الذهنية الريعية المذكورة سابقا وثانيا، عامل “السيادة” وممارستها على خطوط وشبكات التوزيع ناهيك عن المواقع الاحتكارية التي تخلقها تلك “السيادة”.
وبالتالي، فإن مصادر الريع في الوطن العربي تقسم إلى قسمين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. أما المصادر الخارجية فهي النفط والغاز والمعادن، وثمة الممرات الإستراتيجية كقناة السويس وأنبوب “سوميد” الذي يربط السويس بالبحر المتوسط. فالممرات كانت على عبر التاريخ محور إهتمام الدول والإمبراطوريات. فالممر المائي اليوم كما في الأمس كان وما زال مصدرا للريع بسبب الموقع الجغرافي الإستراتيجي للنقل البحري سواء لغرض تجاري أو عسكري. وهذه الممرات مقرونة بعامل “السيادة” المحصورة بمالك الممر – أي الدولة. فالممر الذي لا يوجد له بديل اقتصادي مقبول على صعيد الكلفة وأو الوقت يوّلد الريع. لذلك تصبح عائدات القناة والأنبوب ريعا بامتياز. أما المصدر الخارجي الثالث، فهو القطاع السياحي. عدد كبير من الدول العربية تمتلك آثارا هامة تجذب السياحة الدولية إليها. والدخل العائد للدولة “السياحية” هو نتيجة “السيادة” الداخلية والخارجية على التراث الثقافي التي تمكّن الدولة من الحصول على الموقع الاحتكاري للمدخول. ومفهوم ممارسة “حق السيادة” أساسي في فهم تكوين الريع لأنه يستغل القوة المتلازمة في اقتناص الفائض من المستهلك أو المستفيد من السلعة أو الخدمة التي “تمتلكها” الدولة صاحبة السيادة أو المحتكر صاحب المشروع الاقتصادي.
أما المصادر الداخلية للريع فهي تشمل معظم النشاطات الخدماتية التي يطغي عليها عامل السيطرة، وهو عامل أساسي لفهم نشأة الريع. فالتجارة تأتي بالريع عندما يستطيع التاجر أن يُفعّل السيادة على شبكات التوزيع كالاحتكار في النقل مثلا أو التحكّم بالعرض أو خلق حاجة غير موجودة أصلا من الرغبات الاستهلاكية التي توّلد الطلب. وإذا أردنا أن نلقي نظرة إلى التاريخ العربي نرى أن قريش كانت مسيطرة على أمور مكّة بسبب نفوذها الاقتصادي. ذلك النفوذ كان ناتجا عن المكانة المميّزة في إعداد قوافل الصيف والشتاء التي كانت تربط حركة السلع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبين الهند والصين وشرق إفريقيا وبلاد الروم وفارس. وهذه المكانة كانت بدورها ناتجة عن دور قريش في تحقيق خطوط القوافل الآمنة التي أقامتها عبر التحالفات والمعاهدات بين مختلف القبائل في المنطقة. لذلك مارست قريش “السيادة” في تأمين خطوط القوافل التجارية وجنت أرباحا بسبب الأمن الذي أوجدته. هذه الأرباح لم تكن مرتبطة لا بسعر أو بكلفة إنتاج السلعة بل بسبب الأمن المتوفر بمجهودها ومجهود القبائل الأخرى. كما أن احتكار قريش لخدمات الحج (السقاية مثلا) نتجت عن نفوذ قريش وساهمت في تغذية ذلك النفوذ. غير أن الفائض من الربح المتحقق هو الريع بعين ذاته تطبيقا للتعريف ولواقع الاحتكار في الأمن. فالسيادة تولّد الريع.
من هنا نرى أن قريش استطاعت توظيف مكانتها السياسية والعسكرية لتأمين مصادر ثروتها أي مكانتها الاقتصادية التي هي في دورها حصّنت مكانتها السياسية والعسكرية وبالتالي اكتملت الدائرة. ظواهر ريعية أخرى موجودة في كل من تجارة النفوذ (عامل السيادة) والمضاربات المالية والعقارية (أيضا عامل السيادة).
لا بد من التوقف بعض الشيء لنقاش حول طبيعة الخدمات. هذه الخدمات نشأت مع تطوّر الاقتصاد الرأس المالي الذي رافقه تطوّر سريع وواسع في التكنولوجيا في مختلف الميادين. فقطاع الخدمات يسمّى بالقطاع الثالث – أي بعد القطاع الأول وهو القطاع الزراعي – والقطاع الثاني أي قطاع الصناعة بشكل عام بما فيها الصناعات التحويلية والبناء والطاقة. والقطاع الخدماتي وظيفته الأولى خدمة نشاطات القطاعين الأول والثاني. فعلى سبيل المثال المنتج الزراعي أو الصناعي بحاجة إلى بيع منتوجه في الأسواق ومن هنا انبثق القطاع التجاري. فهذا النشاط الوظيفي يمكن أن يقام إما مباشرة من المنتج أو عبر وسيط. مع الوقت وبسبب التطورات في النظام الرأس المالي والتكنولوجيا عبر القرون أصبحت التجارة نشاطا قائما بحد ذاته متجاوزة الخدمة المباشرة للقطاعين الإنتاجيين. لم يتخلّ القطاع التجاري عن وظيفته الأولى، بل استطاع أن يخلق حاجات إضافية لم تكن موجودة في الأساس كالوساطة التجارية والبيع بالجملة.
كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية والأسواق التابعة لها. في البداية كان دورها الوساطة المطلوبة بين المدخّر وبين صاحب المشاريع التي هي بحاجة إلى تمويل. فالبورصة وظيفتها الأولى كانت تأمين رأس المال للمشاريع الجديدة. مع التطوّر الاقتصادي والمالي أصبحت مصدرا لريع مالي. فالأوراق المالية التي تصدرها الشركات المدرجة في البورصات من أسهم وسندات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والمشتقات عنها (derivatives) كانت في الأساس لتأمين الحاجات المالية للمؤسسات. وهنا أيضا مع الوقت تطوّرت الأمور فأصبحت تلك الأوراق مصدرا لتزايد في أسعارها بسبب المضاربة موّلدة بالتالي ريعا ماليا. ويمكن القول أن البورصة أصبحت مصدرا أساسيا في تقدير قيمة الشركات والمؤسسات التي تأخذ بعين الاعتبار في سياساتها ما يمكن البورصة أن تقوم به تجاهها. فالوسيط أصبح بشكل مباشر أو غير مباشر المقرر للقيمة! في مطلق الأحوال هذا باب للنقاش بين الاقتصاديين والمسؤولين في الشركات المنتجة والمؤسسات المالية التي تقوم بالوساطة.
بعد هذا العرض السريع للأسس النظرية للريع ومظاهره الحديثة في الاقتصاد عموما نتناول في هذا القسم مساهمة الاقتصاد الريعي في تكوين الثروة عند العرب من منظور تاريخي.
من الذين تحدثوا بشكل مسهب عن الاقتصاد أو بالأحرى عن النشاطات الاقتصادية في كتب التراث العربي الإسلامي هو ابن خلدون. فقد جاء في الفصل الخامس من الكتاب الأول ما يوازي ثلاثة وثلاثين فقرة (يسميها “فصل”) تعداد للصناعات والنشاطات الاقتصادية. فعنوان الفصل برمته معبّر وهو: “في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كلّه من الأحوال (وفيه مسائل)”. وابن خلدون يميّز بين النشاطات التي تؤدي إلى “معاش طبيعي” بينما “ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي” . وكذلك الأمر بالنسبة للخدمة المحصور وفقا لمفهومه ب “الجندي والشرطي والكاتب” . فمسؤولية الحاكم هي اقتطاع من بيت المال ما يلزم ل”يكفل أرزاقهم” عندما يقومون بالمهام المكلّفة بها.
فالمعاش الطبيعي مقرون بمجهود. “فالكسب الذي يستفيده البشر إنما هو قيم أعمالهم. ولو قَدّر أحد عطل عن العمل جملة لكان فاقد الكسب بالكلية. وعلى قدر عمله وشرفه بني الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته، وعلى نسبة ذلك نمو كسبه أو نقصانه” . ولكن المعاش الطبيعي المقرون بمجهود لا يعطي الجاه وبالتالي تصبح الفلاحة (أي الزراعة عند ابن خلدون) مقرونة ب “المذّلة” ويستشهد بمقولة بعض الأنصار “ما دخلت هذه دار قوم إلاّ دخله الذلّ” . من هنا نرى أن العلاقة بين المجهود والكسب يتنافى مع الجاه المقرون مع كثرة المال.
أما التجارة فهي “محاولة بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء، أيام كانت السلعة من دقيق، أو زرع أو حيوان أو قماش. وذلك القدر يسمّى ربحا” . وعلى ما يبدو لم تكن التجارة ذا مرتبة عالية عند ابن خلدون فهي”نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة” . وبالتالي كانت الصنائع أرفع من التجارة فهي “تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته” ، فرسوخها يكون برسوخ الحضارة. ويعود ذلك للتكرار وطول الأمد. نرى هنا أن ابن خلدون أعطى قيمة أساسية وأخلاقية للإقتصاد الإنتاجي كما سبق بعدة قرون نظرية آدم سميث المتعلقة بتطور السوق عبر تقسيم العمل الذي لا يكون إلاّ بالتخصص (ضرورة المعلم في الصنائع) والتكرار. وربما هذه سابقة أيضا لنظرية الإنتاج بالسلسه التي ابتكرها هنري فورد في مطلع القرن العشرين في صناعة السيارات.
والطريف في بحث ابن خلدون أن “العرب أبعد الناس عن الصنائع” بينما “أمم النصرانية عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها” ذلك لأنهم “أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه” . ويضمّ إلى تلك القافلة بلاد العجم والصين والهند وأرض الترك وأمم نصرانية استكثرت فيها الصنائع بينما عجم المغرب من البربر “مثل العرب” في عدم اتقانها!
أما “أمهات الصنائع” فهي تقسّم إلى الضروريات كالفلاحة والبناء والنّجارة والخياطة والحياكة، وإلى “الشريفة بالموضع” كالتوليد والكتابة، والوراقة، والغناء، والطب. نرى أن ابن خلدون عدّد معظم النشاطات الاقتصادية سواء كانت في الصناعة والخدمات (طب وتوليد) والزراعة والبناء التي كانت معروفة في ذلك الحين والتي ما زالت قائمة حتى الآن. وما يستوقف الانتباه عند قراءة ابن خلدون تشديده على الشق المعنوي المكتسب في الصناعة، فهي “تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة والحساب” أي أن العلم والمعرفة مقرونان بالصناعة. غير أن الصناعة لا تقود بالضرورة إلى الثروة. فهي (أي الثروة) تتكوّن بمجهود الأخرين ولذلك نرى الملوك والسلاطين يستولون على إنتاج الأخرين لتكوين الثروة.
أردت في هذه الفقرة أن أدّل على بعض الأمور التي تصبّ في سياق البحث المقدّم.
أول الملاحظات هي أن النشاطات الاقتصادية في تاريخ المجتمعات العربية دارت أولا حول التجارة والزراعة (أو الفلاحة كما يقول ابن خلدون) ومن بعدها تنوعت مع التطوّر الحضاري أو العمراني.
الملاحظة الثانية هي أن الكسب من الزراعة والصناعة لن يكون كبيرا بسبب المشاقة والمجهود ولأنه مقرون بمجهود فلا يهتم به الأعيان أو أصحاب النفوذ. وبالتالي تصبح الثروة من حصة الأقلية النافذة اي تتبيّن العلاقة العضوية بين الريع أو الغنيمة كمصدر للثروة والفئوية.
الملاحظة الثالثة أن هناك ميل للكسب دون مجهود إذا أمكن وذلك عبر الإستيلاء على مجهود الآخر أي الغنيمة. فالمجهود بالتراث ينظر إليه نظرة سلبية وهذا ما أكّده مؤخرا المؤرخ أحمد هنّي.
والسؤال الذي يمكن طرحه هو تداعيات ثقافة الاقتصاد الريعي في الوطن العربي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي العربي. يجمع الباحثون على أن الريع يوّلد ثقافة خاصة به . وهذه الثقافة تتلازم مع البنية السياسية القائمة التي يغذّيها توزيع الريع ويساهم في استدامة النظام السياسي والاقتصادي القائم. وتتلخّص هذه الثقافة بالنقاط التالية:
أولا-ثقافة الريع تتنافى مع ثقافة المجهود واقتران النتيجة بالمجهود وتحمّل المخاطر. فلا داعي لبذل أي مجهود لإنتاج الثروة ما دامت “واصلة” دون تعب و”بمشيئة إلهية”. فاقتناص مجهود الآخرين هو المجهود الوحيد المبذول من قبل الفئات التي تمتلك السيادة على المقدرات الاقتصادية والنشاطات التابعة لها . هذه الثقافة مدمّرة لأكثر من سبب. فإضافة إلى الابتعاد عن أساسيات الاقتصاد والمجهود لإنتاج الثروة وهذا ما يؤدي إلى اقتصاد ريعي واستهلاكي لا ينتج شيئا، فهناك تداعيات وخيمة تنسف الأخلاق وتعمم الفساد. هناك علاقة عضوية بين الهروب من المجهود وتحمّل المخاطر واللجوء إلى الفساد لتحقيق الغايات والأهداف. والهروب من المجهود والمخاطر يُجهض الطاقات والابداع ويؤدي إلى اضمحلال المجتمع. فالاقتصاد كجسم الإنسان. فإذا تخلّى المرء عن الرياضة (أي المجهود) يترهّل الجسم وينخره المرض. كذلك الأمر بالنسبة للمجتمع. كما أن الثقافة الريعية تتنافى مع مجهود وتضحيات التي تفرضها المقاومة للإحتلالات مما يّعطي تفسيرات عديدة للمواقف المخذية تجاه احتلال فلسطين والعراق والعدوان على لبنان!
والدليل على وأد الطاقات الإبداعية يتجلّى في النظام التربوي القائم. سأشير في الفقرات التالية إلى بعض ملامح تلك الظاهرة وإن لم تكن شاملة ووافية. لقد أشار التقرير الثاني للتنمية الإنسانية العربي والصادر عن برنامج التنمية للأمم المتحدة والصندوق العربي للتنمية إلى الحالة المزدرية للقطاع التعليمي بشكل عام وخاصة للتعليم العالي في قطاعات العلوم والأبحاث العلمية. فالجامعات العربية غير مستقلّة عن إرادة الدولة والنخب الحاكمة. وهذا يعني أنها تخضع للمشيئة السياسية لتلك النخب التي لا تريد تحفيز مشاركة الشرائح المختلفة من المجتمع عبر تشجيع الفكر النقدي والمسائلة في الحياة السياسية التي تيتمّ عادة عبر التفاعل داخل الجامعات. فالمكتبات رديئة والصفوف صغيرة والمختبرات العلمية مترهلة وجميعها لا تستطيع استيعاب العدد المتزايد من الطلاب وكل ذلك يساهم في تكبير الفجوة بين الطلاب والأساتذة . والتركيز على إبراز العدد المتزايد من الطلاب دون الإلتفات إلى نوعية البرامج التعليمية هو وسيلة سياسية لدرء الإنتقادات التي يمكن أن توجّه للنخب الحاكمة . فالزيادة في عدد الطلاب المنتسبين دون الإلتفات إلى نوعية التعليم ونوعية الطلاّب تعني “إنجازا” اجتماعيا وثقافيا تستثمره النخب الحاكمة لتبرير مختلف سياساتها المشكوك في جدواها لمصلحة البلد.
من جهة أخرى يؤكد التقرير على أهمية العلوم في بلورة نهضة عربية في تاريخ الأمة . وقد أذهب إلى أبعد من ذلك. فإذا كانت الأرض والرأس المال في القرنين الماضيين أساسين لإنتاج الثروة فإن العلم والمعرفة هما العاملان الأساسيان لإنتاجها في القرن الواحد والعشرين. فالعلوم – أي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية وعلم الفلك على سبيل المثال – هي أسس المعرفة الحديثة وللمستقبل فإن السيطرة على منابع المعرفة هي محور الصراع الخفيّ القائم لتمكين سيطرة تلك الدول التي تنتج المعرفة على سائر الدول. من هنا نرى إصرار الدول الغربية على إحتكار الأنواع المتقدمة في البحوث العلمية كي لا تنافسها دول صاعدة لها طموحاتها الخاصة.
أما على الصعيد الداخلي فأن الواقع الحالي في الدول العربية لا يبعث بالتفاؤل. فالإنتاج العلمي لن يتحقق إن لم تواكبة مؤسسات مختصة بذلك وليس هناك من دليل على ذلك. فعدد المراكز العلمية خارج الجامعات في الدول العربية لا يتجاوز 280 حيث مصر تحظى بحصة الأسد مع 73 مركز تليها الجزائر مع 30 مركز وتونس مع 24 مركز والعراق مع 22 مركز . فالإنفاق على البحوث العلمية والمختبرات لا يتجاوز 0.2 بالمائة من الناتج الداخلي لمجمل الدول العربية بينما يفوق 3 بالمائة للدول المتقدمة. وهذه النفقات تساهم فيها الدولة بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة في الولايات المتحدة بينما الصناعة تساهم بين 55 و70 بالمائة. أما في الدول العربية فمساهمة القطاع الصناعي لا يتجاوز 3 بالمائة في نفقات الأبحاث مما يؤكد القاعدة غير الإنتاجية في بلورة “المعرفة” في هذه الدول. ولماذا لا يكون الأمر على ذلك طالما أن الريع المتدفق ب”مشئية إلهية” يعفي النخب الحاكمة من بذل المجهود والإكتفاء باستيراد الخبرات من الخارج؟! وكأن هناك سياسة غير معلنة لنشر نوع من العلم الجاهل – أي العلم الذي لا يأتي بأي فائدة ملموسة تساهم في تطوير المجتمعات وتغذّي العقل الناقد والنقدي الذي يؤدي إلى المسائلة والمحاسبة وهذا ما لا ترضاخ النخب الفئوية الحاكمة التي تتحكم بالثروات الريعية.
على صعيد آخر فإن المؤشر الذي له دلالات بالنسبة للإبداع المكبوت وإن الم يكن قاطعا أو كافيا بحد ذاته فهو عدد البراءات المسجلّة . فالإبداع يشمل تطوير سلع جديدة ووسائل إنتاج جديدة وبرامج معلوماتية جديدة غير متوفرة بسهولة. أما فيما يتعلّق بالإمكانيات الإبداعية فيمكن قياسها في الأسواق الوطنية والخارجية. والحقيقة المرّة هي أنه ليس هناك من إبداع يذكر في الأسواق على الصعيد العربي مما يؤكد أن البحث العلمي القائم في الدول العربية لم يصل إلى مرحلة الإبداع . يشير تقرير التنمية الإنسانية أن عدد البراءات المسجلة لفترة 1980 – 2000 لم تتجاوز 360 بينما إسرائيل سجّلت أكثر من 7،650 براءة إختراع وكوريا أكثر من 16،000 . هذه هي بعض تداعيات ثقافة الاقتصاد الريعي والتي تؤثر على تعبئة الطاقات الإنتاجية والإبداعية.
ولا بد من الإشارة إلى التحوّل الذي يحصل في الدول الصناعية المتقدمة حيث نمت في الغرب خلال العقود الثلاثة الماضية ثقافة ريعية حلّت مكان ثقافة المجتمع الصناعي. وهذه هي إحدى التحوّلات الجارية في الرأس المالية في العالم. ومن تداعياتها تراجع التفوّق التكنولوجي الذي كانت تحتكره الولايات المتحدة . فالنموذج الاقتصادي (business model) المعمول به في الدول الغربية كالولايات المتحدة هو نموذج الوساطة التي لا تخلق شيئا وتتوهم أنها بإمكانها خلق الثروة من لا شيء وبدون أي رأس مال. فتمّ استبدال ثقافة الإنتاج بثقافة الصفقات وتقاضي العمولات غير المقرونة بالنتائج من ربح أو خسارة. تفيد التقارير المالية الواردة أن المؤسسات المالية العالمية في بريطانيا وألمانيا واليابان وسويسرا وطبعا الولايات المتحدة أقرضت ما يوازي بين 18 و60 أضعاف القاعدة الرأس المالية لديها (leveraging) مخالفة أبسط قواعد التيقّن والحذر من المخاطر المتمثل أولا بإيجاد قاعدة رأس مالية تتوازن مع حجم الإقتراض وتستطيع تحمّل الخسارة المحتملة وثانيا باتباع سياسة إقتراض مسؤولة ومبنية على جدوى المشروع وإمكانية تسديد الدين. هذا ما أدّى إلى الإنهيارات المالية في الولايات المتحدة في المؤسسات المالية العملاقة والتي قد تلحقها مؤسسات أخرى في العالم. فسياسات الاقتراض دون الارتكاز على إمكانية التسديد لدى المقترض وسياسات إقراض المؤسسات دون التأكد من الملاءة المالية والاقتصادية لكل من القارض والمقترض-كل ذلك مبني على الإعتقاد أنه بإمكان الحصول على ثروة دون أن يكون مقابلا لها في الثمن أو المجهود. وأيضا هناك إعتقاد من قبل المؤسسات القارضة أنه بإمكانها إسناد المخاطر إلى الآخرين. هذه خلاصة أزمة الرهونات العقارية التي هددّت وجود النظام المالي الدولي.
هذه الثقافة الجديدة في الغرب أضحت متأصلّة في الدول العربية حيث بذل المجهود لعقد الصفقات وتقاضي العمولات أصبح النشاط الطاغي في المجتمعات العربية خاصة بعد رحيل الرئيس عبد الناصر الذي حاول ترسيخ قاعدة إنتاجية مستقلّة قدر الإمكان للاقتصاد المصري. فكان قدوة في حقبة تاريخية عززت الشعور بالكرامة وإمكانية تحقيق الاستقلال الوطني والقومي، ولكن هذا حديث آخر.
ثانيا-أما على صعيد الدول العربية فإن ثقافة الريع المتفشية تساهم في تركيز قاعدة عدم الإنتاج وعدم معالجة المعضلات الاقتصادية أو السياسية واللجوء إلى “حلول” عاجزة عن أي حلّ. فالقدرات المالية التي يوفرّها إرتفاع أسعار النفط يسهّل للحكومات العربية النفطية وغيرها في المراوغة في معالجة القضايا الأساسية عبر إتباع سياسة إنفاق تهدف إلى تهدئة الخواطر أكثر من معالجة الأمور وكثيرا ما يشوبها الهدر والفساد. هناك دراسات وأبحاث عديدة تحلّل سياسات الإنفاق في الدول الريعية خلاصتها أن النخب الحاكمة تستعمل الإنفاق الحكومي لشراء الولاءات للنظام القائم .
فالدول النفطية تميّز بين رعياها والمقيمين العرب والأجانب عبر تمكين الرعايا وحمايتهم في نظام “الكفالة” المعمول به في دول الخليج. السمة الأساسية لهذه الدول هو توزيع الريع وفقا لمعايير سياسية اجتماعية محدّدة وخاصة بطبيعة الأنظمة المعمول بها. فالمنـتفعون من التوزيع هم رعايا الدولة دون سواهم. أما المقيمون فيها كعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن جنسيات مختلفة فلا حق لهم في الريع إلا في الأجور التي يتقاضونها وهي في معظم الأحوال متدنية. فعلى سبيل المثال اليد العاملة الآسيوية في مختلف دول الجزيرة العربية حقها في الخدمات الاجتماعية هو أقلّ من حقوق رعايا الدول. والملفت للنظر أن اليد العاملة الأجنبية سواء كانت آسيوية أو عربية أو غربية هي أكثر عددا من رعايا الدول التي يقطنونها وهذا ينذر بمشاكل سياسية واجتماعية في مستقبل قد لا يكون بعيدا. فدول اليد العاملة الآسيوية كالهند وباكستان (وهي دول كبيرة ونووية قريبة جدا!) قد تطالب في مستقبل قريب بتحسين الأوضاع الاجتماعية لرعاياها العاملين في دول الجزيرة العربية تمهيدا ربما لتكريس حقوق سياسية فيها تؤثر في سياسات تلك الدول، بل قد تضطر إلى دعوة دول رعاية اليد العاملة إلى المشاركة في توزيع الريع . لكن السؤال الذي يجب طرحه ولا يُطرح هو لماذا هناك يد عاملة آسيوية ومستوى البطالة مرتفع في الدول العربية وخاصة عند الشباب؟
ولا بد لي من الإشارة إلى الدراسة الهامة التي أعدّها الدكتور خلدون حسن النقيب والتي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية عنوانها “المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)” . جاء في تلك الدراسة أن “انتشار التعليم على نطاق واسع في بلدان الخليج والجزيرة العربية، وتحسّن المعيشة وارتفاع مستوى الدخل، عناصر تؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع مستوى الطموح بين أبناء الطبقات الوسطى والدنيا” . ويضيف قائلا: “ولكن أبناء هذه الطبقات يواجهون واقعا لا يعترف بهذا الحق، ويواجهون منغلقات للحراك تمنعهم من تحقيق طموحاتهم، ويشهدون استئثار النخب الحاكمة بالسلطة والثروة بشكل مثير، وهذا بطبيعة الحال يوّلد أوضاعا يزداد فيها الضغط على النظام السياسي، ويؤذن باندلاع صراع اجتماعي واسع النطاق بين النخب الحاكمة وعامة السكان” .
ثالثا-إن الخط الفاصل بين الخدمة العامة (public service) والمصلحة الخاصة ملتبس إلى حد كبير في الاقتصادات الريعية . فعلى ما يبدو ليس هناك من تناقض في المصالح عند المسؤولين الرسميين وأصحاب القطاع الخاص. فالوزراء في كثير من الأحيان ينشئون شركاتهم الخاصة وهم في سدّة المسؤولية الحكومية وهي ظاهرة غير موجودة في الدول المتحضرة. ولا يجدون أي حرج في استخدام مواقعهم الرسمية لدعم مصالحهم الخاصة سواء بشكل مباشر أو عبر أسماء مستعارة . إضافة إلى ذلك أصبحت الحكومة الموظف (بكسر الظاء) الأساسي في الدول العربية، بل المحرك الاقتصادي للنمو. إن معظم نشاطات القطاع الخاص مرتبطة بعجلة الإدارة. فإذا أنفقت الحكومة ازدهر القطاع الخاص عبر العقود (تلزيمات) التي تمنحها. وهذه العقود تعطى للمقربين أو المرتبطين برموز النظام. أما في أيام الكساد كما حصل في النصف الثاني من الثمانينات والتسعينات عندما انخفضت أسعار النفط ونتيجة كلفة حرب الخليج والعجز في موازنات الدول كادت تتوقف عجلة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. إلا أن الدولة اختارت أن تكون ربّ العمل لمواطنيها وإن كانت توجهات النظام والمجتمع لمصلحة النشاط الفردي في القطاع الخاص. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يحق لكل مواطن سعودي العمل في إطار إدارات الدولة. إضافة إلى ذلك فإن القوانين المعمول بها في المملكة تفرض على الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أن توظّف عددا من المواطنين السعوديين وفقا لنسب تحددها إدارات شؤون العمل الرسمية.
ويعتبر العديد من المسؤولين في تلك الشركات أن تلك النسب للتوظيف هي بمثابة ضريبة على أعمال الشركة خاصة وأن إنتاجية الموظف السعودي قد لا تتوافق مع متطلبات ربّ العمل الأجنبي. على كل حال إن ذلك تفصيل والعبرة هي في رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء التوظيفية عنها من جهة كما أن هناك أيضا رغبة في بناء ثقافة العمل والتقليل من الاتكال على الإدارة العامة كمصدر للعمل كما أنها طريقة غير مباشرة في توزيع الريع لمواطنيها عبر الشركات الأجنبية.
رابعا-ينتج عن الاقتصاد الريعي وثقافته طبقة اجتماعية لا تمثّل أكثرية المواطنين، بل الأقلية منها. فإذا كانت الدولة الجهة المتحكمة بتملّك الريع الخارجي إلاّ أن فئة محدودة العدد من النخب السياسية الحاكمة تحصل على الريع الخارجي بشكل مباشر، “بينما يقتصر دور الأغلبية من السكان على الاستفادة من بعض استخدمات هذا الريع، بحيث أن ما ينشأ عن ذلك من أنشطة اقتصادية تابعة يرتكز أساسا على المصدر الأساسي للريع” . والتمايز بين هذه “الأقلّية” الحاكمة والمستئثرة بالقوة السياسية والاقتصادية والأكثرية المكوّنة من سائر المواطنين والسكان يخلق التناقضات السياسية والاجتماعية التي تهدد الأنظمة والكيانات الوليدة من الحقبة الاستعمارية.
خاتمة
حاولت في هذه “المحاولة” عرض بعض شجون اقتصادية وسياسية في آن واحد وإن كانت بشكل سريع. آمل أن الأفكار المطروحة (جميعها أو بعضها) تصبح في مستقبل قريب محور مناقشات وأبحاث بعيدة عن الحلول التقليدية للمشاكل الاقتصادية التي نواجهها. أعتقد أنه من الضروري بلورة أدوات تحليلية منسجمة مع واقعنا وليس منبثقة عن تجارب الغير. فمشروعنا العربي النهضوي هو الرد الإستراتيجي على كافة المحاولات الخارجية لإخضاع الأمة إلى المشيئة الخارجية. وبالتالي فإن الشق الاقتصادي لذلك المشروع تحت عنوان “التنمية المستقلة” يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي أي الاقتصاد الريعي القائم وارتباطه بالبنية الفئوية المسيطرة على النظم السياسية القائمة.
د.زياد الحافظ..كاتب وباحث اقتصادي من لبنان والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي