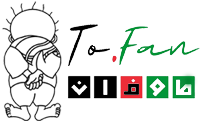إلى أي مدى سينجح ترامب في تمرير سياسة الانفتاح على روسيا؟ والسؤال الأهم بالنسبة إلينا في الجنوب العالمي فهو: إلى أي مدى ستبتلع روسيا الطعم؟
تداول محللون كثر، بعيد الانهيار الكبير في سوريا، فكرة إجراء روسيا مقايضة بين أوكرانيا وسوريا، تتخلى بموجبها عن دعم الثانية في مقابل تسوية بشروطها في الأولى. وما يعزز تلك الفرضية طيفٌ من المؤشرات والدلائل، التي أظهرت تواطؤاً روسياً في عملية “تغيير النظام” في دمشق، في 8/12/2024، والتي سبق التطرق إليها في مادة “لماذا حدث الانهيار الكبير في سوريا؟”.
لكنّ المقايضة الروسية على سوريا، على عكس ما يذهب إليه أولئك المحللون، لا يمكن أن تكون جرت مع الإدارة الأميركية التي يتربع بايدن، ومن خلفه الدولة العميقة في الولايات المتحدة، على رأسها، وكلاهما مُعادٍ بشدة لروسيا، وكانا يبذلان أقصى الجهود، مالياً وسياسياً وعسكرياً، لدعم نظام زيلينسكي حتى الرمق الأخير، بل جرت المقايضة الروسية، وفق رأيي المتواضع، على مستوى إقليمي، مع نظام إردوغان من جهة، والعدو الصهيوني من جهةٍ أخرى. وهي مقايضة جاءت تتويجاً للضغط الروسي المتواصل على الرئيس بشار الأسد كي يلتقي أردوغان، من دون انسحاب تركي من الشمال السوري، وكي يعقد معاهدة “سلام” مع العدو الصهيوني برعاية روسية.
كانت مقاومة الرئيس الأسد للضغوط الروسية، ورفضه التنازل عن سيادة سوريا، في الحالتين، سبب تخلي روسيا عنه في لحظة النهاية، وعلى مدى سنوات من قبلها، أولاً عندما رفضت روسيا المساهمة في حل أزمة مشتقات الطاقة في سوريا المحاصَرة من فائضها النفطي والغازي العميم، وخصوصاً بعد دخول “قانون قيصر” الأميركي موضع التنفيذ سنة 2020، وثانياً عندما نسقت مع العدو الصهيوني في الساحة السورية، وخصوصاً في جنوبيها، وعندما حرمت سوريا حتى من إمكان استخدام منظومة “أس-300” في مواجهة الغارات “الإسرائيلية” المتصاعدة، في عز الحملة الروسية المحمومة لتسويق منظومة “أس-400” دولياً، ومنه لتركيا، ولو بقروض روسية سخية بشروط مخفّفة.
نقول إن تخلي روسيا عن الرئيس الأسد، بعد استخدام سوريا منصةً لتعزيز حضورها إقليمياً، والذي كان قيمة مهملة قبل 30/9/2015، كان أحد العوامل الرئيسة التي سهلت “تغيير النظام”، ولا نقول إنه العامل الرئيس الوحيد.
التقط تلك النقطة الرئيسُ المنتخب ترامب، عشية ذلك التغيير، مغرّداً في منصة “تروث سوشال” في 8/12/2024، وقال إن الأسد رحل لأن روسيا لم تعد معنية بحمايته، وعزا ذلك إلى انشغالها بحرب أوكرانيا، داعياً إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في التغريدة ذاتها، فيما يبدو أنه محاولة للحاق بتطورات المشهد السوري.
لو كان ترامب صانع الحدث السوري، في صفقة مع بوتين، لما فسره بضعف روسيا وخسائرها في أوكرانيا، والتي زعم أنها بلغت 600 ألف جندي بين قتيل وجريح في المنشور ذاته، مع العلم بأن الضغوط الروسية على سوريا للتنازل إزاء النظام التركي والكيان الصهيوني سبقت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بكثير.
أكد ترامب بعد ذلك فكرة سيطرة تركيا على الميدان السوري، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في فلوريدا، في 16/12/2024، قائلاً إن ما جرى في سوريا يمثل “عملية استيلاء غير ودية قامت بها تركيا، من دون ضياع كثير من الأرواح”، مضيفاً أن إردوغان “شخص ذكي جداً”، ينسجم هو معه، أي أن المكسب لتركيا، لا للولايات المتحدة.
لم يكن ترامب، كرئيس منتخب في لحظة “تغيير النظام” في سوريا، على وشك أن يستلم الحكم رسمياً حتى 20/1/2025. ولو أخذنا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نموذجاً عمّا يمكن أن يفعله ترامب، قبيل استلامه سدة الرئاسة، وهو اتفاق فُرض بإشراف مباشر من ستيفن ويتكوف، مبعوث ترامب، في يوم سبت، ودخل حيز التنفيذ قبل يومٍ واحدٍ فقط من تنصيب ترامب رئيساً، كي لا يُنسَب الفضل فيه إلى إدارة بايدن، وكي يكون الجو هادئاً في حفل تنصيبه، لأخّر ترامب عملية “تغيير النظام” في سوريا شهراً واحداً على الأقل، لو قُيض له ذلك، ولرأينا ويتكوف في روسيا قبيل 8/12/2024. وكان ترامب، لو نظرنا ملياً إلى طبيعته الاستعراضية، يتمنى لو استطاع أن ينسُب “فضل” إطاحة الرئيس الأسد إلى نفسه، كما فعل رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني نتنياهو في فيديو من حِفاف الجولان المحتل.
إن بقاء القواعد الروسية في سوريا، بعد استيلاء النظام التركي “غير الودي” على سوريا، وبروز دور روسي محتمل في المشروع الصهيوني لإقامة محميات طائفية وعرقية في سوريا لامركزية، من بوابه “حماية العلويين في الساحل”، يُظهر هوية الجهات التي تنازلت لها روسيا في سوريا، ولو بذريعة الانشغال بالحرب الأوكرانية.
أما أوكرانيا، فمركز ثقل الصراع فيها دولي، لا إقليمي شرق أوروبي فحسب، وهو ميدان أوسع من سعي روسيا لكسب نظام إردوغان والكيان الصهيوني إلى صف روسيا عبر المقايضة على الورقة السورية، بعد توظيفها حتى النهاية كرافعة جغرافية – سياسية لمد النفوذ الروسي إقليمياً. فالورقة الأوكرانية تحدد موازين القوى الدولية، لأنها تمثل استنزافاً مباشراً لروسيا، وبالتالي فهي أهم كثيراً، أميركياً وروسياً، من الورقة السورية.
يتصل الشأن الأوكراني، إذا جرت الرياح في أشرعة سفن صفقة ترامب – بوتين بشأنه كما يشتهيان، بانكشاف أوروبا أمنياً أولاً، ولاسيما أوروبا الغربية، بما تمثله من وزن، اقتصادياً وسياسياً، يزداد تضاؤلاً وتهميشاً في العالم بمقدار تناغم روسيا والولايات المتحدة.
كما يتصل الشأن الأوكراني بقيمة “حلف الناتو” كتحالف عسكري عُقد سنة 1949 بين أوروبا الغربية وأميركا الشمالية في مواجهة روسيا ثانياً، وكأساس للهيمنة الغربية عالمياً.
ويتصل الشأن الأوكراني، ثالثاً، بالصراع الأيديولوجي المحتدم، ضمن الغرب الجماعي ذاته، وعلى المسرح الدولي، بين قوى العولمة المأزومة بنيوياً من جهة، وبين المد الصاعد المناهض لها، والذي يتخذ صورة دول مركزية مستقلة، أو صورة حركات تحرر، كل منها لأسبابه.
يناهض تيار ترامب العولمة باسم الحرس القديم للدولة الإمبريالية، بالمعنى الكلاسيكي للإمبريالية، كما ورد في كتاب لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية”. وهو تيار يحلم باستعادة “المجد المفقود” للولايات المتحدة بُعيد الحرب العالمية الثانية، وبإعادة إحياء المنظومة الدولية التي تتربع “أميركا” على رأسها، بصفتها دولة قومية مستقلة مهيمنة، محددة المعالم، يحكمها رأس مال قومي الهوية والانتماء، لا بصفتها مشاعاً معولماً لرأس المال المالي الدولي المنفلت من قيود الجغرافيا والهوية.
ولا تناهض روسيا والصين العولمة الاقتصادية تحديداً من حيث المبدأ، وإنما تسعيان حثيثاً للمشاركة فيها، وجني ما تعدانه ثمراتها، لكنْ بصفتهما دولتين قوميتين مستقلتين صاعدتين، استفادتا من وزنيهما اقتصادياً في ظل العولمة من أجل تعزيز حضورهما الجغرافي-السياسي دولياً، وأخذ مكانتيهما تحت الشمس في هذا العالم، بتلك الصفة المستقلة، بدلاً من السماح لرأس المال الدولي أن يفكك مجتمعيهما والجغرافيا السياسية لكلا البلدين تحت لافتة العولمة.
ثمة فارق كبير طبعاً بين المهيمن والصاعد، وتكمن مصلحة الأمة العربية وكل شعوب الأرض في تعددية الأقطاب الدولية، لا في أحاديتها، كما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991. وثمة فوارق أخرى بين طبيعة الدولة في الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، كثيراً ما تغيب عمن يضع كل القوى العظمى في سلة واحدة، ومنها دور الدولة في الاقتصاد، ووزن القطاع العام فيه، ومدى الحساسية إزاء “الحس الاجتماعي”، في مقابل “الحس الفردي”، في إدارة الشؤون العامة، والأهم، مدى اندماج النخبة الحاكمة في الحركة الصهيونية العالمية طبعاً، والتي تمثل نفوذاً يهودياً عالمياً لا يقتصر على احتلال فلسطين، وهي النقطة التي يغفل عنها كثيرون من مناهضي الصهيونية.