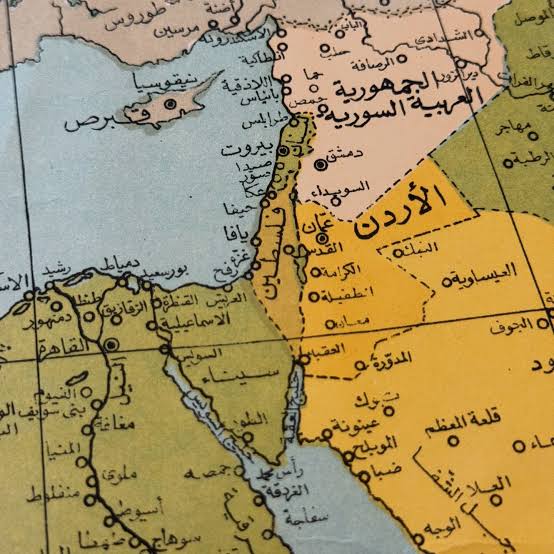لا يمكن فهم الانسداد السياسي المزمن في الوطن العربي من دون تفكيك الخلط المقصود بين الدولة والسلطة. فالدولة، في معناها التاريخي، ليست مباني ولا دساتير ولا أجهزة، بل شكل لتنظيم الصراع الاجتماعي وإدارته ضمن توازن قوى محدد. أما السلطة فهي القوة التي تمسك بهذا الشكل مؤقتًا وتديره باسم المجتمع.
غير أن هذه العلاقة تنقلب رأسًا على عقب في التجربة العربية الحديثة.
السلطة لا تُمارَس داخل الدولة بل فوقها، والدولة لا تُبنى كإطار عام، بل تُختزل إلى أداة في يد فئة ضيقة، أو جهاز ضبط يعمل ضد المجتمع لا من خلاله.
لم تتكوّن الدولة في الوطن العربي كنتيجة لصراع اجتماعي داخلي ناضج، بل وُلدت مشوّهة منذ البداية. إما كوريث إداري للاستعمار، أو كنتاج انقلاب عسكري، أو كتسوية فوقية رعتها قوى خارجية. لذلك لم تتحول إلى ساحة تمثيل أو تنظيم للمصالح المتناقضة، بل بقيت جهازًا مفصولًا عن المجتمع، بلا جذور طبقية واضحة، وبلا شرعية مستمدة من الإنتاج أو المشاركة السياسية.
هذا الفراغ البنيوي هو ما سمح للسلطة بأن تتحول من وسيلة إدارة إلى غاية بحد ذاتها، تُحتكَر وتُورَّث وتُحصَّن بالقوة.
في هذا السياق، تبدو قوة الدولة التي تتباهى بها الأنظمة العميلة وهمًا لغويًا. فالتضخم الأمني والعسكري، واتساع البيروقراطية، وتشديد القوانين، لا يعكس دولة قوية، بل سلطة خائفة. والدليل أن هذه الدولة المزعومة تتفكك أو تنهار عند أول اهتزاز جدي في رأس النظام، لأن المؤسسات لم تُبنَ لخدمة المجتمع، بل لحماية بنية الحكم. ما يسقط في الأزمات ليس النظام فقط، بل يتكشف غياب الدولة نفسها.
وحين تعجز السلطة عن تنظيم المجتمع سياسيًا على أساس المصالح الاجتماعية، تلجأ إلى الطائفية لا بوصفها بقايا تقليد، بل كأداة حديثة للإدارة. الطائفة هنا لا تعمل كهوية ثقافية، بل كوحدة ولاء وضبط، تُفتّت المجتمع إلى جماعات متناحرة وتمنع تشكّله كقوة سياسية موحّدة. وبهذا التحول، يُنقل الصراع من كونه صراعًا على الثروة والقرار إلى صراع وجودي بين جماعات، تُدار من فوق وتُستنزف من تحت.
الطائفية لا تلغي الدولة فقط، بل تلغي المجتمع ذاته، وتمنح السلطة غطاءً زائفًا بوصفها ضامن التوازن أو حامي الوجود.
في قلب هذا النموذج يقف الجيش. ما يُفترض أن يكون أداة دفاع عن كيان سياسي جامع، يتحول إلى عمود السلطة الفعلي. لا يخضع لإرادة اجتماعية، ولا لرقابة مدنية، بل يملأ الفراغ الذي خلّفه غياب الدولة. يصبح حزبًا حاكمًا مسلحًا، أو شركة أمنية كبرى، أو وسيطًا إقليميًا بالنيابة، يحتكر تعريف الدولة نفسها. لذلك، حين تهتز السلطة، لا ينحاز الجيش إلى المجتمع، لأنه لم يكن يومًا جزءًا منه، بل فوقه.
ويتكامل هذا كله مع الدولة الريعية، حيث لا تقوم العلاقة بين السلطة والمجتمع على الضرائب والإنتاج، بل على توزيع الريع،نفطي، أو مالي، أو جيوسياسي. في هذه الصيغة، لا حاجة لمجتمع سياسي منظم، ولا لمساءلة، ولا لتمثيل. المواطن يتحول إلى مستهلك أو زبون، والدولة إلى شركة توزيع، والسلطة إلى مدير امتياز مرتبط بالخارج. ومع كل أزمة ريعية، تُستدعى الأدوات نفسها.
القمع، والطائفية، والجيش، لتعويض غياب السياسة.
لكن هذا النموذج لا يكتمل من دون دوره الخارجي. فالسلطة العربية لم تُنتَج رغم الغرب الرأسمالي، بل من خلاله. بعد نهاية الاستعمار المباشر، أُعيد إنتاج السيطرة عبر نخب محلية، وجيوش بعقيدة أمنية، ودول صُممت لضبط الداخل لا لمواجهة الخارج. ما يريده الغرب ليس دولًا ذات سيادة أو مضمون اجتماعي، بل سلطات مستقرة، أسواق مفتوحة، ومجتمعات مفككة سياسيًا.
لهذا يُقاس النجاح بمعيار واحد.
الاستقرار، أي أمن المصالح وتدفق الموارد، لا العدالة ولا التمثيل.
كل محاولة لبناء سياسة شعبية مستقلة تُصنَّف فورًا كفوضى أو تهديد. تُعاد تدوير النخب نفسها تحت عناوين انتقال منضبط أو إصلاح محسوب. تُستثمر الطائفية، ويُعاد تعريف الجيش كشريك أمني، وتُقدَّم الدولة الريعية كنموذج مثالي للتبعية. وحين تنفجر المجتمعات، ينكشف الدور الحقيقي. ليس دعم التغيير، بل حماية البنية، حتى لو تغيّرت الوجوه.
لهذا يستمر هذا النموذج رغم فشله الاجتماعي. فهو يخدم السلطة التي تحكم بلا مساءلة، ويخدم الغرب الرأسمالي الذي يدير مصالحه بلا مقاومة، فيما يُترك المجتمع معلّقًا بين القمع والانقسام. لكنه نجاح مؤقت، لأنه يراكم التناقضات بدل حلها، ويفرغ الدولة بدل بنائها، ويؤجل الصراع إلى لحظة يعود فيها أعنف.
المعركة في الوطن العربي ليست بين نظام ومعارضة، بل بين مجتمع يسعى إلى دولة تعبّر عنه، وسلطة تريد البقاء بلا مجتمع. وأي مشروع تحرري لا يبدأ بتفكيك هذه البنية المركّبة الريع، والعسكر، والطائفية، والوصاية الخارجية،سيُعاد ابتلاعه داخلها، مهما بدا راديكاليًا في شعاراته.
ولا يبدأ هذا الصراع من المجتمع بوصفه كُلًّا مكتملًا، لأن هذا الكل لم يعد موجودًا أصلًا. يبدأ من شقوقه. من نُوى اجتماعية جزئية تتكوّن داخل الخراب نفسه.
في أماكن العمل الهشّة، في الأحياء المهمّشة، في هوامش المدن، وفي متاهات العيش القسري التي أنشأها الانهيار لا الدولة.
هناك، حيث لا تمثيل ولا حماية ولا أفق، تتشكّل السياسة لا بوصفها اختيارًا واعيًا، بل بوصفها ضرورة وجودية.
تفكك المجتمع ليس نقيض السياسة، بل مادتها الأولية القسرية. فالسلطة حين حطّمت الروابط العامة لم تُلغِ الصراع، بل حرّرته من أوهام الوحدة الزائفة. ومن داخل هذا التفكك، يبدأ الصراع كفعل جزئي، غير مكتمل، غير نقي، لكنه حقيقي. لا كبرنامج جاهز، بل كاشتباك مباشر مع منطق الحكم نفسه.
الدولة التي نريدها لا تُمنَح، ولا تُستعار من الغرب، ولا تُبنى بمرسوم أو دستور.
تُنتَج عبر الصراع،
وتُنتَزع من السلطة،
وتُعاد إلى المجتمع.
وحتى يحدث ذلك، ستبقى السلطة قوية،
والدولة وهمًا،
والمجتمع ساحة مفتوحة للقمع والانقسام.
إلى أن يُعاد إدخال الصراع إلى مكانه الطبيعي.
بين من يُدير الخراب،
ومن يعيش فيه ويرفض أن يُدار إلى الأبد.
بقلم عبدالله عبدالله،،