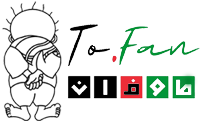مخيم شاتيلا: كيف يتحوّل الإنسان إلى “حالة”؟
مروان عبد العال
منذ ولادته من رحم النكبة، عاش مخيم شاتيلا على تخوم النار؛ لا يهدأ له جرح، ولا ينام له شهيد. كلما حاول المخيم أن يلتقط أنفاسه، أعيد إليه الألم والمأساة من جديد. لم يكن شاتيلا يومًا مجرد حي فقير على أطراف بيروت، بل كان شاهدًا حيًا على واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث. ففي عام 1982، ارتُكبت فيه مجزرة أرادت محو ذاكرة الإنسان معًا.
منذ ذلك اليوم تغيّرت الوسائل، لكن ظل الهدف واحدًا: إلغاء المخيم كرمز للعودة، وتحويله من فضاء وطني إلى ملف أمني أو عبء اجتماعي. بالأمس، استُخدمت “تهمة التوطين” لتبرير الحصار والتجويع، واليوم تُرفع “تهمة المخدرات” لتشويه الوعي واغتيال المستقبل. كما وصفها غسان كنفاني في قصة «أبعد من الحدود»: تحويل اللاجئ من إنسان إلى “حالة”، حيث يُذوّب الإنسان في كابوس جماعي، فيصبح الطبيب والمريض واللص والشرطي مجرد لاجئ، بلا هوية، بلا ذاكرة، بلا مستقبل.
لم تعد الحرب تُشنّ بالدبابات، بل بالسموم البطيئة والدعاية المسمومة، لتغرق الأحياء في الفوضى واليأس والإدمان. يُستبدل المقاتل بالمدمن، والحلم بالهلوسة.
ويظن البعض خطأً أن تصوير المخيمات الفلسطينية في لبنان على أنها معاقل الفساد والانحلال أمر سهل. لطالما كانت ثقافة الكراهية أداة فعالة لتشويه صورة المخيمات، لتعليق مسؤولية الخراب الاجتماعي والاقتصادي عليها، ولتحميل الفلسطينيين وزر ما يحدث.
أما المقالات التي تناولت المخدرات والترويج لها بين بعض الأطراف، فهي لا تقل سوءًا عن الحملات الطائفية نفسها، إذ تختزل واقعًا معقدًا إلى ثنائية ضيقة: الفلسطينيون مجرمون، وغيرهم ضحايا. بين المروّج والمتعاطي، تُستخدم لغة التعميم وبنبرة طائفية صريحة في كل سطر.
أولًا: افتراض أن المخدرات تخص طائفة معينة هو افتراض باطل. التاجر يبيع لمن يدفع بغض النظر عن الانتماء الطائفي، والمخدرات ظاهرة اجتماعية واقتصادية قبل أن تكون طائفية. تحميل طائفة بعينها مسؤولية هذه الآفة هو ضرب مباشر للحقائق.
ثانيًا: استهداف المخيم على أنه “وكر للمخدرات والهاربين من العدالة ومستودع للسلاح” وتضخيم الأخطاء الفردية، هو استخدام للصورة النمطية لتشويه المجتمع الفلسطيني بأكمله. المخيمات، رغم الضغوط الاجتماعية والسياسية، ليست مجرد معاقل للجريمة، بل هي مساحات حياة مليئة بالتحديات اليومية.
ثالثًا: تحميل الفلسطينيين مسؤولية أخطاء الأفراد مغالطة صارخة. في المقابل، تجاهل العوامل الأساسية—الفقر، البطالة، سياسات الدولة اللبنانية تجاه المخيمات—هو تجاهل متعمد لجذر المشكلة. كل ما يحدث في المخيمات جزء من حرب مستمرة تستهدف الوجود الفلسطيني، حيث تصبح الضحية مضاعفة: مرة بالحرمان، ومرة بالأفات الاجتماعية القاتلة.
رابعًا: استحضار الزمن المليشياوي القديم وممارسة الطائفية التي انتهت منذ عقود ليس نقدًا، بل نكء لجروح قديمة لتبرير الإساءة الحالية. هذا النهج لا يخدم الحقيقة، بل يكرس الانقسام ويغذي خطاب الكراهية.
خامسًا: تحسين صورة المخيمات وأهلها لا يتحقق بتصويرهم بصورة أحادية أو بحملات مسيئة. المسؤولية ليست فلسطينية وحدها، بل تتحملها الدولة اللبنانية والمجتمع والإعلام والسياسيون الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في خنق المخيمات وتجويعها وإذلال أهلها.
خاتمة: الحقيقة أن مخيم شاتيلا، مثل أي إنسان مضطهد، يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وإنسانية هائلة. تصويره وكأنه عدو للمجتمع اللبناني أو لأي طرف هو جريمة أخلاقية قبل أن تكون سياسية. المطلوب مواجهة الأسباب الحقيقية للمشاكل، والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش بكرامة، بعيدًا عن الوصم والتشهير. المخيم الذي نجى من المجزرة لن يموت بجرعة سم بطيئة، ولا ببروباغندا حاقدة.