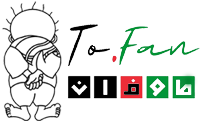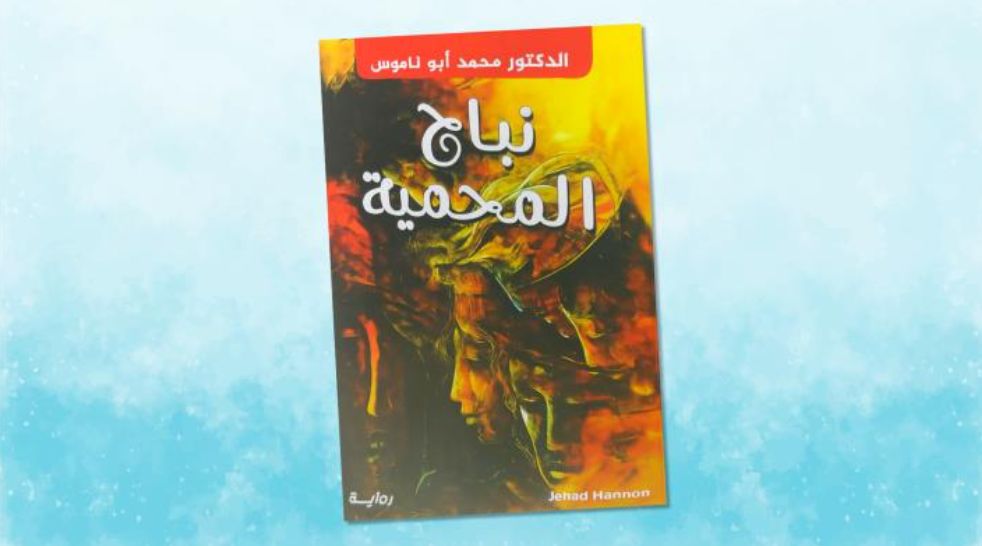تحليل”نباح المحمية”: الإنسان حين يفقد قدرته على الحلم
مروان عبد العال
في روايته “نباح المحمية” (108 صفحات، منشورات دار بعل ـ دمشق)، يقدم الدكتور محمد أبو ناموس نصًا هجائيًا تمتزج فيه السخرية بالتحليل السياسي والفلسفي، حيث يتحول النباح من فعلٍ حيواني غريزي إلى فكرٍ يعكس هشاشة الإنسان وفقدانه للحرية. منذ العنوان، يوضع القارئ أمام مفارقة حادة: كيف يمكن للنباح، رمز الانقياد والغريزة، أن يصبح لغة تفكير، وفي الوقت نفسه يفضح الإنسان الذي فقد قدرته على المقاومة والحلم؟ هذه المفارقة ليست لغوية فحسب، بل تمثل لبّ المشروع السردي، الذي يكشف كيف تُدار المجتمعات كما تُدار قطعان الكلاب، وكيف يتحوّل الانضباط إلى طاعةٍ مقدسة، والوفاء إلى عبوديةٍ مشرّعة.
بطل الرواية، أبو الكلب، ليس إنسانًا بالمعنى المتعارف عليه، ولا حيوانًا تمامًا؛ إنه كائن متشظٍ يقف على حافة النوعين. رجل في منتصف العمر، أشيب الشعر، قصير القامة، مدخن شره، نحيل القوام، يعيش في منطقة رمادية بين وعي الإنسان وغرائز الحيوان. هذا التماهي مع الكلاب ليس عبثًا ولا جنونًا، بل احتجاج وجودي على عالمٍ بشري أكثر انحطاطًا من الحيوانية نفسها. حين يعجز الإنسان عن ممارسة إنسانيته بحرية، يصبح الكلب مرآته البديلة، والصديق الذي لا يخون ولا ينافق.
يبني أبو ناموس عالمه الروائي من قطيعٍ متنوع: كلاب بوليسية تمثل أجهزة القمع، ضالة تمثل المهمّشين، هرمة تمثل الماضي المتهالك، ومدرّبة تمثل طبقة التابعين التي تتقن فنّ الخضوع. وبينها تظهر فلفل، الكلبة التي تتبختر بمشيتها وتفتن أبا الكلب، رمزًا للجمال الذي يُستثمر في خدمة السلطة والإغواء، وبندق الذي يجسّد الفطرة الطيبة التي لم تفسدها اللعبة بعد. كل فصيلةٍ في الرواية تؤدي وظيفةً رمزية دقيقة، حتى يتحول القطيع إلى استعارة كاملة للمجتمع البشري، حيث تُوزع الأدوار على أساس الولاء لا الوعي، ويصبح النباح اللغة الرسمية للوجود.
الفلسفة التي تستند إليها الرواية تعيدنا إلى أفكار المفكر الأميركي إريك هوفر، صاحب كتاب “المؤمن الصادق”، الذي يرى أن الطغيان لا يُنتجه الطاغية وحده، بل الجماهير الباحثة عن زعيمٍ تعبده. هذه الفكرة تجد ترجمتها السردية في “نباح المحمية”، حيث يصير الكلب أكثر إنسانية من الإنسان، لأنه لم يتقن بعد فنّ الكذب، أو التملق. حين يدافع الحيوان عن حقوق الإنسان، فذلك لا يعني ترقي الحيوان، بل سقوط الإنسان إلى مستوى أدنى من الحيوانية.
“يتخذ الكاتب من الخط الساخر الذي عوّد قراءه عليه في أعماله السابقة، أداةً لفضح البنية الملتبسة للسلطة والمجتمع، ولتفكيك منظومات الوعي الزائف التي تستبدل التفكير بالتطبيل والكرامة بالخضوع”
تندرج رواية “نباح المحمية” ضمن تقليد طويل من الأدب الرمزي الحيواني الذي عرفته الثقافتان العربية والأوروبية على السواء. فمن جهة، يستعيد أبو ناموس روح “كليلة ودمنة” التي استخدمت حكايات الحيوان لتقديم الحكمة السياسية والوعظ الأخلاقي، محتمية بالرمز من بطش السلطان ومكر السياسة. ومن جهة أخرى، يحاكي تقاليد الأدب الأوروبي الحديث الذي جعل من الحيوان أداة نقد اجتماعي وسياسي، كما في أعمال جورج أورويل في “مزرعة الحيوان”، وكافكا في “المسخ”، حيث يتحول الحيوان إلى مرآة للاغتراب الإنساني وفقدان الهوية. غير أن أبو ناموس لا يكتفي بالمحاكاة، بل يطوّع هذا الموروث المزدوج داخل الوجدان العربي المعاصر المثقل بالاستبداد والخيبة، ليصوّر الطغيان اليومي الذي تصنعه الجماهير نفسها حين تتحول إلى قطيعٍ يعزف نباحه باسم الولاء والخوف.
لغة الرواية حادة وهجائية، تمزج بين التهكم الشعبي والعمق الفلسفي، فالسخرية ليست أداة تسلية، بل وسيلة تفكير، تجعل القارئ يبتسم وهو يختنق بمرارة الواقع. أبو ناموس يكتب نصًا قريبًا من عالم كافكا في عبثيته، ومن أورويل في رمزيته، ومن الواقعية العربية في انشغاله بالسلطة والذل والخوف. فحين يصبح النباح خطابًا سياسيًا، تتحول الرواية إلى مرآة للواقع، ويغدو الضحك على الكلاب ضحكًا على الذات.
وتتسع رمزية الرواية لتشمل المشهد الدولي، حيث يتحول نباح السلطة إلى لغة الزعماء والمؤسسات الدولية أثناء أزمات الإبادة والحروب، تمامًا كما يتحول نباح الكلاب داخل المحمية إلى خطاب الطاعة والخضوع. هنا يصبح النباح ليس مجرد صوت بلا معنى، بل أداة ضغط وإخفاء للجرائم، وغطاء على الانتهاكات، سواء على المستوى المحلي، أو العالمي. الرواية بذلك تكشف مأساة مزدوجة: الإنسان الذي يعتاد الطاعة تحت نباح الحاكم المحلي، والأمم التي تصغي إلى نباح الزعيم الدولي، فتفقد حرية الرؤية والتمييز. أبو ناموس يثبت أن النباح، سواء في المحمية، أو في قاعات القرار الدولية، يقتل الحلم، ويجرّد الإنسان من كرامته، ويحوّل الحرية إلى جريمة.
في النهاية، “نباح المحمية” ليست رواية عن الكلاب، بل عن الإنسان حين يفقد قدرته على الحلم، وعن المجتمعات التي تقدس ماضيها لأنها تخاف مواجهة حاضرها، وتمجد سلطاتها لأنها نسيت طعم الحرية. أبو ناموس، بأسلوبه الساخر والعارف، يكتب نصًا يُدين العبودية في كل أشكالها، ويحوّل الحيوان إلى كاشف أخلاقي للإنسان. وحين يصمت الجميع ويبقى النباح وحده، يدرك القارئ أن المأساة الكبرى ليست في الطغاة، بل في الذين تعوّدوا أن يصغوا إلى نباحهم بإعجاب.
ويواصل أبو ناموس في هذه الرواية الخط الساخر الذي عوّد قراءه عليه في أعماله السابقة، حيث يتخذ منه أداةً لفضح البنية الملتبسة للسلطة والمجتمع، ولتفكيك منظومات الوعي الزائف التي تستبدل التفكير بالتطبيل والكرامة بالخضوع. غير أن سخريته ليست تهكمًا عابرًا، بل سخرية معرفية تنبع من وعي فلسفي يدرك أن الضحك يمكن أن يكون أداة مقاومة، وأن التهكم قد يحمل أصدق أشكال الألم. فحين تتحوّل الرواية إلى نباح في وجه الصمت، يصبح الأدب نفسه فعل حرية، والكلمة شراسة أخلاقية في وجه الذل. بهذا يثبت أبو ناموس أنه أحد الأصوات القليلة التي استطاعت أن تجعل من الأدب الساخر مرآة للفكر، ومن الحيوان شاهدًا على سقوط الإنسان.