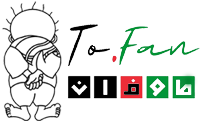د.سيف دعنا
«أشعر بموتك أكثر من حياتي»
سُئِلِ ضرار بن ضمرة: «كيف حزنك على علي؟»
قال: «حُزن من ذُبح ولدها في حجرها، فلا تَرقَأُ عبرتها، ولا يسكن حزنها».
وبعد عام، هذا هو حزننا، في فلسطين على سيد شهداء الأمة: «حُزن من ذُبح ولدها في حجرها، فلا تَرقَأُ عبرتها، ولا يسكن حزنها». وحزن من يعرف، أيضاً، أنه لن ترقأ عبرتنا أبداً، ولن يسكن حزننا مطلقاً حتى يختار الله لنا دنيا هو فيها مقيم.
فسيد الشهداء، وأهله، لم يقدموا لفلسطين ما يجعلنا مدينين لهم أبداً، بل كان السيد مسؤولاً أيضاً عن التأسيس للنقلة الأهم في تاريخ المقاومة الفلسطينية، مساعداً على توفير الشروط الموضوعية لفضاء جيوسياسي إقليمي بديل ومقاوم، يفوق في أهميته وضرورته حتى الدعم العسكري والتقني الكبير والتضحيات البشرية الهائلة التي قدمها «حزب الله» على مدى أربعين عاماً.
ولم يكن توافر هذه الشروط الأساسية ممكناً في ظل هيمنة المنظومة العربية الرسمية، بل هي التي أسهمت في تغييبه أيضاً. لكن، مع توافر الشروط الموضوعية الجديدة، التي أسس لها السيد نصر الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، أصبحت المقاومة الفلسطينية، خصوصاً بعد انتصار أيار 2000، تقف على قدميها، بعدما كانت تقف على رأسها لعقود.
في البدء كان أيار
وفي 25 أيار (مايو) 2000، وفي نهاية مشهد مذلّ من الانسحاب الفوضوي والهزيمة التي لطّخت سمعة كلّ عسكري صهيوني إلى الأبد، أغلق ضابط صهيوني مهزوم ومكسور الروح اسمه بيني غانتس «بوابة فاطمة» في جنوب لبنان، ظناً منه ومن حكومته وكيانه أنّ باباً حديداً يمكنه أن يوقف مفاعيل تلك الهزيمة المُرَّة عند تلك النقطة.
لكن ذلك اليوم، وتلك الهزيمة المُرة، والأولى في تاريخ الصراع العربي- الصهيوني، أسسا للنقلة الأهم والتحول الإستراتيجي الأكثر جذريةً في تاريخ المقاومة الفلسطينية وحركة التحرر العربية. فلم يكن انتصار أيار مجرد محطة عسكرية حاسمة فحسب، ولا نموذج لما يمكن للمقاومة أن تحقّقه فقط، أو حتى مصدراً ضرورياً للأمل للفلسطينيين في تلك اللحظة أيضاً. كان انتصار أيار بداية تشكل مساراً إقليمياً مضاداً، مساراً تاريخياً، يعود بالمنطقة وقضية فلسطين حتى إلى ما قبل النكسة وهزيمة حزيران 1967، وكل ما تلاها.
وفي الخامس والعشرين من أيار 2000، وبقيادة السيد حسن نصرالله، لم يتحرر لبنان، ولكن أفق تحرير فلسطين ظهر واسعاً، كما لم يبدُ من قبل، وبدأ معه التأسيس الحقيقي والفعلي لحركة تحرر وطني حقيقية في فلسطين. منذ كارثة الانفصال بين مصر وسوريا، ولكن تحديداً منذ حزيران 1967، غَرقنا وأُغرقنا في هاوية أيديولوجيا «العدو الذي لا يقهر» السحيقة جداً، حتى لم يبدُ أنّ هناك مخرجاً ممكناً منها يستعيد معه العربي وعيه بذاته وبعدوه وبالعالم. فكان كامب ديفيد، وكانت أوسلو، وكانت وادي عربة مجرد محطات في مسار انحطاط وانهيار لأمة يندر أن يعرف العالم مثيلاً لثقلها التاريخي والحضاري والثقافي وإمكانات استعادتها.
ثم جاء نصر الله، ليرسم في أيار 2000 الطريق البديل إلى فلسطين. أمسك بيد أمة كاملة، لا ليرفعها من قعر تلك الهاوية السحيقة فقط، ولا حتى ليعيد لها ثقتها بنفسها أيضاً، بل سار بها، لتقف كلها خلفه هناك، على «بوابة فاطمة»، التي كانت تبدو من قعر هاوية «عدو لا يقهر» السحيقة، بعيدة جداً جداً، قبلها بأشهر فقط. لكن العرب والعالم، وحتى العدو، شاهدوا من هناك، عبر «بوابة فاطمة»، وعرفوا كم هي قريبة فعلاً فلسطين. لم تكن هذه فقط النقلة الأهم في تاريخ فلسطين، بل، وللمرة الأولى منذ انطلاقتها، بدت وبدأت المقاومة العربية والفلسطينية تقف على قدميها، بعدما وقفت على رأسها منذ النكسة.
ما بعد حرب حزيران 1967
لم تكن حرب حزيران 1967، مقارنة بكل الحروب الإقليمية، وحتى الحروب الأهلية ذات الأبعاد الإقليمية، حتى حرب متوسطة الحجم. بل، كانت، بحكم تفاصيلها وواقعها، أقرب إلى أن تكون أقل من الحروب المتوسطة وأكبر قليلاً فقط من الحروب الصغيرة. فمقارنة بغالبية الحروب والصراعات الإقليمية التي اندلعت بعد عام 1950، كانت قصيرة نسبياً من حيث الزمن (ستة أيام)، فيما عدد الضحايا والخسائر قليل نسبياً (قارب العشرين ألفاً)، وحتى من ناحية نطاقها الجغرافي – العسكري، كانت مساحة الميدان العسكري أصغر من غالبية الحروب الإقليمية السابقة واللاحقة، من الحرب الكورية (1950-1953)، وفيتنام (1955-1975) إلى الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988)، وحتى حرب تشرين (1973).
ففي الحروب بين الهند وباكستان في 1965 و1971 مثلاً التي حدثت في توقيت قريب جداً من حرب 1967، تواجه ما يقارب المليون ونصف المليون جندي من كلا الطرفين كل مرة وفي كل معركة جرت على مساحة تتجاوز (في الجبهتين الشرقية والعربية) أكثر من عشرة أضعاف مساحة فلسطين التاريخية.
لكن الاهتمام الأكاديمي والمعرفي والسياسي والإعلامي بها ــ رغم توافره إلى حد ما ـــ لا يقارن مطلقاً بحجم الإنتاج المعرفي والأدبيات السياسية والإعلامية والعسكرية والإستراتيجية الهائلة التي اهتمّت بحرب حزيران 1967.
ركزت معظم الكتب والدراسات الخاصة بالحرب الهندية الباكستانية على الأبعاد العسكرية أساساً، ولاحقاً فقط على الإستراتيجيات النووية. أما الحرب الكورية، فربما كانت فعلاً إحدى الحروب الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى ذات الأهمية العالمية الفائقة، حيث شاركت فيها كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، في مفصل تاريخي حاسم في بداية نظام الحرب الباردة في آسيا، وأثرت بشكل عميق على الجغرافيا السياسية لأكثر من 60 عاماً، حيث أسفرت عن تقسيم كوريا، وأسست للتحالفات الأميركية في آسيا والحضور العسكري الأميركي في المنطقة حتى الآن.
لكنها، ورغم كل ذلك، ورغم تغطيتها أيضاً لمساحة جغرافية أكبر بكثير من الحرب العربية الصهيونية، واستمرارها لثلاث سنين، وبلوغ خسائرها أكثر من ثلاثة ملايين قتيل، عرفت بـ «الحرب المنسية» بسبب نسبية التركيز عليها، خصوصاً بسبب تصدر الحرب في فيتنام للاهتمام لاحقاً.
كانت تبعات هزيمة حزيران 1967، رغم ذلك، كارثية على الوعي العربي بفعل الاستثمار الهائل، وحتى المبالغة الكبيرة بمعناها وتبعاتها ومآلاتها، من قبل أدوات الدعاية والإعلام العسكري الصهيوني والغربي، وحتى بعض العربي، وشارك عدد من المثقفين العرب وصناع الرأي في تقييمهم للحرب (عن قصد أو جهل) في تحقيق أهدافها الحقيقية التي تجاوزت بكثير المكاسب الجيوسياسية للكيان الصهيوني والمنظومة الغربية -لم ينظروا إليها كهزيمة عسكرية صغيرة إلى متوسطة الحجم، كما هي بالفعل، وبالتالي التصرف وفق مقتضيات ذلك للتجهيز لتجاوزها والانتصار وإعادة الاعتبار.
مراجعات أيديولوجية وسياسية عربية تصاعدت مع النكسة، وضربت قلب الوعي العربي
في 1967 تلاقت، وبوضوح، مصالح الكيان الصهيوني والمنظومة الغربية، مع بعض الشرائح العربية الحاكمة والمتنفذة في كل الوطن العربي المرتبطة بها بنيوياً ومصلحياً (ومعها شبكة مثقفيها وأدواتها الإعلامية) لإعادة تشكيل المنطقة ووعي أهل المنطقة بناء على الصورة التي أنتجوها وعمموها لنتائج الحرب. لهذا، لم يتم المبالغة في تقدير نتائج حرب حزيران عام 1967 فقط، بل «تم المبالغة حتى في تقدير تكلفة الحرب الاقتصادية لاحقاً، في ما يبدو كأنه تمهيد (لسياسة) للانفتاح» كما يشير علي القادري في «تفكيك الاشتراكية العربية».
كان ذلك مقصوداً. ففي مجموعة المقالات المعنونة «الاقتصاد المصري في ربع قرن 1952-1977»، تم الادعاء بأنّ «خسائر حرب الأيام الستة عام 1967 يراوح بين 20-24 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عام 1967». لكن وفقاً لمؤشر التنمية العالمية، كان هناك نمو حقيقي بنسبة 1% تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 1968.
وكان الضرر الذي لحق بالبنية التحتية ضئيلاً، فيما تم استبدال المعدات الحربية بتمويل عربي وسوفياتي. وبالتالي، يقول القادري، «من غير المرجح إلى حد كبير أن يتكبد اقتصاد مثل هذه الخسائر في البنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي ويظل محافظاً على معدل نمو إيجابي في العام التالي». كانت مبالغة لتبرير مسار قاد إلى كامب ديفيد.
كان المستهدف من الحرب، كما يبدو، والذي تم العمل على تحقيقه رغم حجم ونتائج الحرب الحقيقية، هو الثقل التاريخي والحضاري والثقافي العربي الذي لا تختزنه أي منطقة أخرى في العالم. صحيح أن المنطقة مهمة جداً للمصالح الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة (البترول، السوق، اقتصاد السلاح)، ولكن نظرة سريعة إلى الخريطة وقراءة سريعة للتاريخ، ستفيد بأن الوطن العربية بالذات مرشح، بسبب ذلك، بالإضافة إلى إرث حضاري وتاريخي وثقافي هائل، لأن يستنهض معه كل الجنوب العالمي، إن نهض. ولا يمكن للهند، باكستان، كوريا، فيتنام، أو غيرها أن تشكل مثل هذا التحدي للمنظومة الكونية.
أما شبكة المصالح الإمبريالية الغربية – الصهيونية – العربية الهائلة التي التقت في حزيران 1967، واستثمرت في تضخيم تبعات الهزيمة، فلم تكن نتاجاً للحرب فقط، بل إن وجودها وترابطها البنيوي بالكيان الصهيوني والمنظومة الغربية سبق الحرب بكثير. فمنذ الانفصال بين سوريا ومصر، بالحد الأدنى، كانت هذه العلاقة، وهذا التشابك عميقين جداً وبنيويَّين. لهذا، لم يؤسس الانفصال للنكسة والهزيمة فقط، بل وضع حجر أساس المسار البديل الذي أعقبها، واستولد عقلانية سياسية عربية مهزومة، ومجالاً مفاهيمياً مأزوماً، وحتى عقيدة مضادة ومثقلة حتى النخاع بالمقولات الصهيونية والدلالات الاستعمارية.
الانفصال أسس للنكسة، ولكن أسس معها أيضاً لحقبة تاريخية عربية جديدة ميزتها إعادة تشكيل للعقيدة العربية الثورية التي سادت منذ النكبة، وشكلت مقاومة الاستعمار والوحدة العربية ومركزية قضية فلسطين وتحريرها أهم ركائزها. وحين حصلت النكسة تصاعدت مفاعيلها بشكل هائل حتى بدى الانفصال للبعض أقلها.
فحتى قبل النكسة، وتحديداً مع الانفصال، يمكن تلمس بداية مراجعات أيديولوجية وسياسية عربية تصاعدت مع النكسة، وضربت قلب الوعي العربي، وكسرت الخطوط الحمر، حتى أصبحت اليوم معالم الخطاب السياسي الرسمي العربي الراهن الأساسية. فمفهوم التسوية (كما يعبر عنه في الحديث عن حل سياسي، ومفاوضات، وقرارات دولية، الخ) بدء منذ ذلك الوقت يكتسب مكانةً استثنائيةً في الخطاب السياسي العربي. فقد حلّ تدريجياً محلّ مفهوم التحرير كهدف، واستبدله، رغم وجود محاولاتٍ خبيثة متكررةٍ لا تعمل على الربط بين الاثنين فحسب، بل وحتى تخلط بينهما أيضاً. وقد استولد هذا المفهوم، التسوية، استخدامات جديدة للغة والبلاغة والحجج، يبدو الآن، وبأثر رجعي، أنها كانت مؤثرة جداً في قدرتها حتى على خداع الرأي العام، وحشد التأييد.
منظمة التحرير تقف على رأسها
ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصاً الفئة المتنفذة فيها بالذات بعيدة من هذا الفضاء الجيوسياسي العربي والعالمي وتحولاته، بل كانت بحكم مصالحها وطبيعتها وتركيبتها وارتباطاتها وأصولها الاجتماعية في تفاعل قوي معها. فمنذ تبني منظمة التحرير الفلسطينية في دورة المجلس الوطني الثاني عشر (القاهرة 1-8 حزيران 1974) ما سمي «البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير»، هيمن فهم ضيق جداً لمعنى «التحرر الوطني»، وأهداف «حركة التحرر الوطني». كان هذا قطعاً نتاج لشبكة مصالح وبنية علاقات إقليمية/ عربية وعالمية، وليس سوء فهم أو جهل بمعنى حركة التحرر الوطني.
فمع مقررات تلك الدورة للمجلس الوطني، وربما يمكن الزعم أيضاً قبلها، ساد هذا الاعتقاد، وهيمن هذا الفهم: أن هدف حركة التحرر الوطني الوحيد هو «الاستقلال السياسي» فقط. كان هذا الانحراف تأكيد أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني ليس فقط ليست متجانسة، بل منقسمة داخلياً وبحدة منذ البداية وفقاً لطبيعة الفئات الاجتماعية المشاركة فيها، ووفقاً لمصالحها وشبكة علاقاتها، ما يفسر التوترات التي ميزت العلاقة داخل منظمة التحرير منذ البداية.
بل، والأهم من ذلك، ربما، كان هذا تأكيداً أن حركات التحرر الوطني تتفاعل وتتطور ضمن السياق الجيوسياسي الأوسع بمقدار ما ينعكس ذلك بتغيرات في أهدافها وتكتيكاتها وأساليبها استجابة وتبعاً لتفاعل القوى الاجتماعية المشاركة فيها مع التغيرات في الديناميكيات الإقليمية والعالمية الأوسع. ويشمل ذلك فيما يشمل ليس فقط التطورات والتحولات الإيديولوجية داخل هذه الحركات، بل، والأهم، تغير أساليب نضالها، من المقاومة المسلحة إلى الأشكال الديبلوماسية. يكفي أن ننظر إلى مكان وزمان انعقاد جلسة المجلس الوطني المذكورة لندرك التحول المقصود.
لم تكن مشكلة الفلسطينيين الأساسية، إذن، في الشروط الذاتية فقط، في الصراعات والتناقضات الداخلية ذات الجذور الاجتماعية، بين نخب حركة التحرر الوطني الاجتماعية المختلفة، أو في اختلاف برامجها وأساليبها (كما روج طويلاً عن الانقسام الراهن منذ 2007)، بل في الشروط الموضوعية للصراع، في تفاعلها (أي النخب المختلفة) مع فضاء جيوسياسي إقليمي جديد، وعقيدة عربية رسمية جديدة مهيمنة أعطت امتيازاً للنخبة الفلسطينية المتنفذة منذ البداية وأسهم في حسم التناقضات والتوترات الداخلية لصالحها.
هكذا بالضبط أصبحت النكسة فعلاً أخطر الأحداث في التاريخ العربي الحديث. ففي هذا المسار الذي لم تكن فيه أوسلو 1993 حتى نهاية السقوط، بل مجرد محطة جديدة وصلت إلى ما هو أسوء مما سبقها، كانت الحاجة إلى ما هو ليس اقل من انقلاب إقليمي، لتشكل فضاء جيوسياسياً عربياً بديلاً، يمكنه أن يعيد بعض التوازن لحركة التحرر الوطني الفلسطيني لتعود إلى مسارها المفترض، وليوقف حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي على قدميها بعد أن كانت تقف على رأسها.
المقاومة تقف على قدميها
ثم جاء نصر الله. لم يدرك، باستثنائية مذهلة، أهمية توفير الفضاء الجيوسياسي البديل للمقاومة الفلسطينية فقط، بل وحتى أهمية الثقل التاريخي والحضاري والثقافي الهائل للأمة، فعمل على الـتأسيس لاستعادته وتوظيفه حتى أصبح سلاحه الأمضى. وهذه مهمة هائلة ليس فقط لم يعرف مثلها أي قائد لأي حركة مقاومة أو حركة تحرر وطني في التاريخ، بل هي مهمة أكبر حتى من أن تتحملها دول عربية كبرى، فكيف بقائد حركة مقاومة في ثاني أصغر بلد عربي منقسم على المقاومة أصلاً.
فلم يقع على عاتق السيد ورفاقه فقط تأسيس حركة مقاومة وطنية لبنانية وتحرير «أراضٍ محتلة» فقط. فالاستقلال السياسي هو هدف ضيق جداً تسعى من أجله فقط بعض النخب التي تتنازل عن السيادة الحقيقية في سياق تفاعلها مع محيطها ومع العالم. بل، وأيضاً التأسيس لحركة مقاومة حقيقية وإنجاز تحرير حقيقي في لبنان، بالإضافة إلى التأسيس الموضوعي وتوفير الشروط اللازمة لتأسيس حركة المقاومة العربية وتوفير فضاء جيوسياسي إقليمي بديل يمهد لإعادة تشكيل حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعودة بها إلى ما قبل النكسة.
ففي فلسطين، لم تكن القضية الكبرى أن يدعم «حزب الله» المقاومة الفلسطينية مادياً وتقنياً وعسكرياً وأمنياً وبشرياً فقط، وهو فعل، وغزة والضفة وباقي فلسطين كلها شاهدة على ذلك. لكن السيد الشهيد قدم أيضاً ما هو أهم بكثير: تأسيس وتوفير فضاء جيوسياسي إقليمي/عربي بديل تتفاعل فيه ومعه المقاومة الفلسطينية في طريقها نحو القدس. هذا عدا عن التأسيس الأيديولوجي والسياسي والكفاحي الضروري للمقاومة في أعقاب فشل مشروع منظمة التحرير، الذي أنتج مقاومة محلية أصيلة كان يحتاجها ويحتاج نموذجها بشدة الجيل الجديد من المقاومين في فلسطين، خصوصاً أنها تستند أساساً إلى الإرث الثقافي والحضاري والتاريخي الهائل الذي تم تغييبه وتغييب إمكاناته الهائلة في أعقاب النكسة.
هكذا ندرك، كيف ولماذا كانت مساهمات السيد الشهيد نصرالله في إعادة تشكيل ثورية للروح العربية والإسلامية، وليس في لبنان أو فلسطين فقط، وتوظيف الثقل التاريخي والحضاري والثقافي للأمة في مشروع المقاومة، على طريق استنهاضها أكبر بكثير مما تحتمل القوى الأكبر والأغنى والأقوى في العالم، وحتى المنظومة العربية الرسمية القادمة من النكسة. فليس تحريرٌ رمزيٌ «لأراض محتلة»، كما ترغب بعض النخب في سعيها إلى سيادة مزورة، كفيلاً باستجلاب كل هذا العداء وكل هذه الحروب، أو كان يستحقها. لكن مشروع المقاومة التي أسّس لها وقادها السيد الشهيد اصطدم منذ البداية ليس بالقوى الاستعمارية فقط، بل وبالمنظومة العربية الرسمية أيضاً ولا يزال.
د.سيف دعنا