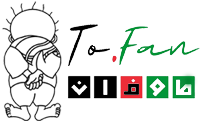يلتبس مفهوم “الحق” على الكثير من الناس، وفي نظري فإن مرجع هذا الإشكال لغوي و تاريخي. ساهمت مرونة اللغة ومجازاتها وأساليبها الخطابية وتطاول الزمان عليها في تغيير جوهر مفهوم “الحق” حتى اختلط مع مفاهيمَ متشابهة او صيغت له مباحث خاصة مثل حقوق الإنسان. وفي سياقات أخرى يستخدم الناس كلمة الحق للتعبير عن صوابية حالة معينة أو بطلان أخرى، وكلها مفاهيم مختلفة منفصلة ولها سياقاتها، ومن المفاهيم المتشابهة مفهوم الصدق، هو متشابه ومتفرع ولكنه ليس هو “الحق”، وأيضاً من تأثيرات الزمان وفي اللهجات العربية يستخدم المفهوم للتعبير عن التملك، مع أن أن التملك حق ولكنه ليس هو “الحق” كذلك.
وتاريخياً ومع بروز الحالة الإستعمارية بقوتها الطاغية المطلة على العالم، صار مفهوم الحق مرناً فضفاضاً وصار مرتبطاً بالقوة التي تتزعم العالم. وبشكل موضوعي، تحول الحق من مبدأ وجودي إلى منتج إنساني، حيث حلت القوة الإمبريالية محل نواميس الكون في صياغة الحق، ومن جملة ذلك ما نسمعه من تصريحات مثل “من حق الإنسان أن يختار جنسه ونوعه”، ومن ثم جاء حزب المحافظين الجمهوريين في أمريكا وقالوا: “ليس من حق المتحولين أن يشاركوا في رياضات الجنس الآخر وليس هناك إلا جنسين اثنين فقط”!. فالظاهر أن مسألة الحق أصبحت تتسم بمرونة عالية في سياق القوى التي لا ترى فوق قوتها أحد. بل الأمر تعدى مسألة المرونة إلى أن أصبحت الحقوق تُعطى وتمنح. وليس هذا بالمستغرب، فإن قوة عظمى تعظّم الحق الوجودي الطبيعي وتعطيه الأولية هي قوة عادلة بالضرورة، وهذه ليست طبيعة الحال التي نعيش فيها سلطة القوى الغربية العظمة حيث تحتل الصهيونية فلسطين، وتشتعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتعيش أفريقيا، القارة الغنية بالموارد، في حالة شح وضعف شديدين.
إلى الآن، قد لا يبدو الطرح الذي أتقدم به جلياً باستخدامي لكلماتٍ مثل أن الحق مبدأ وجودي، أو أن الإمبريالية حلت محل نواميس الكون، أو عندما أقول أن الأمر تعدى مسألة المرونة حتى أصبحت الحقوق شيئاً يُعطى ويمنح. ولكن، هنا مربط الفرس في الطرح الذي سأقدمه. وبدلا من أحمّل المقالة ما لا تحتمل وبدلاً من أناقش الحق بأبعاده الكلية، الأمرُ الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة جداً ومتراكمة، وفي ذات الوقت أطرح عدة أسئلة وسأترك الإجابة عليها لطبيعة القارئ وشفافيته، فأتساءل: هل يعقل للحق ومفهومه أن يكون بهذا التعقيد وهو مفهوم ذا صلة وثيقة بحياة الإنسان؟ وهل الحق مفهوم فلسفي أم أنه مفهوم بديهي كالهواء الذي نتنفسه؟ فنحن لا نقول كلمة الهواء كل يوم ولكننا نعيش به، وكذلك الحال مع كلمة الحق. وإن كان المفهوم فلسفياً فهل تشترط الفلسفة التعقيد أم أن بساطة المفاهيم أحد أدلة انسجامها مع الوجود البشري؟ من أجل ذلك ومن هذا المنطلق سأحاول أن أقوم بعملية اختراق هادئة لكل هذا الضجيج حول مفهوم الحق حتى أصل إلى المنتصف محاولاً أن أصيب هذا الضجيج في قلبه بمقتل، فأقول بإيجاز أن الحق إذا كان مصدره خارجي فهو اصطلاحي، ومعنى أن يكون اصطلاحياً أي أنه يمكن أن يكون له اسم آخر، أو أن الحق هو الجذر والمفاهيم ذات المصدر الخارجي هي مفاهيم منبثقة عنه – أي عن مفهوم الحق-.
وعندما أقول كلمة “مصدره خارجي” فإنني أقصد بذلك القانون أو المجتمع أو الإرادة الجمعية أو الدين أوحتى الإرادة الفردية. وبناءً على هذا وقبل الخوض في بيان ماهية الحق فأنا هنا لا أقصد “الحقوق المكتسبة” التي تنشأ بفعل واقعة أو علاقة مثل المرتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد لقاء ساعات عمله. وأيضاً إنني لا أتحدث عن المستوى الثاني من الحقوق التي تقيمها المجموعات الإنسانية داخل أنظمتها والتي تُقابل بالواجبات، مثل الحق في التعبير والذي يقابَل بواجب احترام الآراء المتعددة الأخرى في المجتمع، فمرة أخرى، أنا هنا أتحدث عن الحق كحالة وجودية في الطبيعة قبل وجود الإنسان.
معنى الحق
في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (395 هجرية): (حق) الحاء والقاف أصلٌ واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الإستخراج وحسن التلفيق ويُقال حقًّ الشيء وَجَبَ. ولا تخرج المعاجم الأخرى مثل لسان العرب عن ذات التعريف. ولكن إن كان هذا هو التعريف الدقيق للحق، فذلك يدل على أن القضية تقوم بمعايير دقيقة. فإننا إذا ما أحضرنا قضيةً مُلفقة كاذبة، وغيّرنا جميع صفاتها ومقوماتها لتكون محكمة فهل تصبح حقاً وحقيقةً؟ ماذا لو جئنا بتمثال من الطين وطليناه بالذهب وأحكمنا الطلاء وقلنا أن هذا التمثال ذهب خالص؟ لذلك يقول ابن فارس أيضأً أن الحق ليس ما بدا محكماً فقط، بل ما كان جوهره صحيحاً أيضاً. وهنا يطرح السؤال المنطقي نفسه، من أين تكتسب الأشياء جوهرها؟ وكيف يتكون جوهر الأشياء؟ أي كيف تتكون بنية الأشياء الداخلية بتركم منسجم مبرر يكوّن هوية الشيء ومعالمة ودوره ووظيفته التي لا يقوم مقامها أحد باستثنائه؟ يبدو أن إجابة المفكر الكبير محمد شحرور حول الحق تحيلنا إلى صلب الإجابة على هذا السؤال وهو أن الحق هو الوجود الموضوعي خارج الوعي. وهنا تتقاطع اللغة والمفاهيم مع الرياضيات بوضوح، حيث تحيلنا الكلمات بشكل موضوعي إلى مفهوم الثابت والمتغير في الرياضيات، فالثابت يمثل ما هو موضوعي (ولا يجب أن نخلط بين الثابت والجامد)، والمتغير يمثل الوعي أو الإدراك البشري المتأثر والمتقلب بعوامل والزمان والمكان، الثابت هو القيمة المضبوطة في المعادلة، والمتغير هو العامل المجهول فيها والذي يحكمه الثابت ويقننه.
الوجود الموضوعي خارج الوعي الإنساني: الثابت والمتغير في الرياضيات
الثابت والمتغير في الرياضيات ليست نظرية موضوعة، وإنما هو مفهوم يشير إلى علاقة بين طرفين. حيث الثابت هو القيمة غير المتغيرة مثل الرقم والعدد والدوال الرياضية مثل الباي والفاي وفيثاغورس. أما المتغير فهو ما نشير إليه برمز في المعادلة الرياضية، وهو ما يتغير حسب السياق والمعطيات.
المسألة ليست في غاية التعقيد كما تبدو، وتتجلى لدينا العلاقة بين الثابت والمتغير بوضوح إذا ما تساءلنا: هل للمتغير أي معنى في المعادلة إذا لم يكن هناك ثابت يصيغها؟ فهل هناك معنى ل “س + ص = ع”؟! وعلى هذا الأساس بإمكاننا أن نضع كل المفاهيم التي صيغت من قبل الوعي الإنساني القائم والمتمثل بالإمبريالية الغربية، كلها نضعها في وعاء المتغير ما دامت تفتقد إلى مرجعية حق كوني وجودي ثابت. ولتبدو المسألة على أبسط ما يكون، فإن أقرب مثال يبين العلاقة بين الوعي الإنساني والوجود هو الشمس. فالشمس حقيقة موضوعية وجودية، لا يمكن إنكارها ولا هيئتها ولا دورها في النظام البيئي على كوكب الأرض، وسواءٌ أكان الإنسان موجوداً في الحياة أم لا، فالشمس باقية في مكانها وتؤدي ذات الدور. فهي تقوم مقام الثابت في الرياضيات. أما حالة وجود الإنسان أو عدمه وتأثيرها في الشمس فهي تقوم مقام المتغير في المعادلة. فلو أغلق الناس عيونهم أو حجبوا الشمس، هل ستصبح الشمس معدومة في تلك المنطقة خارج الوعي الإنساني؟ أم أن الإنسان لغاها في وعيه فقط؟!
وظيفة الوعي الإنسان التي يحتمها وجود الحق
إن كل ما سبق يحيلنا إلى مطلع المقالة ويجعلنا نعيد النظر في كل الحقوق الناشئة عن القانون أو عن التفوق البشري الذي يفرض ذاته كحالة غير قابلة للزوال وكأنها ثابتة من الثوابت، كالحالة الأمريكية التي تفرض الحقوق على البشر من منطلق القوة دون مرجعية موضوعية وجودية، وذلك من خلال فرض تصورات على أنها مطلقة ومثالية مثل مفهوم الديمقراطية الذي كان مبرراً لغزو الشعوب.
إن إعادة النظر في المفهوم تضع لنا سؤالاً حتمياً، ما هو واجبنا اتجاه الحق إذا ما أدركتا أنه حالة وجودية موضوعية خارج الوعي البشري، وبأنه ثابت لا يمكن نقضه في بنيته؟ أليس على المعادلة أن تكون في صحيحة؟ وأن تكون النتيجة بين طرفي المعادلة تمتاز بالتطابق الجوهري حتى لو اختلف الشكل الظاهري بين الطرفين. فالمعادلة 2 + س = 4 تعني أن س =2، لأن التطابق الجوهري يجب أن يكون واقعاً. فالمتغير خاضع للثابت، خضوعاً يصوغ شكل المتغير ولا يلغيه، بل ينتج حقيقة ومواءمة وتطابقاً.
هذه المقالة مقدمة لأخرى تضع مفاهيم الحقوق الأخرى في الميزان، وخصوصاُ تلك التي يتحدث بها الغرب المسيطر فيما يتعلق بوجود “إسرائيل”، أو فيما يتعلق بالمفاهيم المطلقة كالديمقراطية وحق التعبير والحرية على اعتبار أن الحق يعطى ويُمنح ويُقسّم أو تُوجد له صياغات متوسطة بين الوجود وعدم الوجود كحل الدولتين. أو كما ذكرنا آنفاً عن حق الإنسان في تغيير جنسه ونوعه. فهل الأمور بهذه المرونة الليبرالية؟ أم أننا نشهد حالةً طغى فيها الفرع على الأصل، وطغى فيها المتغير على الثابت؟! وهل قضيةٌ مثل قضية فلسطين وحق الفلسطينيين في العودة وحقهم بفلسطين هو حق من تلك الحقوق الاصطلاحية أم هو حق موضوعي خارج الوعي الإنساني؟! لماذا يمكن أن نقول أن إنساناً أسوداً من أفريقيا ولا يمكن أن نقول أنه من بيلاروسيا؟ ولماذا لا يمكننا أن نقول ادعاءً أن صينياً من الهند؟! لماذا تمتاز المسألة بالقطعية في تلك الحالات وتمتاز بالميوعة العالمية إذا ما تحدثنا عن فلسطين؟
هل هناك معايير وجودية موضوعية خارج الوعي الإنساني يمكن الاحتكام إليها.
يسعدني في هذه المقالة بالتحديد أن أتلقى استفساراتكم وتعليقاتكم على عنواني البريدي: adamsartawi@icloud.com
آدم السرطاوي – كندا