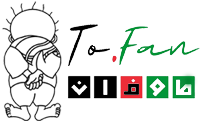التشوّه المُربِح: خلل عضوي في بنية الحضارة الغربية
البداية
أثناء الحرب العالمية الثانية اضطرت النساء الأوروبيات إلى ترك بيوتهن والأرياف والعمل في المصانع والمدن، وذلك بسبب غياب الرجل في الحروب، هذا الأمر أدى إلى انتباه أصحاب رؤوس الأموال إلى أن عمالة المرأة أقل تكلفة، وبعد عودة الرجال من الحرب، ليس كلهم بالطبع، برز النزاع حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل وفي الأجور. وبالرغم مما نتج عن ذلك من آثار على الأطفال الذين صاروا يعيشون في بيوت تغيب عنها الأم، وبالرغم من معارضة الرجل لمنازعته مكانه في السوق، إلا أن صاحب رأس المال قد مال بالكفّة إلى المرأة، بالطبع لأن التكلفة أقل، وقد دعم ذلك من خلال فلسفات مكتوبة وصراع فكري محسوب مثل أفكار سيمون دي بوفوار وبيتي فريدان.
وقد تخلل ذلك زمنيًّا أن شركات الإعلان الأولى في الغرب مثل J. Walter Thompson وProcter & Gamble لاحظت أن الإعلانات التي تظهر فيها المرأة، حتى لو لم تكن لها علاقة بالمنتج، كانت تحقق مبيعات أعلى. وقد رافق ذلك أيضًا ظهور شركات المكياج والتجميل من أجل تجميل المرأة في الشاشة أكثر، فظهرت شركات ضخمة مثل Max Factor وElizabeth Arden ومن ثم تبعها اقتصاد كامل يقوم على أساس خروج المرأة للعمل.
واجهت هذه التغيرات نوعاً من الرفض الكنسي والإجتماعي، ولكن كلمة “الحرية” كانت قد سيطرت على سياقات الخطابات الحقوقية التي تتعلق بالمرأة وعملها بل وحرية التصرف في جسدها، وهكذا بدأ تحوّل المجتمع الغربي من مجتمع أكثر جمعيّة إلى مجتمع فردي، حتى وصل الأمر إلى دعوات التعري في الستينيات تحت مبرر هذه الدعوات التي نادت بالحرية فظهر اقتصاد ضخم آخر يقوم على التعري، وهو اقتصاد الأفلام الإباحية.
في داخل البنية الغربية
فهذه السياقات الإجتماعية والدعوات أنتجت اقتصادات كاملة وتقدمت بصناعات ضخمة وهائلة مثل اقتصاد الموضة والأزياء والمكياج والمنظمات الحقوقية والنشر والإعلام والسينما، ولكن، عندما نقول بأنها ضخمة، فإنها قد تضخمت في الجهة المقابلة من الاقتصاد حيث يقبع صاحب رأس المال والشركات الضخمة. أما في الجهة الأخرى، فقد ظهرت الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تضرب مباشرةً في الصحة النفسية والذهنية للطفل الذي يعيش بعيدًا عن الأم المنشغلة بالمغريات الجديدة المستمرة التي لا ولن تنتهي. وهنا يجب أن ننتبه أن الاقتصاد قد صار اقتصادين: اقتصاد رؤوس الأموال والشركات التي اعتاشت على هذه المعاناة واستثمرتها، واقتصاد آخر في الجهة المقابلة والذي يتضمن النساء والرجال المدنيين متوسطي الدخل؛ الأول يتضخم والثاني يضعف نفسياً وينساق بالغريزة والإغراءات وبشكل مستمر، فكأننا نتحدث عن اقتصاد يبلع الناس ويتغذى عليهم.
بفعل هذه الظاهرة وصل العالم الغربي اليوم إلى مستوىً عالٍ من الهشاشة والضعف المبالغ فيه فيما يتعلق بالصحة النفسية، إلى درجةٍ وصل فيها الإعلام إلى أن يتحدث عن أن الشعور بالوحدة النفسية بين أفراد المجتمع والفراغ النفسي الذي يعيشون فيه قد وصلا إلى مرحلة تشبه الوباء.وقد ظهرت هذه الهشاشة بقوة بعد وباء كوفيد الذي أدى إلى شروخات اجتماعية كبيرة. لأن هذا الاقتصاد يعد مؤسسة البيت مؤسسةً ثانوية، وإذ بها تحولت إلى مؤسسة أساسية بالدرجة الأولى بشكل مفاجئ وطارئ بسبب كوفيد. هذه الشروخات الإجتماعية دخلت في ذات النمط الغربي وأدت إلى تضخم اقتصادات أخرى جديدة في مجال الرعاية النفسية والدواء والوسائط الاجتماعية.
تصدير البنية الهشة المغلفة إلى العالم
ومن بعد آخر، فكما نعلم، إن أساس الحروب التي يقيمها الغرب حول العالم هو أساس اقتصادي تجاري قائم على ضعف الأمم استراتيجياً وعسكرياً، ومن الطبيعي أن يستخدم الغرب ذات الأدوات التي يمكلها لنفسه اجتماعياً وحقوقياً واقتصادياً، هي ذاتها الأدوات التي استخدمها داخل مساحته الخاصة، لذلك تجد أن قضية المرأة والحرية (والديمقراطية هو اسم سياسي لكلمة الحرية) هي القضية التي يتبناها الغرب في كافة خطاباته عندما يهاجم الأمم الأخرى، لأنه كان مسبقاً قد خلق لها أرضية خصبة حول العالم من خلال الإعلام والسينما والدعايات التي تعرض نمط حياة يراه الناس مغريًا ومرغوباً مقارنةً بما يملكون. وأيضاً، فكما أن وجود المرأة كان قد حقق مبيعاتٍ أعلى، فوجود المرأة في سياقات أخرى يحقق قبولًا واستحسانًا كسياق الإستعمار مثلاً.
وأيضاً، فإن كل الحروب التي قام بها الغرب حول العالم أنتج منها شرائح اجتماعية جديدة تحت مسمى “لاجئين”، أولئك الذين يخرجون هروبًا من الحرب، وهم عادة أولئك الذين شُحنوا بنموذج الحياة الغربية ويفضلونه على النمط الثقافي التاريخي الأصلي في بلادهم، أو هم الكثير من المتضررين من الأقليات الذين يعيشون على الهامش ولا يجدون لأنفسهم ملجأً، فينتقلون إلى مخيمات لجوءٍ في الدول الأخرى. بالنسبة للغرب، هذه فرصة تغير ديموغرافي يجب استثمارها، فتُرسل المنظمات الإنسانية لتعمل على مساعدة اللاجئين! ولا تكتفي هذه المنظمات بتقديم الطعام والخِيم والخدمات الصحية، وإنما تُقدّم برامج لدعم المرأة بتعليمها مهنًا بسيطة تحت سياق أن المهنة تؤهل المرأة للاستقلال وصنع القرار، وعلى الطريقة الغربية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسب الطلاق في المخيمات بشكل كبير، لتُعيد قضية المرأة سيرتها الأولى كما بدأت في الغرب.
في رأيي، لم يكن من السهل على المجتمعات الغربية أن تواجه خطاب حرية المرأة والديموقراطية وحرية الجسد، ولم يكن من السهل على المجتمعات الغربية أن ترى أن المستفيد الحقيقي يقبع في الجهة المقابلة من الاقتصاد، بل وحتى إلى يومنا هذا، لا تزال مواجهة هذا الخطاب في غاية الصعوبة، لأن هذه المواجهة بالتحديد تتطلب وعياً لا تدركه الجموع، بل غالبًا ما يدركه مفكرون ونقّاد اجتماعيون متعمقون في دراساتهم ويستطيعون أن يروا إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، ومن هؤلاء عالم النفس الألماني إريك فروم Erich Frommوآخرون قلة، وتأثيرهذه النخبة يظل محدودًا في مواجهة تيار ضخم يحكمه المال والإعلام والخطابات الجماهيرية التي تتجاوز القارات.
النمط
إننا إذا ما أردنا أن نستخرج نمطاً من هذا السياق فإننا نجد ان أي حالة ضعف أو وهن أو معاناة يقوم الغرب بالاستثمار المربح فيها كما رأينا في حالة المرأة واللاجئين، وذلك من خلال تغليف الحالة بهالة تستدعي التعاطف والقبول و”النضال”، ومن ثم تصدير هذه الأزمات إلى العالم بعد تغليفها لغايات التوسع والاستعمار.
إننا إذا ما دققنا النظر أكثر نجد أن هذا النمط قد تكرر في الحالة اليهودية، حيث اضطُهد اليهود في أوروبا ومن معاناتهم ظهر ما يسمى بمعاداة السامية، تم تغليف هذه المعاناة بالتعاطف والندم والحساسية المفرطة والمظلومية، وبذلك صُدرت هذه المعاناة إلى أوطاننا وإلى العالم حتى صار اليهود أداة استعمار عالمية لا تقل أهمية عن أداة المرأة وأداة الحرية (الديمقراطية).
الخلاصة
تهدف هذه المقالة إلى بناء تصوّر دقيق لنمطٍ معيّن يوجّه سلوكنا الاستهلاكي والمعرفي اليومي، وهو النمط الذي تتغلغل آثاره بعمق في حياتنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي التي نستخدمها يومياً، خصوصًا عبر المحتوى النسائي الجنسي الطاغي والخطابات الفكرية التي تنادي بالحرية والديمقراطية وتلك الأخرى التي تعمق مظلومية اليهود. إن الوعي بهذا النمط يكشف أن السياق الذي يبدو في ظاهره حرية وجمال وتمكين، إنما نشأ في جوهره عن خللٍ بنيويّ في الحضارة الغربية كان قد تشكّل بعد الحروب العالمية. الغرب لم يقدم علاجاً لمعاناةٍ ومشكلة، بل استثمر في كل خلل وحوّله إلى اقتصاد وفلسفة ونموذج حضاري استعماري تُلقى تبعاته على مجتمعاتنا. كان الأجدر بالغرب أن يواجه جذور المشكلة ويسعى إلى حلّها، لكن ذلك لم يكن في مصلحة اقتصاد الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الذين راحوا يراكمون الأرباح على حساب الإنسان.
آدم السرطاوي – كندا