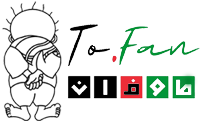إلى أي مدى ستستطيع الصين أن تعيد توجيه صادراتها المقيدة إلى الولايات المتحدة باتجاه أسواقٍ أخرى؟ وإلى أي مدى ستستطيع إعادة توجيه صادراتها إلى السوق الأميركية عبر دول ثالثة؟
حفلت وسائل الإعلام الغربية، في الأسابيع الفائتة، بتقارير تنذر بعواقب خطيرة على الاقتصاد الصيني من جراء الحرب الجمركية التي يركز ترامب رأس حربتها على الواردات الصينية تحديداً، إذ تبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على تلك الواردات 145%، وتصل أحياناً إلى 245%، بما يفوق تلك المفروضة على أي بلد، أو أي قطاع صناعي آخر، مثل الصلب والألمنيوم، أو السيارات، أضعافاً مضاعفة.
وترى الصين، بناءً على ذلك، أن الحرب الجمركية تستهدفها هي، وأنها المعنية بها، بالتالي، أكثر من غيرها.
فرضت الصين، في المقابل، رسوماً تبلغ 125% على معظم الواردات الأميركية، ورسوماً أخرى فوقها على الغاز المسال وحبوب الصويا.
كما فرضت قيوداً نوعية على تصدير المعادن النادرة، والتي تسيطر الصين على حصة كبيرة جداً من إنتاجها ومعالجتها عالمياً. وتستحوذ الصين على نحو 61% من إنتاج المعادن النادرة، و92% من تكريرها، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
صحيحٌ أن ممثلي أكبر اقتصادين في العالم دخلوا مفاوضاتٍ في سويسرا ربما تؤدي إلى خفض التصعيد في الحرب التجارية بينهما.
لكنْ، كما قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في 8/5/2025: “لا تتوقعوا كثيراً”، إذ إن تلك المحادثات ربما تخفّض الرسوم الجمركية عن مستوياتها الحالية التي بلغت عنان السماء، لكنها سوف تُبقِي حواجز جمركية مرتفعة بين البلدين، وقيوداً أخرى متعددة على التدفقات المالية والتكنولوجية بينهما.
يتوقع تقرير لبنك “نامورا” الياباني العملاق أن تكلّف الحربُ التجاريةُ الاقتصادَ الصينيَ 16 مليون وظيفة، بحسب وكالة رويترز في 7/5/2025. وكان تقريرٌ آخر لرويترز وغيرها، في 30/4/2025، نقَلَ اعتماداً على إحصاءات رسمية صينية أن نشاط المصانع الصينية تقلص بأسرع معدل منذ 16 شهراً في نيسان/ إبريل الفائت، من جراء انخفاض طلبيات التصدير، زاعماً أن المؤشرات القياسية للنشاط التصنيعي الصيني دخل طرَفا قدميها الأسبوع الفائت في مستنقع الركود.
كذلك يخلص تقريرٌ في موقع بنك “غولدمان ساكس”، في 6/5/2025، أن الزيادات التراكمية في معدلات الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً من جديد، سوف تؤدي، إذا بقيت قائمة، إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي الصيني الحقيقي 2.6%، منها 2.2% في العام الجاري.
ويجزم تقرير “غولدمان ساكس” بأن السياسات التوسعية، مالياً ونقدياً، التي تتبعها الصين حالياً من أجل تحفيز الطلب الكلي محلياً لن تكفي للتعويض عن خسائرها المحتملة من جراء انخفاض صافي صادراتها، وأن ذلك الانخفاض سوف يقلص معدل نمو اقتصادها المتوقع لعام 2025 في المحصلة من 4.5% إلى 4%، وفي عام 2026، من 4% إلى 3.5%. وهي نسب تتقاطع مع توقعات صندوق النقد الدولي IMF لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني، كما أشرت من قبلُ (في مادة “هل تنجح إجراءات ترامب في إبعاد الاقتصاد الأميركي عن حافة الهاوية؟”).
بلغت صادرات الصين إلى السوق الأميركية نحو 439 مليار دولار سنة 2024، وبلغت وارداتها من الولايات المتحدة نحو 144 مليار دولار في السنة ذاتها. ولا تمثل تلك المليارات، على الرغم من ضخامتها كقيم مطلقة، إلا 14.7% من مجموع صادرات الصين، أي أكثر من سُبعها بقليل، و6.3% من مجموع وارداتها.
لكن السوق الأميركية تبقى، مقارنةً بغيرها، أكبر سوق للصادرات الصينية عالمياً، تليها هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تبلغ الصادرات الأميركية إلى الصين 7.1% من مجموع صادرات الولايات المتحدة سنة 2024، لتأتي في المرتبة الثالثة، بعد كلٍ من كندا والمكسيك.
يعني ذلك، بالمقياس الكمي الصرف، أن تقييد الصادرات الصينية إلى السوق الأميركية سيكون أكثر ضرراً في الاقتصاد الصيني من ضرر تقييد الصادرات الأميركية إلى السوق الصينية في الاقتصاد الأميركي لأن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني تفوق نسبة الصادرات الأميركية إلى الصين من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
لكنْ، حتى في عز التصعيد المتبادل، ترك البلدان استثناءات واسعة من الرسوم الجمركية، حيث يمكن أن يمس انقطاعُها وارداتٍ حيويةً للأمن القومي، أو حيث قد يسبب اختناقات كبيرة اقتصادياً.
فترامب أعفى الصادرات الصينية من الهواتف الذكية والحواسيب وكثيراً من المكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات والألواح الشمسية وشرائح الذاكرة من الرسوم الجمركية، ما عدا الـ 20% المرتبطة بالعقوبات على الفنتانيل، في حين أعفت الصين “قائمة بيضاء” من الصادرات الأميركية إليها من الرسوم الجمركية تضم عدداً من المواد الدوائية (مثل محاليل الفحوص المخبرية)، وأشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة، وغاز الإيثان.
ثمة تقارير شتى في الإعلام الغربي عن أزمة تعانيها المصانع الصينية حالياً في تأمين معدن النحاس، وعن تضاؤل المخزونات الصينية من ذلك المعدن ذي الاستخدامات التصنيعية، وخصوصاً في مجالي الإلكترونيات والأدوات الكهربائية.
وتزعم تلك التقارير أن أزمة توافر النحاس تفاقمت صينياً بعد نشوب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي كانت تصدر 40% من خردة النحاس التي تستوردها الصين.
لكنها أزمة قصيرة المدى، أولاً، بالنظر إلى أن الشركات الصينية التي تسيطر على حزام مناجم النحاس في الكونغو تهدد بإغراق السوق العالمية بالنحاس. كما أنها “أزمة” تكذب مزاعم بدء دخول الاقتصاد الصيني في طور الركود، ثانياً، لأن معدل استخدام النحاس ما برح أحد مؤشرات حيوية النشاط التصنيعي في القرن الـ 21.
يصعب على الصين، على الرغم من ذلك، أن تخلد إلى الطمأنينة، لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية المحاذية للسودان، والغنية جداً بالمعادن ذات الاستخدامات الصناعية، مثل النحاس والكوبالت، إضافةً إلى الذهب والماس والمنغنيز وغيرها، تتعرض منذ أشهر لغزو من ميليشيا M 23 المدعومة من رواندا المجاورة والأصغر جغرافياً من الكونغو بكثير، لكنها مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
هو صراع دخلت قطر على خط الوساطة فيه بين رواندا والكونغو في شهر آذار / مارس الفائت، في الوقت نفسه الذي عرضت فيه رئاسة الكونغو على إدارة ترامب تسليم موارد البلاد للشركات الأميركية “مقابل الأمن” رافعةً الراية البيضاء!
وتتنصل الولايات المتحدة الآن من دعم ميليشيا M 23، وتفاوض إدارة ترامب من أجل توقيع اتفاقي معادن مع كلٍ من الكونغو ورواندا من خلال مستشار ترامب اللبناني الأصل، مسعد بولس.
تتجلى العبرة إذاً في سعي الولايات المتحدة إلى إخراج الصين من معادلة المعادن الوفيرة في أفريقيا، في سياق الصراع الدولي، جيوسياسياً، وفي سياق السعي أميركياً إلى ضرب مشروع التصنيع في الصين، والذي لا يقتصر على الحرب الجمركية.
في ذلك السياق تحديداً، يصبح مشهد تفكيك جمهورية الكونغو الديموقراطية، أكبر بلد في أفريقيا جنوبي الصحراء، والصراع الدموي الجاري فيه، أكثر وضوحاً، سواء لجهة ضرب عوامل النهوض في أفريقيا والجنوب العالمي، أم لجهة محاصرة الصين اقتصادياً.
لا يدرك معظمنا، إبان ذلك كله، الصلة العضوية بين معدن التنتالوم النادر، والذي تشغّل شذرات منه هاتفنا المحمول والجهاز اللوحي وغيرهما، وبين الحروب الدائرة في أفريقيا الوسطى وعليها، مع العلم أن معظم إنتاج العالم من ذلك المعدن يأتي من الكونغو ورواندا، ثم البرازيل.
من الواضح، في المقابل، أن الصين، في سعيها الدؤوب للالتزام بأولوية لعبة العولمة الاقتصادية التي وضعها الغرب ذاته، والتي أتقنتها الصين قبل أن يرتد الغرب عنها، ما برحت تفتقر إلى الأدوات والرؤى السياسية لبث نفوذها وللدفاع عن مصالحها خارج حدودها، كما أنها تفتقر إلى مشروع سياسي لمقاومة الهيمنة الغربية، بموازاة مشروعها الاقتصادي.
لعل الصين خُيّل إليها أن الغرب سيشاهد صعودها اقتصادياً وتكنولوجياً، وتحولها إلى أكبر مصنع للإنتاج وأهم بائع للصادرات عالمياً، وهو يتفرج عليها مهنئاً إياها بتفوقها عليه، في لعبتها ذاتها، عبر “المنافسة الشريفة”!
تركز التقارير والمقالات التي تتناول رد الصين المحتمل على الحرب الجمركية عليها، على مبادراتها الجديدة للتقارب مع الدول الدائرة في فلك الغرب الجماعي في آسيا، والمستهدفة (بمقدار أقل بكثير) بجمارك ترامب أيضاً، مثل كوريا الجنوبية واليابان، أو مبادراتها للتقارب مع أوروبا الغربية ذاتها.
لكنّ تلك الدول تخاف الصعود الصيني في محيطها المباشر ربما أكثر مما تخشى الولايات المتحدة تآكل نفوذها عالمياً إزاء الصين البعيدة. كما ترتبط تلك الدول بعلاقات تحالف استراتيجي عميقة ومعاهدات راسخة مع الولايات المتحدة تاريخياً، من حلف الـ”ناتو” في الغرب إلى حلف “جاركوس” JAROKUS الأميركي-الياباني-الكوري الجنوبي في الشرق.
لذلك، تبقى اليابان وكوريا الجنوبية من جهة، وأوروبا ككتلة، ممزقة بين مصالحها الاقتصادية مع شريكها التجاري الأول: الصين، ومصالح أمنها القومي مع شريكها السياسي الأول: الولايات المتحدة. وقد تخاف تلك الدول على صناعاتها من التعرض لإغراقٍ بالمنتجات الصينية الرخيصة التي تغلق السوق الأميركية في وجهها، كما “واشنطن بوست” في 18/4/2025.
تسعى الصين، في المقابل، إلى تعزيز صلاتها بمحيطها المباشر مع دول منظمة “آسيان”. ومن بين دول تلك المنظمة، كانت فيتنام وكمبوديا وماليزيا محطات في جولة للرئيس الصيني تشي جين بينغ الشهر الفائت جرى خلالها توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التبادل التجاري بين الصين وفيتنام، تبقى الأخيرة ساحة تنافس جيوسياسي حاد بين الصين والولايات المتحدة. كما أن الحدود التي رسمتها الصين في بحر الصين الجنوبي تضعها على حافة صدام محتمل مع معظم دول “آسيان”، ولا سيما الفيليبين. ويشكل ذلك كابحاً لتطوير علاقات الصين مع أعضاء المنظمة طبعاً.
يبقى السؤال الملح: إلى أي مدى ستستطيع الصين أن تعيد توجيه صادراتها المقيدة إلى الولايات المتحدة باتجاه أسواقٍ أخرى؟ وإلى أي مدى ستستطيع إعادة توجيه صادراتها إلى السوق الأميركية عبر دول ثالثة لا تفرض عليها إدارة ترامب رسوماً جمركية إلا بقيمة 10%؟
وهل تنقل الصين بعضاً من مصانعها إلى دول “آسيان” لتصدر إلى السوق الأميركية منها، مع العلم أن بروز فوائض تجارية كبيرة فجأة ربما يعرّضها لنقمة الإدارة الأميركية؟
أم أن إدارة ترامب ستنجح، ببساطة، في إجبار الصين على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة؟ مع العلم أن تقريراً في “ساوث تشاينا مورنيغ بوست”، في 27/4/2025، بعنوان “الشركات الصينية تتسابق لفتح مصانع لها في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة” يؤكد أن بعضاً من هذا يحدث فعلاً؟
وهل تنجح إدارة ترامب في استراتيجيتها الرامية إلى عزل الصين عن العالم اقتصادياً، في ضوء اعتماد العالم على الصين، لا في حيز السلع الرخيصة فحسب، بل في حيز التكنولوجيا المتقدمة الأقل تكلفةً؟ مع العلم أنها أطلقت مؤخراً DeepSeek، كمنافس لـ ChatGPT، وأن شركة BYD الصينية تفوقت على “تسلا” العام الفائت، كأكبر صانع للسيارات الكهربائية، وأن شركة “أبل” Apple تخسر حصتها السوقية باضطراد لمنافسيها الصينيين مثل “هواوي” و”فيفو”، وأن الصين أعلنت أنها ستنفق تريليون دولار في غضون العقد المقبل لدعم الابتكار في حقل الذكاء الاصطناعي، كما أنها تراهن على بنيتها التحتية المتقدمة في مجال سلاسل الإمداد، وعلى حذاقة يدها العاملة، بحسب موقع الـ BBC في 24/4/2025 تحت عنوان “خمس أوراق تملكها الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة”؟
يزداد ذلك السؤال إلحاحاً في ضوء تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، في 15/4/2025، قال إن وزير المالية الأميركي، سكوت بيسنت، بصدد التفاوض مع أكثر من 70 دولة كي تقنن علاقاتها اقتصادياً مع الصين في مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية عليها.
ورداً على ذلك “التسريب”، حذّر ناطق بلسان وزارة التجارة الصينية شركاء الصين التجاريين من الانجرار إلى لعبة عزل الصين مؤكداً أن الصين سوف ترد على أي إجراء ضدها بالمثل.
لكن الرهان على حفاظ الصين على تقدمها يعتمد على تفعيل أوراقها اقتصادياً في الداخل الصيني أكثر مما يعتمد على الخارج. وما يزال معدل الاستهلاك الصيني منخفضاً نسبياً عند أقل من 40% من الدخل سنة 2024، في مقابل ارتفاع نسبة الادخار من الدخل إلى 33%.
لذلك، قامت الصين مؤخراً بتخفيض معدل الفائدة الأساس من 1.5% إلى 1.4%، وبتخفيض الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 6.6% إلى 6.2%، وبإطلاق مشاريع حكومية لإنفاق مئات المليارات لتحفيز الاقتصاد.
وبحسب تقرير مهم جداً لمؤسسة “راند”، نُشر في 17/4/2025، عما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من تجربة الصين الصناعية، فإن الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد عالمياً، بالأسعار الجارية بالدولار الأميركي، لم يعد صغيراً، وبالتالي لم يعد التصدير إلى العالم كافياً لتحريك عجلاته، وأن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني انخفضت من ذروتها التي بلغت 35% سنة 2006 إلى أقل من 19% سنة 2024، وأن نقطة التحول الكبرى، على هذا الصعيد، جاءت سنة 2010، وأن الصين توقفت منذ عام 2015 عن تخفيض سعر عملتها من أجل تشجيع صادراتها، لأنها باتت أكثر قلقاً من هجرة رؤوس الأموال من اليوان إذا انخفض سعره أكثر.
باختصار، من الطبيعي أن الصين التي يعد اقتصادها الأكبر عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity لم يعد يكفيها العالم كي تنمو من خلال تصدير البضائع الرخيصة إليه كما كانت تفعل من قبل.
لذلك، في الوقت الذي يتوجب عليها التصدي للتحديات التي تواجهها خارجياً، والحروب التي تُشَنّ عليها، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهها حالياً هو تفعيل الطلب الكلي داخلياً من خلال زيادة الاستهلاك والإنفاق الحكومي، وهو تحدٍ تحلم معظم دول العالم حلماً لو كانت تواجهه عوضاً عن الصين: كيف تواجه تحفظ الصينيين في الإنفاق، وحرصهم على الادخار؟!
د.إبراهيم علوش