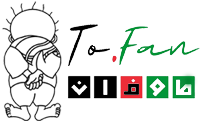في خضم الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وتصاعد أزمات الحصار والحروب، تبرز اليوم ملامح مشروعين متقابلين في الزخم والدلالة: من جهة، ما يُعرف بـ خطة ترامب التي طرحت في سياق المساعي الدولية لإعادة ترتيب المشهد في غزة، ومن جهة أخرى أسطول الصمود كفعل رمزي وشعبي يُحاول كسر الحصار البحري على القطاع وإذكاء حضور القضية على الصعيد العالمي. هذا التناقض بين مشروعٍ مركزي يرتكز على إعادة هندسة الواقع الفلسطيني عبر معادلات سياسية ـ تقنية، وبين مبادرةٍ تقليدية لكنها مؤثرة بمعناها الرمزي، يعكس صراعًا أعمق بين قراءات مختلفة للقضية الفلسطينية: قراءة من القمة والتفاوض، وقراءة من القاعدة والمقاومة.
في هذه الورقة سنستعرض مكونات كل مشروع، ونحلل نقاط التناقض الأساسية، ونتناول التحديات والفرص المحيطة بكل منهما، في ضوء السياق الإقليمي والدولي الراهن.
مكونات “خطة ترامب”: البناء والآليات والرهانات
خطة ترامب التي طرحت في سبتمبر 2025 تتألف من عشرين نقطة (20-Point Plan) تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة بناء غزة ضمن أطر أمنية وسياسية مقيدة. من أهم محاورها:
- وقف عمليات القتال فور توقيع الاتفاق، وسحب تدريجي للقوات الإسرائيلية مقابل قيام آلية تبادل أسرى / رهائن.
- إنشاء هيئة مؤقتة (Board of Peace) يرأسها ترامب تتولى الإشراف على الحكم التقني وتحويل غزة إلى منطقة تنموية مؤقتة، مع مراقبة دولية.
- فرض شرط أن لا يكون لحماس أي دور لاحق في الحكم، مع شرط تفكيك البنى العسكرية (أنفاق، مصانع سلاح، بنى تحتية عسكرية).
- تأهيل البنى التحتية: الكهرباء، المياه، الطرق، إعادة الإعمار، دعم التشغيل والقطاع الخاص، منطقة اقتصادية خاصة (Special Economic Zone).
- ضمان ألا يُجبر الأشخاص على الخروج من غزة، مع السماح للراغبين بالمغادرة (والعودة إن رغبوا) ضمن آليات مشروطة.
- نشر قوة دولية مؤقتة (International Stabilization Force – ISF) تعمل بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ودول الجوار لتأمين الحدود ومراقبة الامتثال.
هذه الخطة تحاول الدمج بين البعد الأمني، والبعد التنموي، والبعد المؤسساتي في صيغة “نهج تكنوقراطي” يُفترض أنه يخرج غزة من دوامة العسكرة ويُنقذها عبر إعادة البناء.
لكن في المقابل، يقرّ المحللون بأن هذه الخطة مشحونة بعدم وضوح في عدد من النقاط، خاصة فيما يتعلق بمسارات التنفيذ، وتوقيت الانسحابات، وآليات الرقابة والمساءلة، وأدوار القوى الإقليمية في ضمان التزام الأطراف.
من الجدير بالذكر أن الخطة ترفض التهجير القسري، وتؤكد أن الهدف ليس تفريغ غزة، مع بعض الضبابية حول قدرة الضمانات على منع العودة القسرية أو الضغوطات السياسية لاحقًا.
من منظور استراتيجي، فإن الخطة تمثّل محاولة لفرز سياسي جديد: فصل البعد العسكري عن البعد المدني، وإخراج المقاومة التقليدية من المعادلة السياسية، وفرض شبكة أمان دولية عبر هيمنة أمريكية وتقنين عالمي. إنها إعادة تأسيس المشهد الفلسطيني عبر آليات “السلام من الأعلى”.
أسطول الصمود: المبادرة الشعبية وتحدّي الحصار
على الضفة الأخرى، يبرز ما يُطلق عليه أسطول الصمود / Global Sumud Flotilla، كأحدث محاولة لكسر الحصار البحري على غزة أو على الأقل فرض انعكاسات إعلامية وسياسية لهذا الحصار. هذه المبادرة تتشكّل من مئات الناشطين من عشرات الدول، يحملون قوافل بحرية تحمل مساعدات رمزية (طبية، غذائية، لوجستية) في سبيل الاستفزاز الرمزي أولًا، وإحداث ضغط قانوني ودولي ثانياً.
في أكتوبر 2025، اعترضت إسرائيل معظم السفن أثناء عبورها المياه الدولية، بحجة أنها اقتربت من منطقة مراقبة بحرية ومناطق محظورة، وتم احتجاز المشاركين، باستثناء سفينة واحدة نجحت مؤقتًا في دخول مياه القطاع.
من المنظور القانوني، تؤكد المبادرة أن إغلاق البحر وحرمان غزة من ممر بحري يُفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية قانون البحار (UNCLOS)، والاتفاقيات التي تُجبر الدول على السماح بمرور المساعدات الإنسانية.
من الناحية الرمزية والسياسية، فإن أسطول الصمود:
- يُذكّر الرأي العام العالمي بأن الحصار البحري لغزة ليس مجرد إجراء تكتيكي، بل عنصر أساسي في إطباق الحصار الشامل عليها، والتحكم في طرق الوصول.
- يسلط الضوء على معاناة غزة في أوقات الحرب، ويرفع سقف الانتباه الحقوقي والإعلامي لقضية الحصار وقانونية الاعتداء على السفن المدنية.
- يوفّر منصة للفاعلين المدنيين الدوليين والشخصيات المعروفة للانخراط في القضية الفلسطينية، والمحافظة على استمرار حساسيتها في الإعلام العالمي.
لكن المبادرة تواجه تحديات هائلة:
- القدرة العسكرية واللوجستية المحدودة مقارنة بقدرات البحرية الإسرائيلية، خاصة مع استخدام وسائل التشويش، الاعتراض البقري أو البحري، قطع الاتصالات، المقاومة المادية للعبور.
- الخطر القانوني والاعتقال والملاحقة للمشاركين، والتي قد تُستخدم كآلية ردع من قبل إسرائيل أو حلفائها.
- أن المساعدات التي تصل غالبًا تكون رمزية ولا تفي بمساحات الاحتياج الواسعة، ما يجعل التأثير الميداني محدودًا.
- الانقسام في المواقف الدولية: بعض الدول تدعم حقوق المرور والمساعدات، وبعضها تقف محايدة أو تدعم حجج إسرائيل.
- التحدي في تحويل هذه المبادرة الرمزية إلى أداة سياسية مؤسَّسة ذات تأثير دائم، وليس مجرد حادث إعلامي.
التناقضات الجوهرية بين المشروعين
عند وضع المشروعين في مواجهة تحليلية، تبرز عدة تناقضات هيكلية:
البعد خطة ترامب أسطول الصمود
المنطق المؤسسي من القمة والسيطرة السياسية، فرض إعادة البناء ضمن مراقبة دولية من القاعدة والمقاومة المدنية، كسر الحصار وفرض الوجود
العسكرية مقابل المدنية تفكيك المقاومة كشرط أساسي للمشاركة السياسية المقاومة المدنية والضغط القانوني والرمزي
دور الفاعلين الدوليين مركزي، عبر إشراف دولي وهيمنة أمريكية داعم أو مساند، لدعم الحق في الوصول وإدانة الحصار
المخاطر القانونية طغيان الأجندات السياسية على الالتزام بحقوق السكان الاعتراض على الحصار البحري وإعادة التأكيد على القانون الدولي الإنساني
مدى التأثير الفعلي يعتمد على التوافقات السياسية والتنفيذ يعتمد على الرأي العام الدولي، التأثير الرمزي، النشاط المدني
هذا التباين يعكس تحولًا في أساليب المواجهة الفلسطينية: من الاعتماد على التفاوض والتكتيكات الدبلوماسية، نحو الاستنهاض الرمزي والحراك الشعبي الدولي كمعادلة موازية.
السياق الإقليمي والدولي: متغيرات التأثير
لكي نفهم فرص وتحديات كلا المشروعين، لا بد من ربطهما بالسياق الإقليمي والدولي:
- توازن القوى الإقليمي: دول مثل مصر، تركيا، قطر، إيران، والإمارات تلعب أدوارًا مهمة في الوساطة والدعم، وقد تتأثر مواقفها من أي مشروع يُصاغ.
- الانكفاء الغربي وتقلب المواقف: القوى الغربية، وخصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا، قد تدعم مشاريع السلام المهيكلة، لكنها تتقلب في مواقفها تجاه الحروب والحصار وحقوق الإنسان، مما يؤثر في إمكانية تنفيذ خطة ترامب أو الحماية القانونية لأسطول الصمود.
- الحضور الإعلامي الدولي وحركات التضامن: في السنوات الأخيرة، اكتسبت حركات التضامن المدني قوة أكبر في التأثير على الرأي العام، خصوصًا عبر وسائل التواصل والمناصرة القانونية – الأمر الذي يعزز فرص أسطول الصمود.
- الأزمات المتزامنة (سوريا، لبنان، اليمن، العراق): هذه الملفات تستنزف التركيز والدعم الدولي، وقد تجعل القضية الفلسطينية في المرتبة الثانية إن لم يكن الثالثة، ما يضغط على المشاريع التي لا تملك آليات قوة قوية.
- الشرعيات الدولية والقانون الدولي: قرارات الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، الآليات القانونية ضد الحصار وجرائم الحرب، كلها قد تشكّل غطاءً أو رادعًا لأي طرف يتجاوز الخطوط.
الفرص والتحديات المشتركة والمسارات الممكنة
الفرص المحتملة:
- يمكن أن يُشكّل أسطول الصمود رافعة إعلامية وقانونية تُسهم في كسر جمود الموقف الدولي تجاه الحصار، وإحياء الضغط على المؤسسات الدولية لفتح قنوات بحرية مجهولة أو جديدة.
- قد تستفيد خطة ترامب من رعاية قوية من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي ترى في إدارة إعادة الإعمار والاستقرار مصلحة استراتيجية، خصوصًا إذا ربطت الخطة بإعادة جذب التمويل العربي والدولي إلى غزة.
- إمكانية الدمج بين المشروعين: قد تُستثمر رمزية أساطيل الصمود لدعم المفاوضات، أو أن يُعطى الحراك البحري غطاءً من خطة إعادة البناء كجزء من آليات الوصول.
- في حال نجحت المبادرة البحرية في تحقيق اختراق فعلي ولو جزئي، ستُشكّل سابقة في كسر الحصار، وتُغيّر قواعد الاشتباك الرمزية مع الاحتلال.
التحديات الكبرى: - التنفيذ العملي لخطة ترامب مرهون بموافقة الأطراف، لا سيما حماس، التي قد ترفض تفكيك بنيتها العسكرية أو التخلي عن دورها السياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقلاب في الاتفاق أو فشل مبكر.
- الخطر أن تُستخدم خطة ترامب لشرعنة تحوُّل السيطرة على غزة إلى إدارَة دولية بغطاء أمريكي، مما يُثير جدلًا حول نوعية السيادة الفلسطينية المستقبلية.
- ضعف القدرات المادية والتنسيقية لدى أسطول الصمود، خصوصًا في مواجهة الاعتراضات البحرية والتقنيات المضادة المعتمَدة من إسرائيل.
- احتمالية أن يُواجه المشاركون في الأسطول بملاحقات قانونية، قرارات حظر، أو إجراءات دبلوماسية ضاغطة لردع التجارب المقبلة.
- التناقض في الرؤى بين القوى الفلسطينية (فتح، حماس، الفصائل)، قد يُضعف أي جهد موحد يستند إلى المبادرة البحرية أو الاتفاق التفاوضي.
- امتصاص القضية من قبل مشاريع إقليمية أو دولية تُغري بالفعل التنموي مقابل التفريط السياسي، وقد تُستخدم خطة ترامب كذريعة لإبعاد الفلسطينيين عن صلب الصراع إلى “إدارة الأزمة”.
الخاتمة
إن التناقض بين خطة ترامب وأساطيل الصمود ليس مجرد مواجهة بين مشروع كبير وآخر صغير، وإنما صدام بين رؤيتين لاستعادة فلسطين: رؤية مركزية تستند إلى إعادة البناء والهيكلة عبر آليات دولية، ورؤية شعبية تُعلي من منطق الحراك المدني والرمزية القانونية. قد لا تنجح أي من المشروعين لوحده من دون تفاعل تكاملي بينهما، ومن دون تحالفات إقليمية ودولية حقيقية تدعم التنفيذ والمساءلة.
للتأثير في المستقبل، يُنصَح بما يلي:
- تكوين إطار فلسطيني موحَّد يضم القوى السياسية والمجتمعية لدعم الحراك البحري والسياسي معًا.
- العمل على استثمار النجاحات الرمزية للأساطيل في بناء رأي عام دولي وضغط دبلوماسي لاحق.
- ربط تنفيذ أي خطة إعادة بناء بشرط الالتزام بصون الحقوق الأساسية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مع آليات رقابة شفافة.
- استغلال البعد القانوني الدولي: تدويل المسألة أمام المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لتعزيز موقف أسطول الصمود ومساءلة الانتهاكات.
- الحرص على الارتباط مع جبهات الدعم الإقليمي – من تركيا إلى إيران إلى منظمات التضامن – لتوسيع الغطاء والدعم المالي والدبلوماسي.
إن الرهان ليس على أحد الأسطولين وحده، بل على قدرتهما على التحرك التكميلي: أن تجعل رمزية الملاحة في البحر دعامة للمشروع السياسي، وأن تمنح “خطة السلام” شرعية شعبية لا تُبنى فقط من فوق، بل تُدعّم من أسفل. في هذا التوازن، قد يكمن مفتاح تغيير المعادلة في فلسطين.
خالد ناصيف