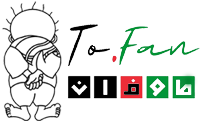اليهـودية، الصهـيـونية، ومسألة “إسرائيل الكبرى” عقائدياً |د.إبراهيم علوش
تقبع، بين جولات الصراع مع العدو الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني، مسألة جوهرية، يتحرج كثيرون من الخوض فيها، على الرغم من أنها تمثل رافعة أيديولوجية لزعزعة استقرار المنطقة من المنظور الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني، وهي مسألة “الوعد الإبراهيمي”، أي مقولة وعد الله إلى النبي إبراهيم، والتي زعموا أن الله منح بني إسرائيل بموجبه أراضيَ شاسعةً بين نهري الفرات والنيل، بحسب سفر التكوين، الفصل أو الإصحاح 15، الأعداد 18 -21.
يمثل ذلك “الوعد الإلهي”، بالمناسبة، ركناً ثابتاً ومكيناً من أركان الديانة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، بعد التوحيد مباشرة، وقبل التوراة وقوانين الشرع اليـ.ـ.ـهـ.ـودي الـ613 (المسماة “متزفوت”)، أي أنه ليس شطحة فرقة “متطرفة” أو “شاذة”، كما التكفير في الإسلام أو المسيحية مثلاً.
ويرى معظم أحبار اليـ.ـ.ـهـ.ـود ذلك الوعد عهداً أبدياً وغير مشروط وغير قابل للنقض، كما يرونه مستقلاً عن سلوكياتهم الجمعية والفردية، بحسب تأويلهم للإصحاحات 12 و15 و17 من سفر التكوين، باستثناء بعض الشعائر التي يفترض بهم أن يلتزموا بها، كالختان.
وفي سفر الخروج، الإصحاح 23، العدد 29، نفهم أن الله لن يعطي بني إسرائيل كل تلك الأراضي في سنة واحدة، ولن يطرد أهلها منها مرةً واحدة، لئلا يعم فيها التوحش، ما يمثل خطراً على بني إسرائيل. لكننا نفهم من ذلك أن مشروع التهجير، وزعزعة الاستقرار كي يجري التهجير، لا يقتصر على الغزيين، أو حتى على الفلسطينيين وحدهم.
يذكر، بالمناسبة، أن جبل الروس في مزارع شبعا (“بيتاريم” في المصطلح الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني) هو المكان الذي تلقى فيه النبي إبراهيم عهد الله بأنه وذريته سيرثون “أرض إسرائيل” بين الفرات والنيل. لذلك، فإن تلك المزارع لا تتمتع بأهمية استراتيجية فحسب، بل بأهمية عقائدية أيضاً.
وبعد “العهد الإبراهيمي”، جرى تجديد العهد الإلهي، بحسب الرواية التوراتية، مع النبي موسى في سيناء، بأنه وذريته سيرثون أرض الكنعانيين، أرضنا، بحسب الإصحاحين 23 و13 في سفر الخروج، والإصحاح 3 في سفر التثنية.
ونفهم من سفر الأعداد، بحسب الإصحاح 34، أن حدود تلك الأرض ليست من الفرات إلى النيل في تلك المرحلة، بل موطئ قدم أولي يمتد من رأس شكا في البترون شمالي لبنان شرقاً إلى قرية صدد في حمص، ثم جنوباً بحيث يجري اقتطاع أجزاء من محافظتي حمص وريف دمشق، نزولاً بمحاذاة سلسلة جبال لبنان الشرقية جنوباً، ثم بمحاذاة نهر الأردن، ومن بحيرة طبريا إلى البحر الميت، ومن جنوبيه بصورة قُطرية عبر منتصف بادية النقب، والعودة بعد ذلك شمالاً بحيث يجري اقتطاع الأقسام الشرقية من محافظة شمال سيناء حالياً. والعبرة في تلك الخريطة أن لبنان مثلاً يصبح بموجب العهد الموسوي جزءاً لا يتجزأ من “أرض إسرائيل”. وهذه، على الهامش، لعناية “السياديين”.
تتألف التوراة من 5 أسفار، هي تكوين، خروج، لاويين، عدد، وتثنية. لكنّ “العهد القديم” لا يقتصر على التوراة، بل يضم كتباً أخرى مثل الأسفار التاريخية وأسفار الحكمة وأسفار الأنبياء.
وفي سفر حزقيال في كتاب الأنبياء، الإصحاح 47، ثمة تعديلات على خريطة الغزو الواردة في سفر الأعداد، إصحاح 34 أعلاه، بحيث تمتد “أرض إسرائيل” شمالاً بصورة أوسع في لبنان، من جبل عكار، بدلاً من رأس شكا كما جاء سابقاً، ثم شرقاً إلى صدد في حمص، لكن تقل النسبة المقتطعة لـ “أرض إسرائيل” شرقاً من محافظتي حمص ودمشق، وتزيد النسبة المقتطعة من جنوبي سورية، كما تقل النسبة المقتطعة من بادية النقب ومن شمالي شرقي سيناء.
جاء العهد الموسوي بعد 430 عاماً من العهد الإبراهيمي، بحسب الرواية ذاتها، لا لينقضه أو يقلصه، بل ليثبّته بصفته “عربوناً” للوعد الإبراهيمي، ومصداقاً له، وبصفته “كوشان أرض”، أو سند ملكية رسمياً لمعظم لبنان وفلسطين وبعض سورية والأردن وسيناء.
لكن العهد الموسوي جاء مشروطاً هذه المرة بطاعة الله والخضوع لقوانينه. وكانت الغاية منه، بحسب التفاسير اليـ.ـ.ـهـ.ـودية دوماً، “تعليمية” و”تربوية”، ريثما يأتي المسيح المنتظر. أما عدم الالتزام بما أنزل على الأنبياء، بحسبهم، فعليه عقوبة وجزاء، لكنه لا يبطل الوعد الإبراهيمي المزعوم بأن تكون الأراضي بين الفرات والنيل لبني إسرائيل في أي حالٍ من الأحوال.
ثم هناك، ثالثاً، عهد داوود، في سفر صموئيل الثاني، الإصحاح السابع، وفي مقاطع أخرى في العهد القديم، بأن يتربع على عرش إسرائيل إلى الأبد حاكمٌ من صلب داوود، وصولاً إلى قدوم المسيح، وهو عهد غير مشروط على بني إسرائيل ككل، ومشروط على الحاكم الفرد. وهذا بدوره عهدٌ يكرس فكرة “يـ.ـ.ـهـ.ـودية الحكم” فعلياً في “أرض إسرائيل”. وهذه، على الهامش، لعناية من يريدون تحويل الكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني إلى “دولة ديموقراطية لمواطنيها كافةً”.
تلك عقائد مستلة من الرواية التوراتية والتيارات الرئيسة في الديانة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، وقد ظلت كامنة في الوعي اليـ.ـ.ـهـ.ـودي على مدى آلاف الأعوام قبل نشوء الحركة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية الحديثة في القرن الـ 19 للميلاد. فهي الخامة الأيديولوجية التي استُخلصت منها الفكرة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية، ولم تأتِ تلك الفكرة من فراغ، ولم تولد من عدم، ولم يكن الاستعمار الغربي هو الذي فبركها وفصلها وألبسها للغزاة اليـ.ـ.ـهـ.ـود كي يوظفهم في مشروعه الجيوسياسي، بل كانت صلة تلك العقائد بفلسطين وجوارها هي التي جعلتها قابلة للتوظيف استعمارياً.
لم تبدأ الفكرة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية مع ثيودور هرتزل أو مع كتابه “الدولة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية” (1896)، ولم يكن هرتزل الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني الأول، بل جاءت الحركة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية نتيجة مخاض اصطدام أوروبا بالتجربة القومية العلمانية من جهة، والاستعمار الحديث من جهة أخرى.
وقبل هرتزل، وجدت في العصر الحديث تيارات صـ.ـهـ.ـيـ.ـونية قوية ومتنوعة الاتجاهات كانت مأثرة التنظيم الذي أسسه هرتزل، أو “المؤتمر الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني العالمي”، أنه نجح في توحيدها، أو توحيد معظمها على الأقل.
لكنْ، قبل هذا، يجدر القول إن ارتباط العقيدة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية عضوياً بمقولة “أرض إسرائيل”، وبالقدس عاصمةً لها، لا على سبيل الحج مثلاً، كما مكة للمسلمين أو الفاتيكان للكاثوليك، بل كـ “أرض ميعاد” منحها الله لليـ.ـ.ـهـ.ـود كي يؤسسوا فيها حكماً سياسياً، إضافةً إلى الاستناد إلى روايات التوراة ومفسريها لتأسيس مرجعية تاريخية، حقيقية أو مفبركة، لدولٍ يـ.ـ.ـهـ.ـودية في المنطقة قامت قبل آلاف السنين، وعدم تحديد حدود “أرض إسرائيل” بصورة واضحة حتى في أسفار التوراة، جعل بلادنا مهددة بالغزو دوماً بمجرد دخولها في حالة ضعف.
وفي الوقت الذي يجري فيه التركيز على صلة الإسلام المزعومة بالإرهاب، وتجري المطالبة بحذف الآيات القرآنية المتعلقة بالجهاد، أو المناهِضة لليـ.ـ.ـهـ.ـود، فإن الحري بنا أن نطالب كعرب ومسلمين بأن يجري تعقيم العقيدة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية من المقاطع التي تزعم حقاً في أرضنا، كبيراً بين الفرات والنيل، أو صغيراً في فلسطين وجوارها، لأن ذلك يمثل مشروعاً دائماً للغزو والاحـ.ـتـ.ـلال والتهجير والمـ.ـجازر.
فلو افترضنا جدلاً أننا تمكنا من دفن الكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـوني غداً، فإن القنبلة الموقوتة المتمثلة بمقولة “أرض الميعاد” ستبقى خطراً ماثلاً على الأمن القومي العربي حتى بعد آلاف السنين، لأن صلة اليـ.ـ.ـهـ.ـود بالأرض، أرضنا، لا تمثل عقيدة دينية فحسب، بل تحولت إلى هوية ثقافية يتمثلها حتى العلمانيون والملحدون بينهم، حتى تحولت تلك الصلة المزعومة بالأرض إلى مكونٍ رئيس لما يسمى “الهوية اليـ.ـ.ـهـ.ـودية”، بعيداً حتى عن الإيمان بالله أو التوراة.
تجري الرواية التوراتية بأن اليـ.ـ.ـهـ.ـود في العالم يعيشون في “الشتات” منذ التدمير الثاني لهيكل سليمان في القدس على يد الرومان سنة 70 بعد الميلاد. وتزعم الرواية ذاتها حضارةً يـ.ـ.ـهـ.ـودية عامرة في المنطقة قبل 3 آلاف عام وصولاً إلى سنة 70 للميلاد.
هذه السردية، بغض النظر عن مدى دقتها تاريخياً، أصبحت جوهرية في تكريس الصلة بالأرض، وفي جعل اليـ.ـ.ـهـ.ـودي خارج “أرض الميعاد” في حالة لجوء أو شتات، وبالتالي في وضع مفهوم “العودة” Aliyah في مقابل مفهوم “الشتات” Diaspora. وليست الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية سوى تجميعاً لذلك “الشتات” لإقامة “وطن قومي لليـ.ـ.ـهـ.ـود”، عوضاً عن انتظار الله ليقوم بالمهمة ذاتها، كما كانت تنحو اليـ.ـ.ـهـ.ـودية التقليدية.
كذلك تكرّس مفهوم الارتباط بالأرض ثقافيأ في المناسبات والأعياد اليـ.ـ.ـهـ.ـودية مثلاً، والتي يحييها اليـ.ـ.ـهـ.ـود المتدينون وغير المتديّنين. فعيد “هانوكا” مثلاً يمثل إحياء لثورة ضد اليونانيين، وعيد الفصح إحياء للخروج من مصر إلى أرض كنعان، وعيد يوم “كيبور”، عيد الغفران، هو اليوم الذي عفا فيه الله عن تجاوزات بني إسرائيل في سيناء، إلخ…
وفي ختام الفصح والغفران، وفي المناسبات العامة والخاصة، يحتفلون قائلين: “العام المقبل في القدس”، وهو عنوان ذو مغزى ثقافي ورمزي عميق تردّد صداه على مدى آلاف السنين، ولا يمكن أن نتغاضى عن حقيقة كونه موجهاً ضدنا.
كما أن الشكر على “أرض الميعاد” عنوان رئيس في الصلاة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية التي تعقد 3 مرات يومياً. وفي دعاء الشكر، في الأعراس، وبعد تناول الطعام، المسماة “بركات همازون”، تتضمن البركة الثانية والثالثة، من أصل أربع بركات، شكراً على غزو أرض كنعان، ودعوةً لإعادة إعمار القدس باليـ.ـ.ـهـ.ـود.
وما زال هنا الحديث في حيز التقاليد الدينية والثقافية اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، قبل نشوء الحركة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية وبموازاتها، فإذا انتقلنا إلى النسخ العلمانية والحديثة من الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية، فإن الصلة بالأرض، أرضنا، تصبح أكثر وضوحاً وعدوانيةً وشراسة، كما رأينا في المئة عام الأخيرة، لأن الحركة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية لا تمثل قطيعةً مع التقاليد اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، كما يزعم البعض، بل تكثيفاً ثقافياً وتفعيلاً سياسياً لها، مع أو من دون تديّن.
من الأهمية بمكان، في هذا السياق، التركيز على أن العرب الكنعانيين وجدوا في “الأرض الموعودة”، بحسب “العهد القديم” ذاته، قبل بني إسرائيل وخلال عبورهم وبعد رحيلهم، سواء كانت قصص التوراة عن “الدول اليـ.ـ.ـهـ.ـودية” التي نشأت في أرض كنعان قبل 3 عام صحيحة أم لا (ومن هنا قول الرئيس ترامب أنه حلّ صراعاً عمره 3 آلاف عام!).
كما أن الحركة التي نشأت في أوروبا في القرن الـ 19 لدمج اليـ.ـ.ـهـ.ـود في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها، والتي قضت عليها الحركة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية فعلياً، تمثل الحل التقدمي للمسألة اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، إذا صح التعبير.
لكن المقولة التوراتية بشأن “أرض الميعاد”، وخصوصاً عندما تجري علمنتها لتتحول إلى عقيدة سياسية مع الحركة الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية، ليجري من بعد ذلك تسويغ تلك العقيدة السياسية دينياً من طرف تيار الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونية الدينية، تظل مقولةً عقائدية تقوم على الإيمان أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي فإن تحصين الناس منها يتطلب إيماناً أصلب حتى لا تجري صـ.ـهـ.ـيـ.ـنة شعبنا بالمقولة “الإبراهيمية” كما جرت صـ.ـهـ.ـيـ.ـنة عشرات الملايين في الغرب على يد تيار المسيحية المتصـ.ـهـ.ـيـ.ـنة.
وهو أمرٌ غريبٌ حقاً على المسيحية ذاتها، لأن “العهد الجديد”، والذي جاء مع النبي عيسى المسيح عليه السلام، جاء ناقضاً، اسماً ومضموناً، للعهد القديم الذي يعتنقه اليـ.ـ.ـهـ.ـود. وتميز ذلك بجعل العهد الجديد شاملاً لكل المؤمنين، لا لليـ.ـ.ـهـ.ـود أو لبني إسرائيل فحسب، وبأنه ألغى فكرة “أرض الميعاد”، ليجعل العهد شاملاً لكل الأرض.
من المهم جداً التنبيه إلى أن “المقولة الإبراهيمية”، كعنوان رئيس لما يسمى “الديانة الإبراهيمية”، تعني صـ.ـهـ.ـيـ.ـنة المسيحية والإسلام من خلال الإقرار بأن الله وَعَدَ اليـ.ـ.ـهـ.ـود بحكم المنطقة الواقعة بين الفرات والنيل بصورة غير مشروطة.
فالإبراهيمية تعني الإقرار بمقولة “إسرائيل الكبرى”، لأن الله عز وجل، بحسب التوراة وأحبار اليـ.ـ.ـهـ.ـود، ألزم نفسه بذلك العهد مع اليـ.ـ.ـهـ.ـود إلزاماً لا رجعة فيه بغض النظر عن أي شيء. وأود لفت النظر هنا إلى أن ما جاء في الآية 64 من سورة المائدة: “وقالت اليـ.ـ.ـهـ.ـود يدُ الله مغلولةٌ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا”، لا يمكن فهمه خارج سياق “الوعد الإبراهيمي”، لأنهم زعموا أن عطاء الله يقتصر عليهم فحسب، والمسألة تتعلق بالأرض في جوهرها.
العبرة أن “العهد الإبراهيمي” في التوراة يقتصر على ذرية إبراهيم من السيدة سارة، اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، أما ذريته من السيدة هاجَر، غير اليـ.ـ.ـهـ.ـودية، فغير مشمولين بذلك العهد، ولو كانوا مشمولين به لاعتبر العهد متحققاً بسيطرة العرب على المنطقة الواقعة بين الفرات والنيل.
لذلك، يصعب فهم الآية 67 من سورة آل عمران بأن إبراهيم كان مسلماً حنيفاً، وما جاء في الآية 68 بعدها: “إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ”، إلا في سياق الرد على “المقولة الإبراهيمية” كما وردت في التوراة.
وهذا النبي عربي، وهو ومن اتبعوه الأحق بإبراهيم، وبالتالي الأحق بوراثته، دينياً، وبين الفرات والنيل، في حين أن إسحاق، ابن سارة، هو الذي يرث العهد في التوراة، لا أبناء إبراهيم من هاجر.
ليس إسماعيل، ابن إبراهيم من هاجر، نبياً في التوراة، بل ابن جارية فحسب، وكذلك إخوته من هاجر. في حين أن مكانة السيدة هاجر في الإسلام عظيمة، ويكفي أن الطواف سبعاً بين الصفا والمروة في الحج والعمرة جاء تيمناً بطوافها بينهما بحثاً عن الماء لابنها إسماعيل، الذي يعد جد العرب، وجد النبي محمد (ص). والسيدة هاجر في المراجع الإسلامية أميرة ابنة ملك حاربه فرعون مصر وهزمه، لا جارية.
أخيراً، لا يمكن فهم العدد الكبير من المرات التي يتحدث فيها القرآن عن نقض اليـ.ـ.ـهـ.ـود للعهود، كما في الآية 13 من سورة المائدة: “فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً يحرفون الكلم عن مواضعه”، خارج سياق نقض السردية التوراتية بشأن الوعد الإلهي، وإن ذكر تحريف الكلام في الآية ذاتها مع نقض الميثاق تفيد هذا المعنى تحديداً.
الفروق كبيرة، وهي ذات دلالات سياسية معاصرة وراهنة. والرد على المقولة الإبراهيمية نجده في القرآن، وهو سلاحٌ فعّالٌ في مواجهة مشروع صـ.ـهـ.ـيـ.ـنة المنطقة، وصـ.ـهـ.ـيـ.ـنة العرب مسلمين ومسيحيين،هنا واليوم.
د.إبراهيم علوش