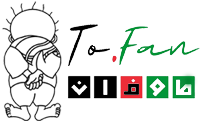سيكولوجيا الاستشهاد: لماذا بقي السيّد حسن نصر الله في الضاحية رغم علمه بأنه سيُقتل؟
السلام عليكم إخواني،
اليوم سأجيب عن سؤال ظلّ يتردّد في داخلي منذ اليوم الذي أعلنت فيه المقاومة استشهاد السيّد حسن نصر الله في سبتمبر عام 2024. لم أسأل كيف مات، بل لماذا استشهد بهذه الطريقة. لماذا بقي في الضاحية الجنوبية؟ لماذا لم يغادر إلى موقع سري أو جبل أو نفق أو مكان محمي؟ لماذا أصرّ أن يبقى في النقطة التي يعرف أنها ستكون الأولى على قائمة أهداف إسرائيل؟ هل كان قراره استشهاديًا صرفًا؟ هل كان قرارًا رمزيًا؟ سيكولوجيًا؟ سياسيًا؟ أم شيئًا أبعد من كل ذلك؟
علم النفس الحديث، وتحديدًا علم النفس الوجودي كما في أعمال فيكتور فرانكل، يقدّم مدخلًا هامًا لفهم هذه المواقف. في كتابه «الإنسان يبحث عن معنى»، يذكر فرانكل أن الإنسان يستطيع أن يتحمل أقسى ظروف الحياة أو الموت إذا شعر أن حياته تخدم هدفًا يتجاوز ذاته. السيد نصر الله لم يبقَ في الضاحية لأن الظروف أجبرته، بل لأنه اختار البقاء رغم معرفته المسبقة بالمخاطر. هذا قرار لا يمكن عزله عن السياق النفسي الداخلي لفكرة الاستشهاد، التي لا تعني فقط السقوط في المعركة، بل تعني مواجهة الموت كجزء من الهوية، من المعنى، من القيادة ذاتها.
هذا النمط من القرار ليس معزولًا في التاريخ. في الثورة الروسية، كانت إينيسا أرماند، من أبرز قيادات البلاشفة، قد أصيبت بالكوليرا في منطقة قوقازية موبوءة لأنها رفضت مغادرة السكان المرضى، وقالت إن القائد لا ينفصل عن جماعته في المحنة. روزا لوكسمبورغ بقيت في برلين وهي تعلم أن فصائل القمع ستغتالها، لأنها رأت أن الثورة لا تُدار من بعيد. ليون تروتسكي، في «حياتي»، يذكر أن الثورة تأخذ من المرء كل شيء، بما في ذلك حياته، حين يتحوّل القائد إلى صورة للفكرة لا لشخصه.
في الحالة الشيعية، الاستشهاد ليس حدثًا عرضيًا بل هو بنية رمزية مرتبطة بالقيادة الأخلاقية. الحسين بن علي، في كربلاء، خرج وهو يعلم أنه لن ينتصر عسكريًا، لكنه رأى أن الانسحاب موت معنوي، وأن الشهادة وحدها تحفظ المعنى. هذا النموذج الفكري والأخلاقي يتكرّر في تجربة السيد حسن نصر الله: أن تكون في الموقع المستهدف، وتبقى فيه، وأنت تعرف يقينًا أنك الهدف، يعني أنك لا تعيش فقط باسم القضية، بل أنك تموت لتؤكّد أن القضية ليست خطابة، بل دم.
في علم النفس الجماعي، تبرز نظرية “الانصهار الهوياتي” التي تحدّث عنها وليام سوينسون، والتي تقول إن بعض الأفراد يندمجون مع مجموعتهم أو قضيتهم لدرجة يصبح فيها أي تهديد لها تهديدًا لذاتهم، ويصبح الفناء جزءًا من الحفاظ على الذات المتماهية مع المعنى الأعلى. هذا ما فعله نصر الله: لم يبقَ فقط في الضاحية بوصفه القائد، بل بوصفه الذات الرمزية لتلك الأرض، لذلك الناس، لذلك الخط.
في كتاب «الخوف من الحرية» لإريش فروم، يُطرح سؤال جوهري: هل يستطيع الإنسان أن يتحرّر من ذاته دون أن يفقد هويته؟ الشهيد، في هذا السياق، هو من يجيب بنعم، لأنه لم يعد يرى نفسه كجسد يجب حمايته، بل كقيمة يجب إثباتها ولو بالزوال الجسدي.
الأمثلة ليست قليلة. أميلكار كابرال، قائد الثورة في غينيا بيساو، رفض الحراسة لأنه قال: “إذا اختبأ القائد، تختبئ الفكرة.”، وقُتل. باتريس لومومبا رفض التفاوض على حياته، وقُتل. حتى خارج الإطار السياسي، في الأدب والمسرح، نجد في مسرحية «أنتيغونا» لسوفوكليس، أن الشخصية الرئيسية تذهب للموت بوعي لأنها ترى أن البقاء يعني الانفصال عن المبدأ.
قرار البقاء في مكان الخطر، رغم امتلاك القدرة على الانسحاب، ليس غريزيًا. الغريزة تدفع الإنسان للهروب. أما الوعي، حين يصعد إلى مستوى المعنى، فقد يدفعه للبقاء. هذا هو جوهر القرار الذي اتخذه السيّد حسن نصر الله، سواء شعر به الناس أم لم يشعروا: لقد اختار أن يُقتل، لا لأن الموت يُغريه، بل لأن المعنى كان يستدعي أن يبقى. أن لا يغادر. أن يتحمّل حتى النهاية ما طلبه من رجاله أن يتحمّلوه.
جنازته لم تكن جنازة قائد سياسي. كانت لحظة تثبيت جماعي لحقيقة رمزية: أن القيادة ليست بقاءً في المنصب، بل استعداد دائم للزوال من أجل إثبات الفكرة. ولهذا بقي في الضاحية. ولهذا قُتل فيها. ولهذا صار استشهاده لحظة وعي أعمق من كل خطاب، أبلغ من كل ظهور تلفزيوني، وأشد وقعًا من كل معركة خاضها في حياته.
ذلك هو الشهيد، حين يُولد المعنى من جسده، لا من شعاراته.