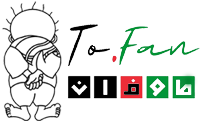الأنا والعصيان
في مفهوم الأنا بين الشرق والغرب
عندما يقرأ المشتغلون في علم النفس كلمة ال”أنا” تذهب عقولهم إلى تعريفات علماء النفس مثل فرويد وكارل يونغ وغيرهم كثيرون ممن دخلوا في تفصيلات كثيرة في أنواعها أو مكوناتها من مشاعر مكبوته ومشاعر ظاهرة، ولكنهم أخيراً يشتركون في أن الأنا هي الصورة الحاضرة عن الذات. ويرى علم النفس الغربي أن الأنا ضرورة، وليست بالعدو الذي تجب محاربته، فهي التي تجعلك تعرف واقعك وكيف تتصرف فيه. وفي المقابل أخذت كلمة “الأنا” بعداً آخر في الشرق، قد يسميه البعض بُعداً شعبياً، يرى هذا البعد أن مفهوم الأنا مرتبطٌ بمفهوم سلبي، وهو مفهوم الأنانية بمعناها الواسع: جلب المصلحة إلى الذات دون أي اعتبار لأي ضرر على الآخر. نعم يُسمى هذا البعد بالبعد الشعبي في الأوساط العلمية، ولكن، في الحقيقة أرى أن وجود هذا البعد الشعبي ناجم عن التأمل بالنفس وفهمها وفهم دينامياتها في حضارات الشرق. فغوص أسبار النفس ليس أمراً جديداً على الإنسانية والشرق بالتحديد، وهو الأمر الذي ربما يكون مفهوماً لدى البعض أن علم النفس سبقٌ علمي غربي، وهذا الأمر ليس بصحيح. فإن التصور عن أن فرويد هو أول من جاء بفكرة اللاوعي وحاكميته للشخصية وعلاقة ذلك بالطفولة ومن ذلك يُشار إلى الإنسان أنه ديناميكية قابلة للتفسير (علم التحليل النفسي) هو تصور غير دقيق، إذ أن هذا كله كان موجوداً في الوعي الجمعي الشرقي، ولكن يصعب أن تجده في صياغة بحثية متكاملة كما فعل فرويد. من هذا المنطلق لا أحب أن أسمي هذا المفهوم مفهوماً شعبياً حتى لا تُحتكر صياغة الأفكار إلى جانب أحادي، ولنسمّه بالبعد الشرقي كما يجب أن يُسمى.
من منطلق آخر، أرى أن اختيار الكلمات في الشرق أقرب منها إلى الفاعلية في التعامل مع الذات من الطريقة الفرويدية، فمثلاً يرى فرويد أن الأنا هو الحالة الحاضرة التي تستخدمها وتفكر بها وتوازن بها الأمور من خلال الاحتكام إلى الواقع، ويرى فرويد أن هذه الحالة طبيعية مقبولة، وعلى الإنسان اختيارياً أن يسعى إلى الأنا العليا التي تحوي المثل والقيم العليا. أما في حالة الشرق فالانا هي الأنانية، فيرى الإنسان الشرقي أن الحالة الحاضرة لدى الإنسان هي الأنانية، وعلى الإنسان أن يعي بهذه الأنانية ويتجرد منها حتى يرتقي إلى مرحلة حضور الضمير. فالواقع ليس معياراً في صحة الأنا عند الشرقيين. وإنما هم بطبيعة الحال يؤمنون بحضور الأنانية حضوراً تلقائياً.
فالخلاصة مرة أخرى، فرويد يرى أن الوعي الطبيعي هو الوعي الحاضر المحتكم إلى الواقع وغيابه مرض. في حين أن الشرق يرى أن الأنانية هي الحاضرة بطبيعتها وعلى الإنسان أن يصل إلى حضور المثل العليا بغض النظر عن الواقع. فالتوازن عند فرويد معياره الواقع، والتوازن في الشرق هو الحركة نحو المثل والقيم. أما الحركة نحو المثل العليا عند فرويد فهي مجرد أمر مستحسن. وحضور الأنا كافٍ عنده ليقيَ الإنسان نفسه من الانزلاق نحو ما يسميه ب”الهو” وهو الجانب الغرائزي البدائي الذي لا يعبأ إلا باللذة والشهوة المستعجلة الحاضرة الآنية.
مفارقة
إن تعريف فرويد يلقي بالأفراد إلى أحضان المجتمع ليصوغ المجتمع للفرد ضميره، حيث يستخدم الفرد الواقع الذي يصوغه المجتمع في تعريف ما هو صحيح وخاطئ، ونستذكر هنا أن المجتمعات والجموع هي حالة مرنة في يد السلطة بحسب علم النفس الاجتماعي. أما الطريقة الشرقية تُخبر الإنسان أنه يجب أن ينتبه لأنانيته الحاضرة بطبيعتها وأن يبذل الجهد في أن يتخلص من هذه الحالة الطبيعية المندفعة بالوراثة ليرتقي سعياً إلى المثل العليا والواقع أو سياق المجتمع ليس معياراً لماهية المثل العليا والطريق إليها.
الطوفان المجيد وصحوة الأنا
إن ما يميز الطوفان عن كل المعارك بأنه كان بمثابة إعلان عصيان. عصيانٌ ضد الطغمة والظلم والحصار والاحتلال والاستعباد بالحديد والنار، عصيانٌ ضد نظام ظن بأنه تمكن من إبادة الشعب الفلسطيني أبداً وبأنه حاصره بأوراق التطبيع ومعاهداته. أقول عصيان لأن الفرق بين العصيان وبين المعارك السابقة الأخرى التي قامت بها المقاومة سابقاً، أن العصيان إعلان ابتدائي ينطلق من صاحب العصيان، وليس ردة فعلٍ لهمجيةٍ صهيونيةٍ أو اعتداءٍ على الأقصى أو مجزرة هنا أو هناك. بل يجيء العصيان ابتداءً في لحظة صفاء ونقاء ليلعن انتهاء حالة المقاومة، وليعلن ابتداءَ حالة الرفض والهجوم، أو هي أدنى من الهجوم بقليل، لأن مقومات الهجوم العسكرية غير حاضرة اليوم، وأيضاً لا يبدو أنها ستحضر في المستقبل لأن من يحمل السلاح في حالتنا الفلسطينية تتم محاصرته علناً وبأسلوب ناعم لا تشعر معه الجماهير بحضور التهديد المباشر عليها.
الغرب (معيار الواقع)
وفي نظري، إن حركة العصيان تختلف عن حالة المقاومة في تأثيرها على وعي الإنسان، لأن العصيان رفضٌ لحالةٍ تمتاز بالكمون والهدوء الأمر الذي يثير الانتباه والاستغراب. أما حالة المقاومة فهي ردة فعل طبيعية لهجوم وعدوان من العدو، ولا يثير ذلك اندهاشاً ولا استغراباً، وفي ظل انعدام الاستغراب يظل العدو ممسكاً بزمام الرواية ليصوغها كما يريد. اما في سياق الاندهاش والاستغراب، فلا يكتفي الإنسان بأن يسمع ما يقال له، بل يبدأ بالبحث ليعرف أكثر عن الدوافع والمسببات لهذه الحالة المدهشة، انتفاضة في عمق الكمون والهدوء.
إن المجتمعات الغربية التي لطالما عاشت تعرّف نفسها وقيمها بأنها ديمقراطية تختار بحرية، وتعرّف ذاتها بما يتماشى مع هذا الواقع المنفتح الذي يتغنى بالقيم، تكتشف الآن أن تلك الدعوات كانت تُستخدم لأسباب في جوهرها استعمارية، فليست إسرائيل إلا وجهاً حقيقياً لهذه القيم الزائفة، فمن هذا الذي انتفض على واقعنا في الغرب؟ من هذا الذي انتفض على معيارنا في تعريف الذات؟ من هذا الذي انتفض على المرآة التي ننظر إليها كل صباح لنرى بها أنفسنا؟ ولماذا يود أحدهم أن ينتفض على هذه القيم وعلى هذا الواقع أصلاً؟ وما الذي تملكه إسرائيل لتخفي هذا الواقع الذي تعرف به هذه المجتمعات نفسها؟ أوليست إسرائيل رمزاً للعدالة الأوروبية ولإنهاء الظلم الواقع على اليهود؟ فما الذي نراه اليوم من إسرائيل؟ هل أنهينا واقعاً مظلماً لنبدأه ونخمده ونكبته في مكان آخر؟
كلها أسئلة يتحدث بها الغربي في لا وعيه وبها ينفعل، كان يعيش الغرب بأجوبة حاضرة على هذه الأسئلة المرتبطة بالذات والتصورات عن الأنا، لكن السابع من أكتوبر أزاح تلك الأجوبة، فتجد اليوم في المظاهرات العالمية يرفعون شعاراتٍ مثل Google Nakba، أي ابحث عن هذه الكلمة على جوجل لتفهم الواقع وتفهم القصة. بل وتكمن حساسية الموضوع أن السابع من أكتوبر قد حدث في ذروة الصراع الغربي حول الهوية وحول تعريف الذات وطريقة تشكيلها والتي انقسم الغرب عليها بين يمين ويسار. فجاء في خضم هذه الحالة السابع من أكتوبر ليذهب بالتساؤلات إلى منطقة أبعد من تلك التساؤلات حول الهوية، ليذهب بالجميع إلى إعادة تشكيل الواقع بإعادة قراءة التاريخ.
فالتركيبة الغربية التي صيغت في منطلقاتها من فهم فرويد وعلماء النفس في أن الواقع هو الذي يصوغ الفهم عن الأنا، قد أصيبت بضربة مدهشة لتخبر العالم أن هناك أمرٌ تجب مراجعته ويجب النظر إليه.
الشرق (معيار الأنا العدوة)
وأيضاً، إن فارقاً الحاسم في حالة العصيان أنها خروج عن حالة المظلومية. وحالة المظلومية هي تعريف الأنا ب”أنا ضحية”. وفي نظري إن ضرب مفهوم المظلومية في عمقه هو دعوة إلى صحوة الإنسان للتحرك والتجمهر، لأن لا شيء يعوق الإنسان عن التحرك مثل أن يقول عن نفسه بأنه مظلوم، فيدخل في سيكولوجية الانتظار، تماماً كما انتظر الصهاينة بريطانيا لتأتي لهم بأي حل مهما كان نوعه ليخرجوا من حالة الظلم التي كانوا فيها، وكانت المحصلة أن عاشوا على دماء غيرهم! ولهذا أقول بأن المظلومية لا يمكن أن تأتي بخير.
إن قفزة المقاوم في السابع من أكتوبر كانت إيذاناً بالانطلاق، وكسراً لكل انتظار، وهو الأمر الذي أول من أدركه كان الشهيد المقدس، السيد حسن نصر الله، والذي دخل الإسناد في الثامن من أكتوبر مدركاً لأبعاد هذه المنازلة، ومدركاً لحالة العصيان التي يجب أن ينخرط بها وهو من أجدر الناس بذلك كزعيم للمقاومة في الجنوب اللبناني.
عوداً على بدء، إن مشاهد الموت والقتل للأطفال والنساء والأبرياء في غزة قد أصابت معيار الأنا العدوة عند الشرقيين، والتي يؤمن الإنسان الشرقي أنه يجب عليه أن يدفع بها نحو المثل بطبيعة الحال. وعندما نتحدث عن هذه المثل فنحن نتحدث عن مفاهيم متقدمة كالنخوة والكرامة والتضحية والعدالة، بل والإقدام على الموت والشهادة. فقد أصابت إسرائيل ومعها الحكومات العربية هذه المنظومة الأخلاقية والمثالية بحالة من التناقض، بخلق واقعٍ موحش مليء بالدماء يستحضر كل هذه القيم والتصورات عما يجب عليه أن تكون الأنا الشرقية، وبنفس الوقت خلصت الحكومات العربية واقعاً مليئاً بالقمع والصمت الإسكات لحالة الشعور بالواجب وحضورها. ولكن، هل يعني ذلك أنها ليست حاضرة؟!
إن خلاصة كل ما قيل آنفاً يكمن في أن بوصلة الشارع الغربي هي الواقع، في حين أن بوصلة الشارع الشرقي هي الذات. وإنني أرى أن سرعة استجابة الشارع الغربي لأحداث غزة وتأخر استجابة الشارع العربي ليس لها علاقة بالأفضلية ولا بوجود الحس الإنساني أو عدمه، وإنما هو فرق في الديناميات الفاعلة في وعي كل شارع، فدينامية الغرب ظاهرية عملية، ولكن دينامية الشرق فلسفية تأملية، الأولى تستجيب بسرعة وتحقق النتائج قصيرة الأمد، والثانية تحتاج وقتاً لتستجيب، وتكون استجابتها حاسمة ومفصلية.
من هذا المنظور، لا أؤمن أن النفس الإنسانية ترضى بالقتل والدماء والظلم، لأن جلّ ما يهم كل نفس هو تصورها عن ذاتها وعلى هذا الأساس تحدث ردة الفعل. وإن وصم الشعوب العربية بالتخاذل والنوم والسكوت سببه عدم الفهم لطبيعة الإنسان الشرقي الذي أراهن في هذه السطور على تحركه المفاجئ.
“بومة منيرفا لا تبدأ طيرانها إلا عند الغسق”
آدم السرطاوي – كندا